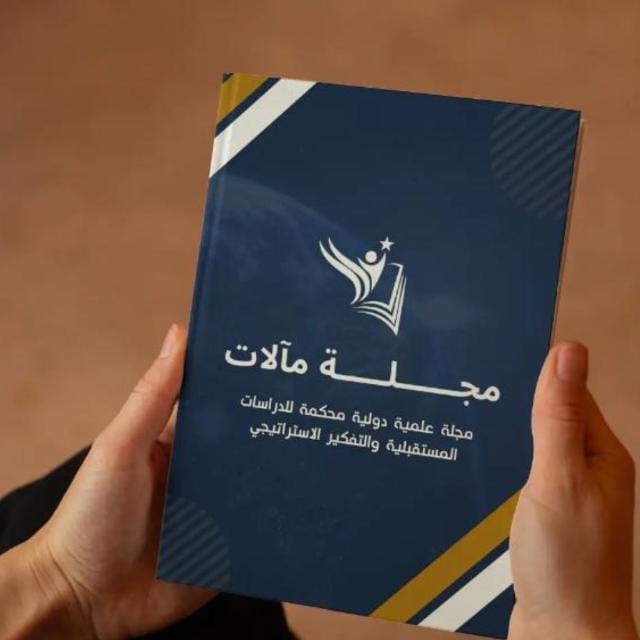د. محمد براهمي جامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء
ملخص:
الحديث عن الأسرة حديث عن مؤسسة ولدت مع ولادة الإنسان، واستمرت معه في مختلف مراحل وحقب التاريخ، خلافا لباقي مؤسسات المجتمع التي ارتبط وجودها بأسباب وعوامل كانت السبب في بقائها أو زوالها، فقد وجدت الأسرة في مختلف المجتمعات رغم اختلاف دياناتها وتوجهاتها، حيث كانت وما زالت القاسم المشترك فيها رغم التحولات التي طالت بنيتها ووظيفتها وشبكة علاقاتها. وهذه الدراسة ستحاول سبر أغوار مسألة القيم ومدى تفاعلها داخل مؤسسة الأسرة.
الكلمات المفتاحية: الأسرة – القيم.
Family and the question of values
Dr. Mohamed BRAHMI
UNIVERSITY HASSAN II – Casablanca
Abstract:
Talking about the family is talking about an institution that was born with the birth of man, and continued with him in various stages and eras of history, unlike the rest of the institutions of society whose existence was linked to causes and factors that were the reason for its survival or disappearance. The family has existed in various societies despite their different religions and orientations, where it was and still is. The common denominator in it, despite the transformations that affected its structure, function, and network of relationships. This study will attempt to explore the issue of values and the extent of their interaction within the family institution. Keywords: family – values.
تقديم:
الأسرة أهم بناء مجتمعي حظي بالاهتمام والتفصيل التشريعي خلافا لباقي مؤسسات المجتمع، بما في ذلك مؤسسة الدولة نفسها، وهي الوحدة الاجتماعية الأولى التي ينشأ فيها الطفل، ويكتسب فيها قيمه وتوجهاته، وتتبلور فيها منظومة قيمه، وتكتمل فيها معالم شخصيته، وتزرع فيها بذور عقيدته، ف “ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء” [1]
وهي الضامن لتوارث القيم والعادات والمبادئ بين الأجيال خاصة في أوقات تجفيف مصادرها بمحاصرة واستئصال مؤسسات بنائها والتنشئة عليها،كمؤسسات المسجد والمدرسة والإعلام، يؤكد ذلك تاريخ العديد من الدول ــ كجمهوريات السوفيات سابقا وتركيا … ــ التي حفظت قيمها ومعتقداتها ونقلتها لأبنائها الذين أعلنوا عنها مباشرة بعد زوال موانعها، بزوال الأنظمة المعادية لها، رغم التضييق والتجفيف الطويل الذي عرفته قيم الإسلام ومبادئه وتعاليمه، بل ومظاهره ورموزه.
مؤسسة يصعب الإلمام بكل جوانبها في الحديث والدراسة، فهي قد تقارب في بنيتها ووظيفتها، كما قد تدرس من خلال شبكة علاقاتها، وبمقاربات ومناهج متباينة من حيث الأسس الفلسفية والمعرفية، فقد تقارب برؤية اجتماعية، أو قانونية أو تاريخية، أو تربوية…
أما القيم فهي معايير وضوابط توجه سلوك الفرد والمجتمع في علاقاتهما بمكونات الوجود كله، وهي نتاج فكري وسلوكي يتحول بدوره إلي ضوابط توجه السلوك والفكر..
وهي عملية خاصة بالجنس البشري، إذ لا وجود له بدونها، فهما متلازمان كظهري الورقة النقدية، ومرتبطان ارتباط الروح بالجسد، وهي لحمة المجتمع ومؤسساته، الضامن لاستقراره واستمراره، ولنهضته أو انهياره، وصدق في ذلك أمير الشعراء لما قال:
إنما الأمم الأخلاق ما بقت إن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
والحديث عنها حديث عن جوهر الرسالة الإسلامية، وغايتها لقوله صلى الله عليه وسلم ” إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”، فهي الغاية والمقصد، وهي المنطلق والمبتغى.
فإلى أي حد ما زالت الأسرة تحظى بالاهتمام والرعاية العلمية؟ وتمارس وظيفتها ودورها في التنشئة على القيم في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية الجارية؟ وهل استطاعت التكيف مع المستجدات والتحولات والمحافظة على بنيتها ووظائفها وشبكة علاقاتها؟
1: الأسرة في الدراسات الإنسانية:
إن تتبع تاريخ العلوم[2] يؤكد الانحصار المتنامي في البحوث التي تتناولها بالدرس والتحليل، وخاصة الدراسات التي تهتم بوظيفتها في بناء القيم والتنشئة عليها، حيث اقتصر الاهتمام بها في تخصص الأنثروبولوجيا في مقاربتها كوحدة اجتماعية تقليدية تحتفظ بالشكل القبلي، باعتبارها بناء اجتماعي أساسي تسوده علاقات القرابة والعشيرة، كما تدرس في ضوء التغييرات التي طرأت عليها في المجتمعات الصناعية في مستويات ( البنية والعلاقات..).
واهتم علم الاجتماع بوظائفها خاصة المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية بما يحقق استقرار المجتمع ويستجيب لحاجاته المادية، وببنيتها وأشكالها، والتحولات التي طالتها على مستوى والوظيفة وعلى مستوى على شبكة علاقاتها.
أما في علم السياسة فلا مكان لها فيه، حيث ينذر وجود كتابات في علم السياسة تتحدث عن الأسرة، فهي في التصنيف وحدة سياسية لا تدخل بشكل أصيل في البحوث والدراسات السياسية، فقد اهتم هذا العلم بالسلوك السياسي لمختلف المؤسسات التي لها علاقة أو صلة به من قريب أو بعيد، ووصل حد الاهتمام بالسلوك السياسي للفرد كوحدة في التحليل، واستبعدت الأسرة من دائرة الدراسة والاهتمام في هذا المجال، بل حتى في علم الاجتماع الذي اهتم بالأسرة استبعدت من تخصصه المرتبط بالسياسة، والمتمثل في علم الإجماع السياسي، حيث لا ينظر إليها كوحدة تحليل، وفي المقابل تدرس توجهات الفرد والنخبة والأحزاب وغيرها من المؤسسات، وتقل البحوث التي تربط الأسرة كوحدة اجتماعية بالسلوك السياسي للفرد، كما أن الكتابات التي تناولت هيكل السلطة داخل الأسرة، فدراستها ركزت على البعد الاجتماعي بعيدا عن السلوك السياسي للفرد وقيمه السياسية، بل حتى في علم الأنثروبولوجيا السياسية تغيب الأسرة من اهتمامه ويتركز الاهتمام بمؤسسة القبيلة، وظهور الدولة، والرموز السياسية للجماعة، ودور الدين في المجتمع، وتوزيع القوة، وأنواع القيادات الاجتماعية، رغم أن للأسرة مركزية في الدراسات الأنثروبولوجية خاصة الأسرة الممتدة.
وقد طغى في المقابل دراسة الدولة مند القرن السابع عشر كنظام ومؤسسة وآليات، وأصبحت هي الأصل، وتقلص في المقابل دور المجتمع ومؤسساته، وإن كان من اهتمام بهذا الأخير ففي ظل ما يحفظ للدولة بقاءها وقوتها وسيطرتها، حيث أن مفهوم المجتمع المدني الذي برز في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات لم يعني الانتقال من الاهتمام بالدولة إلى المجتمع، بل ظل يدرس في سياق صلة المجتمع بالدولة وآليات العلاقة بينهما، وهو كما عبرت عنه هبة رؤوف توسيع لرقعة التنظير، وليس تغييرا في طبيعة الابيستمولوجيا، ولم يمتد ليشمل الأسرة، بل الاهتمام انصب على وحدات اجتماعية أخرى كالنقابة والجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، فكانت النتيجة تعملق الدولة وتضخمها في الأدوار والوظائف والمهام بشكل أكثر مما يحتاجه المجتمع، وفرضت عليه سلطات أكثر مما هو في حاجة إليه، وقلصت من أدواره ووظائف مؤسساته التي تنظم الفعل الجماعي وتوحد الجهود، بما في ذلك مؤسسة الأسرة التي فقدت أغلب وظائفها، وفي مقدمة ما فقدت، الوظيفة الاقتصادية كوحدة منتجة في إطار الأسرة الممتدة في ظل نظام اقتصادي تضامني، حيث انتقلت للمصانع والمؤسسات الاقتصادية، فكان لها انعكاسات على بينة الأسرة بالإضافة لوظائفها، حيث امتدت الأسرة النووية على حساب الممتدة، وانخرطت المرأة في سوق العمل، وحولت الوظائف والمهام داخل الأسرة تبعا لهذا التحول، وتقلصت بذلك الوظيفة التربوية والاجتماعية، حيث فوتت عملية التنشئة والرعاية للمدرسة والمؤسسات التربوية مثل دور الحضانة ودور العجزة، بل فوتت حتى الأعمال المنزلية الطبيعة من تنظيف وطبخ إلى مؤسسات خدماتية خاصة، فتقلصت أدوارها حتى كادت تنعدم.[3]
وهنا يطرح السؤال حول السبب من استبعاد موضوع القيم في دراسات الأسرة والحرص على التعامل معها كباقي مؤسسات المجتمع من حيث الوظيفة والأدوار؟ وحول سبب إخراج الأسرة من دائرة الدراسات السياسية في العلوم الإنسانية، وحصرها في زاوية العلوم الاجتماعية التي تقلصت مساحة الدراسات الأسرية فيها لصالح قضايا المجتمع عامة، والحركات الاجتماعية، ومشاكل المجتمع وقضاياه كقضايا الفقر والبطالة، والتحضر…؟
إن الهدف الثاني وراء استبعاد الأسرة من الدراسات السياسية في حقول العلم والمعرفة، في مقابل طغيان مؤسسات أخرى كوحدات في الدراسة والتحليل راجع لامتداد وظيفة الدولة كوحدة لها سلطة التدخل والتوجيه، حيث جمعت مصادر السلطة، ووجهت وظائف وأدوار مؤسسات المجتمع بما ينسجم مع وظيفتها وبنيتها الحديثة، وهو ما قابله تقلص في وظائف وأدوار باقي مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الأسرة التي تراجعت وظائفها ابتداء من الوظيفة الاقتصادية، مرورا بوظائف التربية والتنشئة والرعاية الاجتماعية، وصولا للوظائف الخدماتية المنزلية، كإعداد الطعام والتصبين وغيرها.
كما أن استبعاد القيم من الدراسات الأسرية في العلوم الإنسانية جاء بدعوى أن القيم لا محل لها في دراسة المجتمع والأسرة، تأسيا بالنموذج الطبيعي الذي يبحث فيما هو كائن، لا فيما ينبغي ان يكون، فعلم الاجتماع يبحث في ظواهر الأشياء ويكشف عن الحقائق ويعتمد التحليل والملاحظة والتجربة وسائل للوصول إلى الحقائق، والقيم تحكم على الظواهر وتقوم الفعل والسلوك، وتبحث في الغايات وهي ليست من صفات العلم الذي يدرس ويحلل ويستخلص الحقائق فقط، فالعلم في الدراسات الاجتماعية وضع قطيعة بين الواقع والقيمة، وجعل من ” البحث عن أسس الأحكام القيمية ضرب من الميتافيزيقيا”[4] وهو مسار اختارته الدراسات الاجتماعية ابتداءً من الحرب العالمية الأولى حيث بدأ ” مبحث القيم يتوارى شيئا فشيئا في العلوم الاجتماعية بحجة ترددها أغلبية الباحثين مفادها أن الأخلاق لا محل لها في دراسة المجتمع التي ينبغي أن تتأسى بنموذج العلوم الطبيعية التي أثبتت جدارتها وبالتالي فإن المعرفة العلمية هي المسلك الوحيد لفهم الواقع الاجتماعي”[5]
وتبقى حدود الدراسة والبحث مقتصرة على الملاحظة والتحليل والتفسير وصولا للتنبؤ، دون الامتداد للحديث عن الأهداف والغايات والمبادئ أو القيم الحاكمة للظاهرة، إذ علم الاجتماع هو علم يصف ويكشف، ويحلل ويفسر الظواهر بآليات وطرق تعتمد القياس والتجريب، ولا يصل في وظيفته ومهمته إلى مجال الحكم والتقييم، أو الإصلاح أو اكتشاف قوانين التغيير، وهو ما يؤدي على إحداث قطيعة تامة بين الموضوع المدروس والذات، ويساهم – حسب هذه المدارس- في إحلال نوع من الموضوعية في النتائج المتوصل إليها، لانتفاء الأحكام التقويمية، واستبعاد الانطباعات والميولات الشخصية أثناء التعامل مع الظاهرة الاجتماعية، رصدا ووصفا وتحليلا وتفسيرا.
لقد مارس المرجع الطبيعي المادي سلطته المنهجية والمرجعية على العقل المؤسس لعلم الاجتماع في دراسته للظواهر الاجتماعية ومؤسسات المجتمع ذات الصلة بالعلاقات الإنسانية والقيم الضابطة لها، حيث انتهج نفس المقاربات والخطوات المعتمدة في الدراسات الطبيعية، بغية تحقيق نفس النتائج المتحققة في الدراسات الطبيعية، وهو نهج أفصح عنه رائد المدرسة الوضعية أوجست كونت إذ قال ” إننا ما دمنا نفكر بشكل وضعي في مادة علم الفلك أو الفيزياء لم يعد بإمكاننا أن نفكر بطريقة مغايرة في مادة السياسة أو الدين، فالمنهج الوضعي الذي نجح في علوم الطبيعة غير العضوية يجب أن يمتد إلى كل أبعاد التفكير”[6]
وهو أمر أكده إميل دوركايم حيث دعا إلى وجوب دراسة الظواهر الاجتماعية على أنها أشياء، وجعل جل ذلك أساسا تقوم عليه طريقته في الدراسة والبحث[7] باعتبار أن الظواهر الاجتماعية أشياء، والشيء هو ما يقع تحت الملاحظة ويقدم نفسه للملاحظة كنقطة بدء العالم.[8]
فقد تم التعامل مع الظاهرة الاجتماعية بنفس الطريقة التي يتم بها مقاربة الظاهرة الطبيعية من حيث الطبيعة ومناهج التفكير والوصف والتحليل، ويطبق عليها نفس وسائل وأدوات البحث المعتمدة في دراسة المادة الطبيعية من ملاحظة وتجربة واستنتاج، لأن كليهما يخضع لقوانين يمكن الكشف عنها وتوظيفها في فهم الظاهرة الاجتماعية، وتفسيرها، وتحليل علاقاتها ومكوناتها، وساعد على اعتماد النموذج الطبيعي في الدراسة ما وصلت إليه العلوم الطبيعية من نتائج وإنجازات، وما وصلت إليه بعض الدراسات الاجتماعية من خلاصات باستخدام المناهج السوسيولوجية في الدراسة والتحليل.
2: الأسرة والقيم في الدراسات الإنسانية:
تعتبر الدراسات الإنسانية الوضعية بشقيها الوظيفي والماركسي استقرار النسق الكلي ( الدولة / المجتمع) الهدف من وظيفة باقي الأنساق الاجتماعية كالأسرة… فعملية التنشئة والضبط الاجتماعي والإنجاب تأتي وفق حاجات الدولة واستقرارها وانسجام مؤسساتها واستمرارها، وقد نتج عن هذه المقاربة في دراسة المؤسسات الاجتماعية عامة، ومؤسسة الأسرة على وجه الخصوص قيم تضبط سلوك أفراد المجتمع، وتنظم علاقاتهم، وتوجه تصوراتهم، وأهمها:
أ: قيم المادية:
وتتجلى هذه القيمة في تفسير كافة العلاقات الأسرية بمقاربة مادية، فالزواج على سبيل المثال ظهر لأسباب اقتصادية فهو عبارة عن شكل من أشكال الملكية الخاصة ” ظهر مع ظهور قدر معين من الثروة في يد شخص واحد وهو الرجل، ومع رغبة هذا الرجل في توريث الثروة لأبنائه”[9] ” فأصبح الزواج مؤسسا على اعتبارات اقتصادية أكثر من أي وقت مضى”[10]. بل تجاوز التفسير ذلك إلى اعتبار الزواج الفردي ” بدء للاغتصاب والعلاقات غير المشروعة” بل واعتبار ” ستر العورة طريقة صريحة لامتلاك النساء”.[11]
وقد انبنى هذا التحليل من منطلق التطور الذي صاحب الأسرة حسب بعض التوجهات في المدارس الوضعية، إذ انتقلت من مرحلة المشاع أي الزواج الجماعي باعتباره الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة، إلى حالة الانفراد الذي يجمع الرجل والمرأة، مفسرين ذلك ” بمعطيات اقتصادية نتجت عن انتصار الملكية الخاصة على المشاعية البدائية الطبيعية، وتركز الثروة في يد واحدة، هي يد الرجل الذي سعى لتوريث هذه الثروة لأبنائه من بعده وحرمان الآخرين منها”[12] وهو أمر تبنته الاتجاهات النسوية، باعتبارها امتدادا للفكر الماركسي أسسا وتأسيسا ونضالا، أمر يؤكده حوارات لنين وكلارا زنتكي إحدى رواد هذا الاتجاه، حيث يقول ” إن أول واجباتنا أن نخلق حركة نسوية عالمية، قائمة على أساس نظري واضح ومحدد.. ومن المؤسف أن مؤتمرنا الأممي الثاني لم يكرس وقتا لمناقشة المسألة النسوية، أو اتخاذ موقف بصددها بالرغم من أن هذه المسألة قد طرحت على بساط البحث”[13]
وقد ذهبت مناضلات هذا المسار إلى الدفاع عن حقوق المرأة مركز الأسرة، معتبرة الزواج ” عقد تمليك تفقد فيه المرأة ملكيتها لنفسها، وتسلمها للزوج، وفي ظل قوانـين الزواج لا بملك الرجـل يد المرأة فحسب بل يملك أطفالها” [14]بل وتذهب الأستاذة نوال السعداوي إلى أن الرجل ” يشتري المرأة بالزواج لتخدمه وتكون أداة إمتاعه ووعاء ينجب أطفاله”[15]أي هو صفقة تتم بين الأب والزوج حول المرأة كما سيؤكد ذلك النظرة للصداق المقدم للمرأة، حيث يعتبر تجسيدا للصفقة التجارية بين الزوج والأب، وموضوعها سلعة المرأة، وهو أمر أكدته الكاتبة المغربية كنزة العلوي بقولها ” يعتبر الزواج في القانون المغربي صفقة تجارية تتم بين الأب والزوج، تنتقل بمقتضاها أغلبية الحقوق من يد الأب إلى يد الزوج، وذلك مقابل مقدار من المال يعطيه الزوج إلى أب البنت كتعويض عن الخسارة الاقتصادية الناتجة عن مغادرة البنت كقوة عمل بيت أبيها“[16]. وتؤكد الكاتبة المغربية نعمان جسوس في دراستها الاجتماعية على مجموعة من الفتيات أن الصداق ممارسة تقليدية تتعارض مع مقتضيات العصر، ويمثل وجها من وجوه المبادلات التجارية، حيث تقول ” إن الفتيات القلائل اللاتي يرفضن أن يعرضن للبيع فإنهن يصطدمن بتعصب الوسط الأسري، ولا يكون لهن بد من الخضوع لمشيئته”[17]” وإذا فقدت الزوجة بكارتها نقص ثمنها كأي شيء مستعمل يفقد بعضا من قيمته التجارية، ولا يعود في وسعها أن تطمع في صداق أكبر”[18]
وينبني على هذه الممارسة ـ تقديم الصداق ـ تحكم الرجل في بناء الأسرة وتشكيلها، وفي حق انتساب الأبناء له، بل وحق تسير الأسرة والتحكم في مصيرها ومصير أعضائها، ويرتبط به بالتبعية مسؤولية الإنفاق على أسرته، وهو ما يضفي على الزوج سمة التسلط والتوجيه، والتحكم في مصير الأسرة وأفرادها.
كما يتجلى التفسير المادي في علاقة الأبناء بالآباء، حيث تطبع هذه العلاقة أبعادا مادية وتوجهها منطلقات اقتصادية، إذ الأسرة التقليدية تنعدم فيها قيم المساواة والمحبة والمودة الخالصة نتيجة سيطرة البعد المادي والملكية الخاصة التي تطبع علاقات أفرادها، وهو ما جعل العديد من الدارسين الوضعيين يدفعون في التبشير بالأسرة الجماعية (كميونات) حيث تنعدم ” الكثير من المشاكل التي تعترض الأسرة التقليدية، إذ فيها يتحرر الأب والأم من قلق وعبء مسؤولية الإنفاق على أطفالهما ورعايتهما، وتصبح العلاقة بين الأبناء والآباء علاقة عاطفية خالصة، ولا تفسدها مطالب الآباء الاقتصادية الملحة وقلق الآباء الدائم لتأمين مستقبل أبنائهم وتعليمهم..وتحرر الأطفال من الفروق الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تفصل بينهم حسب ارتفاع أو انخفاض طبقتهم وأسرهم ويحضوا جميعا بفرص متكافئة في النمو والتغذية والتعليم والعمل، وتوصل الباحثون إلى أن الكثير من الأمراض التي كانت تصيب الطفل في الأسرة قد انتهت”[19]
إن الوضع الاقتصادي للأسر والعامل المادي حاسم في طبيعة العلاقة التي تجمع الآباء بأبنائهم، وأساليب التربية والتواصل بينهم، بل وطريقة التأديب التي يمارسها الآباء تجاه أبنائهم، مما ينعكس في البناء القيمي والنفسي والعقلي للأبناء، وهو أمر يستدعي تجنب هذا العامل في العلاقة التي تجمع بين الآباء والأبناء باعتماد النموذج الكميوني الذي يتحرر فيه الآباء من مسؤولية أبنائهم، ويتفرغوا إلى العطاء العاطفي تجاههم، وإلى الإبراز عن قدراتهم وطاقاتهم، ويسمح للأبناء في الوقت نفسه في بناء الثقة في أنفسهم وتجاوز المعوقات الطبقية المحددة لوجودهم ووعيهم، حيث يتم التساوي بين الجميع في فرص العيش والنمو والتعليم والعلم والمعرفة.
فالأسرة حسب الاتجاهات الوضعية مؤسسة منتجة لقيم العبودية والتفاوت الطبقي ولقيم الإذلال والخنوع والمسكنة، بل واعتبار الأعمال والوظائف القائمة فيها وظائف ليست بذات قيمة لانتفاء بعد الإنتاج الحقيقي فيها، إذ المرأة رهينة وعبدة “للاقتصاد المنزلي الصغير الذي يثقل كاهلها ويخنقها ويبلدها ويذلها ويقيدها في المطبخ وغرفة الأولاد ويرغمها على هدر قواها في مهام غير منتجة إلى حد رهيب، -وهي- مهام مثيرة للأعصاب ومرهقة”.[20]
إنّ المرأة والأسرة عموما لا يمارسان إنتاج القيم الحقيقية لارتباطهما بوظائف غير منتجة، إذ التربية وصناعة الإنسان حسب هذا الاتجاه مهام صغيرة مرهقة ومثيرة للأعصاب، تتنافى والدور الحقيقي للمرأة والأسرة في بناء المجتمع الحر، والاقتصاد العام، وهذا أمر تؤكده الكثير من الكتابات النسوية وفي مقدمتها كتابات الكاتبة المغربية فاطمة المرنيسي إذ ربطت حرية المرأة بسوق الشغل باعتباره أفضل مكان يمكن أن تساهم فيه في عملية التغيير، ويحقق لها الحرية المطلقة، منطلقة من إيحاءات رواية شهرزاد، معلنة انفكاكها من قيود الاستغلال وسلطة الأسرة والمجتمع وقيمه وأحكامه، خاتمة كتابها ” وأدركت شهرزاد الصباح، فلم تسكت عن الكلام المباح.. شهرزاد الحديثة تقول كل ما تريد وليس فقط ما هو مباح”،[21] بل وتفعل كل ما تريد منفكة بذلك من قيود الأسرة كمؤسسة كابحة لكل أشكال التحرر، وقد ترتب عن ذلك إنشاء قوانين تخول للمرأة فعل ما تشاء وهذا ما أشار إليه لنين في قول ” عما قريب يكون قد انقضى عام على صدور تشريع حر تماما بصدد الطلاق، ولقد أصدرنا مرسوما ألغى الفوارق في الوضع بين الولد الشرعي والولد غير الشرعي.. ولأول مرة في التاريخ أبطل قانوننا كل ما كان يجعل من المرأة كائنا بلا حقوق”.[22]
كما اعتبر هذا الاتجاه الأسرة مؤسسة منتجة لقيم التسلط والكبت وانعدام الثقة لدى الأبناء من خلال عناصر التدخل والضبط التي تمارسها هذه المؤسسة على أبنائها وهو أمر تؤكده الكاتبة المغربية نعمان جسوس بتساؤلها ” ما هو تأثير التقاليد على سلوك الإنسان وحياته الجنسية؟ وبالأخص ما موقف أجيال الشباب في بلادنا من التزمت الأخلاقي الذي يلقونه من أوساطهم الأسرية”[23]يقابله جواب هو، ضرورة الانفكاك من هذه القيود والتحرر من أغلالها، أي التحرر من مؤسسة الأسرة التقليدية والانفتاح على أشكال جديدة تتيح فرص أكثر في المساواة والتحرر، أشكال ترجمتها نماذج من الأسر المسماة كما سبق الإشارة بالأسر الجماعية (الكميونيات) التي يشترك فيها الجميع من النساء والرجال والأطفال مكونات العيش والحياة، وهذا أمر يؤكده أنجلز في كتابه أصل الأسرة، حيث اعتبر هذا النوع من الزواج هو ” الشكل القديم للعائلة الإنسانية البدائية، وهو الشكل الذي عليه دلائل لا تنكر ويمكن إلى اليوم مشاهدته بين قبائل بدائية عدة في أماكن مختلفة، هذا الشكل هو الزواج الجماعي الذي تكون فيه جماعات بإسرها من الرجال وجماعات بإسرها من النساء في علاقات جنسية مشتركة، وهو ما لا يترك مكانا للغيرة”.[24]
ويتيح حسب المدرسة ترسيخ قيم الحب والمسؤولية والتعاون، وتجاوز الفوارق الطبقية، والإحساس بروح التعاون، إذ ترى الكاتبة نوال السعداوي أن ” تحرير الأطفال من سلطة الآباء والأمهات جعلهم أسرع في النمو الجسدي والنفسي والفكري، واختلاطهم بزملائهم خلصهم من الأنانية والأثرة كما أن الآباء أيضا تخلصوا من كثير من الأنانية التي تربت معهم داخل أسرهم، وأصبحوا يشعرون بالحب لأطفال الغير كما يشعرون بالحب لأطفالهم، وكذلك أصبحوا يحبون عددا كبيرا من الناس، ولا يخافون الغرباء، وقد ساعد هذا على ازدياد موجة الإنسانية ولم تعد العلاقة بيولوجية، أو رابطة الدم هي التي تفرض نفسها على الأفراد، ولم يعد الأخ يتحيز لأخيه خاطئا أو مصيبا لأنه أخوه، ولم يعد رئيس العمل يتحيز لقريبه لأنه من أسرته، ولم يعد الأب يحنو على ابنه فحسب ويقسو على أبناء الآخرين، ولم يعد هناك طفل يتحمل وزر أخطاء أبيه أو أمه، ولم تعد هناك امرأة تخدم ورجل يسود، فقد تخلص الزوج من مفهوم النفعية وأصبحت العلاقة بين الرجل والمرأة تقد على أساس الحب الحقيقي”[25].
أي التحلل من كل مسؤولية أسرية، ومن كل شيء يربط أعضاء أسرة معينة ببعضهم البعض، في أسرة جماعية يتساوى فيها الجميع، بغرض تحقيق القيم الواردة في النص أعلاه، وهي قيم قابلة للتحقق دون اللجوء لإشكال من أسر جديدة لا يتوقع منها تحقيق ما ذكر من قيم، وقابلة للتحقق باعتماد معايير أخلاقية تتماشى والأهداف المرجوة من الأشكال الجديدة من الأسر المبشر بها لدى الاتجاه الماركسي.
إن الأسرة وأعضاءها ترتبط قيمتهم وما ينتجونه من قيم بطبيعة الوظائف الإنتاجية، وهو أمر يؤكده التحول في الموقف من الأسرة بعد أن تم إدراك أهمية وظيفتها في إنتاج اليد العاملة والعنصر البشري المساهم في الاقتصاد العام للمجتمع، إذ تم رهن وظيفة الإنجاب في الأسرة بطبيعة المساهمة في الإنتاج، بل ارتبطت وظيفة الإنجاب بوظيفة الإنتاج، إذ اعتبر الأطفال رأس مال بشري وإنتاج للنظام الأسري، يفيد المجتمع في بنائه العام ويخضع للنظام الاقتصادي السائد في المجتمع، إذ تؤكد الكاتبة نوال السعداوي أن” أن الإنتاج البشري (ولادة الأطفال) كأي إنتاج آخر في المجتمع يخضع للنظام الاقتصادي والاجتماعي السائد”[26].
وترتبط عملية الولادة بطبيعة النظام الاقتصادي، إي بطبيعة الوضع الاقتصادي السائد في البلد، حيث تقول ” إذا كانت الموارد الفلاحية والمادية قليلة وعدد الأطفال الذين يولدون كثير فإن المجتمع يبيح أي شيء من اجل أن يحدث التوازن بين الموارد الغذائية والمادية، وبين عدد الأطفال وذلك عن طريق ـ إما زيادة إنتاج الموارد الغذائية والمادية أو خفض إنتاج الأطفال”[27].
وهي نظرة واضحة في ربط وظائف الأسرة بالبعد الإنتاجي المادي المرتبط بالنظام الاقتصادي العام، وارتهانها لأهدافه ومصالحه.
ب: قيم الصراع:
يعتبر الصراع على السلطة والموارد المادية عنصر حاسم وموجه لطبيعة العلاقة التي تجمع أفراد الأسرة، وفي علاقتها مع باقي مكونات المجتمع حسب العديد من الدراسات الإنسانية الوضعية ، وتختلف درجة وطبيعة السلطة باختلاف الموقع من وسائل الإنتاج، وباختلاف الأنظمة الاقتصادية التي تعرفها المجتمعات، وهو أمر يؤكده أنجلز حيث اعتبر السلطة مبنية على ” امتلاك الرجال الثروة ووسائل الإنتاج، والنموذج أن سلطة النساء في المجتمعات الزراعية أقل من سلطة الرجل، باعتبار أن نظام الإرث يقضي بانتقال الأرض من الأب إلى الولد الذكر بالإضافة إلى انتقال الزوجة من بيتها إلى بيت زوجها، وكلما تحول الوضع نحو المجتمعات الصناعية ازدادت سلطة المرأة بل قد توازي سلطة الرجل في بعض الأحيان”[28]
وينعكس هذا على طبيعة العلاقة التي تجمع أعضاء الأسرة فيما بينهم، وهي علاقة يطبعها الصراع الناتج عن عدم المساواة في الحقوق والواجبات، ويُستَعمَلُ فيه وسائل وآليات عدة في تدبيره، وقد ذهب إنجلز إلى أن الصراع القائم بين الأزواج أمر طارئ وحادث بحداثة مؤسسة الزواج، حيث أقر بأن ” التنازع بين الجنسين لم يكن قد أعلن إلا اللحظة التاريخية التي ظهر فيها الزواج”[29] مؤكدا أن ” أول صراع طبقي ظهر في التاريخ كان مع الصراع بين الرجل والمرأة في ظل الزواج، وأن أول خضوع طبقي يتمشى مع خضوع المرأة للرجل”[30] ومعلنا أن ” إنهاء الانتساب للأم هو الهزيمة التاريخية العالمية للجنس المؤنث، فقد سيطر الرجل على السلطة في المنزل أيضا، وانخفض شأن المرأة وأصبحت عبدة لشهوة الرجل فاعلة لتربية الأطفال”[31].
إن الوقوف على النصوص السابقة لأنجلز ليؤكد طغيان نفس المظلومية التاريخية تجاه المرأة، جسدتها مؤسسة الزواج بأوضح صورة، معلنا بذلك للصراع الأبدي بين الجنسين ما دامت مؤسسة الزواج قائمة، صراع ينطلق من نظرة الضعف والقهر المسلط على المرأة حسب المدرسة بسبب التراجع عن مبدأ التشارك الذي يلغي مبدأ الملكية والتحكم في مصير المرأة في مؤسسة الزواج، وسيادة مبدأ التسلط الذي أفضى إلى الصراع بين الرجل والمرأة، وهو أمر بينته الكاتبة نوال السعداوي في دراستها عن المرأة بقولها ” إن الصراعات الأساسية في الحياة البشرية ليست صراعات بين نوعين من الأفكار، أفكار ضعيفة وأفكار غير حقيقية، ولكنها صراعات بين نوعين من الناس، نوع معه سلطة، ونوع مضطهد ينشد التحرر من السلطة، ومن الطبيعي أن يحمي أصحاب السلطة سلطتهم بأفكار معينة، ويضربوا بيد من حديد كل من يهدد سلطتهم”[32] وهو أمر يجسد مبدأ الظلم والاستبداد في حق المرأة ” ويُعَودُ المظلوم على الخنوع والذل، ويُعَودُ الظالم على القسوة والبطش والعدوان، وهذا ما حدث لكل من شخصية المرأة والرجل في ظل قوانين الزواج الجائرة”[33].
أي في ظل مؤسسة الزواج التي أعلنت سيمون دي بوفوار فشلها وخطورتها، بل اعتبارها ” مؤسسة فاسدة من أساسها، إذ مجرد الإعلان بأن رجل وامرأة ملزمين بواجب إرضاء بعضهما بكل الطرق الممكنة، طيلة حياتهما يعد أمرا بشعا رهيبا، يؤدي بالضرورة إلى ظهور النفاق والكذب والكراهية والتعاسة”[34].
مما يدفع بالطرف الأضعف في الصراع والمتمثل في المرأة إلى البحث عن مختلف الأدوات الممكنة لتدبير هذا الصراع، والتي قد تظهر في شكل اصطدامات مباشرة أو انتقامات مستترة، أو في شكل طلبات وحاجات، إذ تؤكد الكاتبة نعمان جسوس أن ” الزوجة الحامل تقوم بسلسلة انتقامات نتيجة الإكراهات التي تقع في العادة وتتجلى هذه الانتقامات في الحياة اليومية في الاشتهاءات والرغبات الجامحة التي تطلبها المرأة من بعض المواد الغذائية المتعذر إيجادها”[35]. أو مهور مرتفعة تدير بها المرأة عملية الصراع، وتشهرها أثناء الحاجة إليها، بحيث تؤكد الكاتبة أن ” الفتاة تحيط نفسها بضمانات لكثرة الأمثلة عن النساء اللاتي تخلى عنهن أزواجهن، ولشدة خوف الزوجات وخوف أسرهن من مواجهة ما يتهدد الزيجات من عدم الاستقرار”[36]. أو في شكل أدعية باعتبارها حسب زهير حطب ” أداة الصراع الوحيدة المتاحة لها، فهي إذا غضبت أو أصابها ظلم حتى من أقرب الناس إليها تنهال عليه إما جهارا أو خفية بالدعوات طالبة من الله أن ينتقم منه ويعاقبه، ولا بأس حتى بان يكسر رجله أو يمينه، وهي تستعمل مثل تلك الأسلحة المضادة حتى مع طفلها”[37].
أمر يؤكد أن نفس الصراع لا يقتصر على الأزواج وحدهم بل يتعداه لمختلف مكونات الأسرة كعلاقة المرأة مع الحماة التي تنطبع بعلاقة الصراع حسب هذا الاتجاه، إذ تؤكد نعمان جسوس أن العلاقة ” بين الكنة والحماة تنطبع من أول اتصال بينهما بطابع البغض المتبادل، ويحكم هذه العلاقة الصراعية ويوجهها جهاز كامل من الأفكار الجاهز والمسبقة”[38] تتمثل في اعتقاد الحماة بسرقة الزوجة لابنها، وهي فكرة متأصلة حسب الكاتبة في أذهان النساء كبيرات وصغيرات، إذ تؤكد أن ” المرأتان تتصارعان من أجل السيطرة، إذا صح التعبير على أرض تعتقد كل واحدة منهن أنها صاحبة الحق فيها”[39].
كما يبين أن نفس الصراع يمتد إلى الأطفال والأبناء من طرف الآباء، وقد يجد انعكاسا تجاه الآباء على ما يصطلح عليه بصراع الأجيال، حيث يؤكد أنصار المدرسة الوضعية على أن العلاقة القائمة بين الآباء والأبناء علاقة قائمة على قيم التسلط تثبت ذلك الأستاذة نوال السعداوي، في قولها أن ” العلاقة بين الأب وابنه تقوم على سلطة الأب على ابنه فهي علاقة صاحب سلطة وشخص صغير بغير سلطة، وهي علاقة كبير أعلى بصغير أدنى”[40].
وفي إطار هذا الوضع يفسر الصراع القائم بين الأجيال، بل والانحرافات السائدة في أوساط الأحداث والشباب، وغيرها من الأضرار النفسية والمرتبطة بطبيعة الشخصية من انعدام الثقة بالنفس إلى فقدان الاستقلالية والقدرة على الإبداع.
وتختلف السلطة باختلاف مصدرها لدى الأبوين، فهي إن كانت تتسم بالشدة لدى الأب فقد تتسم بالمحبة عند الأم، إذ الأم في الأسرة ” تعوض عن وحدتها بالتصاق شديد بطفلها، وبهذا الحنان المريض تعطل قدرته عن الاستقلال عنها، وقد اتضح أن حالات الشذوذ الجنسي التي أصبحت تتزايد بين الذكور، أحد أسبابها تلك الأمومة المريضة في الأسر الحديثة”[41].
فالأسرة مؤسسة يُعنَفُ فيها الأحداث بمختلف الوسائل لترسيخ قيم تقليدية تهد من شخصية الطفل وتؤول به إلى الخنوع والاستسلام تحت غاية التدريب على الطاعة والإذعان، إذ ” علاقة الولد بالأب في جميع العلاقات علاقات سلطوية أبوية تؤكد على قيم الطاعة وما يرافق ذلك من خوف وتودد وخضوع”[42].
سمة تجد انعكاسها من الأبناء تجاه الآباء، إذ يلجأ الأبناء إلى الدخول في مواجهات من أجل إثبات الذات والتداول على مركز السلطة والقرار وتداول وضبط العملية.
وهي نتيجة مطلوبة في نتائج هذه الدراسات، حيث يؤكد تروتسكي على ضرورة مساهمة الدولة في تعزيز هيبة الأجيال الصاعدة على حساب الآباء والكبار، خشية تلبس الأطفال بقيم آبائهم وأسرهم وتأسيسا للصراع بينهم، حيث يدعوا ” إلى تعهد الدولة بتربية الأجيال الطالعة وأن لا تبالي بتعزيز هيبة الكبار وبخاصة هيبة الأب والأم، بل تسعى على العكس إلى فصل الأطفال عن الأسر لتحصينهم ضد الأخلاق والأعراف القديمة، وحتى إلى عهد قريب كانت المدرسة ومنظمات الشبيبة الشيوعية تهيب بالأولاد أن يفضحوا الأب السكير، أو الأم المؤمنة، أن يجللوهما بالعار، أن يحاولوا إعادة تربيتهما.. بيد أن ذلك النهج كان يهز بكل حال أسس السلطة العائلية بالذات، وقد تحقق في هذا المضمار تغيير جدري لا يخلوا من أهمية”[43].
إنه نفس صراعي حاكم وموجِه لشبكة علاقات الأسرة، والذي يساهم في بلورة وإنتاج قيم حاكمة في هذا الاتجاه، قيم لا تخلوا من نفس الأسس المنهجية والأهداف المعلنة والخفية للمدرسة الوضعية، خاصة في شقها الماركسي.
ويعتبر نفسا موجها لتفسيرات وتحليلات مختلف العلاقات السائدة داخل المجتمع وبين مؤسساته، كما داخل مؤسسة الأسرة نفسها، وهو ناتج عن الموقع من وسائل الإنتاج، أو بعابرة أخرى ناتجا عن القدرة والتحكم في السلطة.
يتعارض هذا النفس الصراعي مع مفاهيم التعاون والتضامن والتدافع، بل ويعتبر وسيلة لتحقيق توازن محل توازن زائل، إذ ” الفكرة الأساسية في المنظور ألصراعي تدور حول أن الحياة الاجتماعية تتصف بصراع المصالح الفردية، والتغيير هو نتيجة هذا الصراع الذي يحطم التوازن السابق وينتج توازنا جديدا يحمل بدوره صراعات جديدة، وبنية الأسرة تخلق ظروفا خاصة ملائمة لتضارب مصالح أفرادها وصراعاتهم، وهذه الصراعات الداخلية تعكس في الواقع عداوات أساسية متأصلة في البنية الاجتماعية الكبرى، فالصراعات الزوجية مثلا غالبا ما تتعلق بتوزيع الموارد، وتوزيع العمل وممارسة السلطة داخل الأسرة”[44].
إن علاقات الأسرة الداخلية بناء على ما سبق قائمة على الصراع الدائم بين أعضائها بسبب الموارد المادية، والموقع من السلطة، فالزوج في صراع دائم مع زوجته، والآباء في صراع مستمر مع أبنائهم، والأبناء في صراع دائم فيما بينهم، لأن علاقاتهم تحكمها المادة والمصالح الفردية حسب القيم السابقة، مما ينتج عنه قيم أخرى تتمثل في الحقد والعداوة والتنافس المحموم الذي لا يخلوا من ضغائن ودسائس.
فالزواج في أصله حسب إنجلز لم يظهر نتيجة توافق بين الرجل والمرأة، بل خضوع من جنس لجنس، فكان المآل التنازع والصراع المستمر، مع استمرار مؤسسة الزواج، كما أن العلاقة مع الأبناء قائمة على صراع مستمر، ومنبعه الرغبة في السيطرة التي يمارسها الآباء، والرغبة في التحرر التي ينضح بها الأبناء، أي الصراع بين قيم جيل سابق يريد الاستمرار في أبنائه، وتحقيق وجوده وذاته فيهم، وبين قيم جيل جديد يريد أن يكتشف ذاته وينفك عن قيم وعادات وثقافات آبائه وأجداده وأسلافه.
ت: قيم الفردانية:
فردانية جسدتها مظاهر الصراع الذي افتعلته التيارات النسوية، التي سعت جاهدة في هدم مؤسسة الأسرة والتأسيس لمرحلة الكميونات التي يشترك فيها الجميع من أجل الجميع بهدف استقلال الذات الفردية من ثقل المسؤولية، وهو ما تقصده الحركات النسوية ، حيث ” أعلنت عند انطلاقتها على جنسانية المرأة وحقها بالسيادة على جسدها”[45] لأن ” تحرير الجسد لا ينفصل عن تحرير الروح والعقل، باعتبار أن الرجل يملك جسد زوجته لكنها لا تملك جسد زوجها لأن الرجل ينظر إليه كذات مستقلة عن المرأة، والرجل يتمركز حول ذاته ويحقق ذاته دون أن يلومه أحد ودون أن يتهمه أحد، إنه ضد الأخلاق والدين”[46]
أي الهدف تحرير ذات المرأة ولو على حساب مختلف القيم، وقد وجدت هذه التحركات صداها في العديد من التشريعات الأسرية التي أقرت بتسيير الأسرة من طرف الزوج والزوجة في إغفال تام لوجود هذا التسيير في واقع الأمر، وفي طموح قائم لتحقيق المساواة الميكانيكية كأجلي تعبير عن مبدأ الفردانية والاستقلالية، وفي رغبة جامحة في تحطيم قيم الجماعة، وقد جسد هذه القيمة الدعوات المتكررة لأصحاب هذا الاتجاه في فصل الأبناء عن الأسرة ترسيخا لهذه القيمة في شخصيتهم، وهو ما أكده تروتسكي سابقا في دعوته إلى عدم تعزيز هيئة الكبار، وبخاصة الأب والأم ” وفصل الأطفال عن أسرهم لتحصينهم من الأخلاق والأعراف القديمة”[47].
أي تحصينهم من قيم الجماعية وآثارها، وترسيخ قيم الفردانية في مختلف أبعادها، التي ترتب عنها تحلل من المسؤولية، وتزايد مستمر في تراجع الأسر والولادات كأجلى تعبير عن تراجع مؤسسة الأسرة، يؤكد ذلك إحصاءات ومعطيات في هذا الباب، حيث ” سيتقلص حجم سكان ألمانيا حسب بعض علمائها في الديموغرافيا ( هيرفينغ ) من 83 مليون إلى 32 مليون، وحجم سكان إيطاليا من 58 اليوم إلى 15 مليون نسمة عام 2100 وسيتناقص سكان اليابان من 128 إلى 112، وروسيا من 143 إلى 112 مليون عام 2050، كما سيتقلص سكان الاتحاد الأوروبي سنة 2050 من 455 مليون إلى 400 مليون نسمة، والاتحاد الأوروبي يحتاج اليوم إلى 13,5 مليون مهاجر لتغطية خصاص السنوات السابقة، ويحتاج سنويا إلى 1,6 ملون مهاجر من القوة العاملة للموازنة بين المواطنين العاملين والمتقاعدين، إنها أسرة أمة تشتعل شيبا”[48]
كما يتجسد ذلك في مظاهر العيش والعلاقات التي أصبحت سائدة في مختلف المجتمعات داخل الأسر، وبين أفراد العائلة الواحدة، وبين الأسر ومحيطها الاجتماعي، حيث التضخم المتوالي للفرد والتراجع المستمر للقيم التراحمية الجماعية على مستوى العادات والأعراف المتعلقة بالولائم والأفراح وعادات الأكل والحفلات وغيرها من العلاقات الاجتماعية، لحساب القيم الفردية والتعاقدية التي جعلت من الفرد مركز العلاقة بدل الأسرة.
3: الواقع العربي والقيم الأسرية:
إن تتبع واقع الأسرة العربية وما طالها من تحولات على مستوى البنية والوظيفة وشبكة العلاقات، يثبت أن ما تم التنظير له والتأسيس له في مدارس علم الاجتماع الوضعي وجد صداه في ثقافات وفكر العديد من المجتمعات، بل وفي سياساتها العمومية في مختلف القطاعات الإعلامية والتعليمية والثقافية والتشريعية، فنتج عن ذلك ما سبق إقراره والاستدلال عليه من أنواع القيم التي نتجت عن الأسس النظرية للمدارس الوضعية، يؤكد ذلك العديد من المعطيات والشواهد الاجتماعية، من مثل العادات الاجتماعية الخاصة بالأفراح والأتراح، حيث كانت العلاقة تتأسس على قيم التضامن والتراحم، وهي قيم بدأت تتلاشى أمام زحف قيم التعاقد والمادة كما سبقت الإشارة، والتي أصبحت تحكم العلاقات وتوجه التصرفات، حيث تراجعت عادات التعاون في مثل هذه المناسبات، حيث كانت الأسر والجيران يعملون على توفير احتياجات بعضهم البعض من تجهيزات منزلية، وموارد بشرية، واحتياجات أمنية تضمن نجاح المناسبة، دون الحاجة إلى البحث عن أطراف تتعاقد معها بمقابل مادي للسهر على نجاح مناسبتها.
كما يثبت هذا التحول نظرة العديد من الأسر لوظيفة الأبناء في الأسر والمراهنة عليهم بدرجة كبرى في تحقيق الاستقرار المادي للأسر، وتأمين التقاعد الوظيفي للآباء، حيث الرهان على الإنجاب، لا لتحقيق قيم الأبوة كقيم مجردة عن المصلحة المادية، بل تحول التفكير أمام زحف قيم المادة في الأبناء كضمان استقرار واستمرار للأسر واحتياجاتها المادة ومصالحها الدنيوية.
ويؤكده أيضا التحول في النظرة للزواج وطبيعة العلاقة بين الأزواج، التي يؤصل لها النص القرآني ” ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون”الروم 21، حيث طغت الاعتبارات الفردية، وتنازعت المصالح الشخصية، فاحتكم الأزواج للتعاقد حماية للمصالح، وخوفا من المستقبل،فغابت السكينة عن العلاقة، وتوارت المودة والرحمة لحساب المصلحة والوثيقة.
كما يتجلى هذا التحول في مظاهر العيش والأكل والتعليم… وغيرها من التقاليد والعادات الأسرية التي كانت تنضبط لقيم التراحم والتعاون، وتتأسس على قيم التضامن، فتغيرت لتخضع لقيم الفردانية والتعاقد المنضبط للمصالح المالية والمادية و المتنوعة لتنوع طبيعة بيئة الأسر وعلاقاتها.
وهو ما يفرض الوعي بخطورة التحديات التي تواجه الأسر، والتي تنعكس في مستوى وطبيعة التنشئة والتربية التي يتلقاها الأبناء، وفي طبيعة العلاقات التي تنسجها وتربطها داخل محيطها العائلي، وفي محيطها الاجتماعي، وكذا الوعي بأهمية الأسرة وبوظيفتها، وحقيقة الأدوار التي يمكنها القيام بها على مختلف مستويات ومجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية…، وعلى مستوى استقرار المجتمع واستمراره، ثم العمل على تقوية وظيفتها وحضورها في الدراسات العلمية الاجتماعية والسياسية والأنثربولوجية، وحمايتها بالتشريعات القانونية المباشرة التي تحصنها وتقوي وظيفتها ودورها، وغير المباشرة المتصلة بالإعلام والتعليم والثقافة… بحيث يتم العمل على تعميم الوعي الاجتماعي والثقافي الضامن لسلامة الأسرة في بنيتها ووظيفتها وشبكة علاقاتها، فضلا عن ذلك مطلوب تضافر الجهود من مؤسسات المجتمع المدني، وتأسيس المراكز والمراصد المهتمة بها، والتي تتبع قضاياها بما يقوي من وظائفها ومهامها.
لائحة المصادر والمراجع.
- القرآن الكريم برواية ورش.
- د: محمد أمين فرشوخ، الأسرة والقيم بين الجماعتية والفردية، كتاب القيم في التربية والإعلام،
- د: حليم بركات.المجتمع العربي المعاصر، بحث استطلاعي اجتماعي،
- تعددية القيم، ما مداها وما حدودها؟ د: طه عبد الرحمان، سلسة الدروس الافتتاحية، د: 2، أكتوبر 2001 بجامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش، ط:1/2001،.
- د: محمد الزبيدي.القيم والاتجاهات،
- ذ، نوال السعداوي، المرأة والدين والأخلاق، حوارات القرن الجديد، دار الفكر لبنان، ط:1424هـ/2004م.
- د: عبد الرحمان بدوي.الأخلاق النظرية،
- د: فوزية دياب، القيم والعادات الاجتماعية، دار النهضة العربية، بيروت، ط: 1980،.
- د: محمد الكتاني.أزمة القيم ودور الأسرة في تطور المجتمع المعاصر،
- د: توفيق الطويل، أسس الفلسفة، دار النهضة العربية، مصر، دون تاريخ ورقم الطبعة .
- د: محمد بلبشير الحسني، مدونة القيم في القرآن والسنة، منشورات المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، ط:2008،.
- د: محمد الغريب عبد الكريم،السوسيولوجيا الراديكالية، رؤية نقدية تحليلية في النظرية الماركسية، المكتب الجامعي الحديث،ط:1/1988.
- صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي، تحقيق محمد بن عيادي بن عبد الحليم، مكتبة الصفا، ط:1، 1422/ 2003.
- تحرير الدكتور عبد الوهاب المسيري، إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد، الصادر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط:1417 هــ، / 1997م.
- د: محمد بلفقيه، العلوم الاجتماع ومشكلة القيم، تأصيل الصلة، منشورات المعارف الجديدة الرباط، ط: 1: 2007.
- د: محمد محمد أمزيان، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية، بيت الحكمة للترجمة والنشر، وجدة، المغرب. ط:3، 1416هـ/ 1996م.
- إميل دوركايم، قواعد المنهج في علم الاجتماع، ترجمة د: محمود قاسم، مراجعة د: السيد محمد بدوي، دار المعرفة الجامعة، الاسكندرية، ط:2/ 1988.
- فريدريك أنجلز، أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة، ترجمة أحمد عز العرب، دون رقم وتاريخ دار الطبعة.
- لينين، ريا زانوف وآخرون، المرأة الاشتراكية، ترجمة وتقديم جورج طرابيشي، منشورات دار الآداب، الطبعة 3/1979.
- المرأة في الثرات الاشتراكي، ماركس ـ أنجلز ،ماوتسيتونغ وآخرون، ترجمة جور طرابيشي، دار الطليعة بيروت: ،ط: 1977.
- د: كنزة لعمراني العلوي، الأسرة المغربية، ثوابت ومتغيرات ، تقديم فاطمة المرنيسي، الجديد في النشر والتوزيع، دون رقم وتاريخ الطبعة.
- ذ: فاطمة المرنيسي، شهرزاد ليست مغربية، ترجمة ماري طوق، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط:1/ 2002.
- سمية نعمان جسوس، بلا حشومة الجنسانية النسائية في المغرب، ترجمة عبد الرحيم حزل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط:1/2003،.
- حسين بستاني (النجفي) الإسلام والأسرة، دراسة مقارنة في علم الاجتماع، تعريب على الحاج حسين، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، سلسلة الدراسات الحضارية، بيروت، ط:1/ 2008،.
- د: زهير حطب، تطور بنى الأسرة العربية، الجدور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة، ص: 182، معهد الإنماء العربي، فرع لبنا، ط: 3/1983.
- بينارإيلكاركات، المرأة والجنسانية في المجتمعات الإسلامية، ترجمة معين الإمام، دار الهدى للثقافة والنشر، ط:1/2004.
- د: نوال السعداوي، دراسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط:2/1990.
- د: حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر، بحث استطلاعي اجتماعي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط:9/2006.
- د: عادل العوا، فلسفة القيم، جان ـ بول رزفبر، تعريب دار النشر والطباعة عويدات، بيروت لبنان، ط:1، 2001.
- د: رالف بارتن بيري، أفاق القيمة دراسة نقدية للحضارة الإنسانية، ترجمة عبد المحسن عاطف سلام، تقديم دك زكي نجيب محمود.
المجلات:
- مجلة الفرقان، ع: 60/ 1429/2008، مقدمة.
- تقديم الأستاذ امحمد طلابي، في مجلة الفرقان المغربية، عدد: 57، سنة: 1428هـ/ 2007م.
- ارتقاء القيم دراسة نفسية، د: عبد اللطيف محمد خليفة، مجلة عالم المعرفة، ع: 160، أبريل 1992.
[1]: اخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب القدر، رقم: 2658.
[2]: للتفصيل في هذا المحور يمكن العودة لدراسة قيمة للدكتورة هبة رؤوف عزت، حول الأسرة والدولة: الماضي الغربي أم المستقبل الإسلامي، كتاب إشكالية التحيز، الجزء الثاني، ص: 337.
[3]: للتفصيل في هذا المحور يمكن العودة لدراسة قيمة للدكتورة هبة رؤوف عزت، حول الأسرة والدولة: الماضي الغربي أم المستقبل الإسلامي، كتاب إشكالية التحيز، الجزء الثاني، ص: 339.
[4]: د: محمد بلفقيه، العلوم الاجتماع ومشكلة القيم، ص: 113.
[5]: نفسه ، ص: 10.
[6]: د: محمد أمزيان، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية، ص: 22.
[7]: إميل دوركايم، قواعد المنهج في علم الاجتماع، ترجمة د: محمود قاسم، مراجعة د: السيد محمد بدوي، ص:23.
[8]: نفسه، ص: 90.
[9]: فريدريك أنجلز، أصل العائلة، والملكية الخاصة والدولة، ترجمة أحمد عز العرب ص: 70.
[10]: نفسه، ص: 75.
[11]: نفسه، ص: 40.
[12]: نفسه، ص: 96.
[13]:بقلم لينين، ريا زانوف وآخرون، المرأة الاشتراكية، ترجمة وتقديم جورج طرابيشي، ص: 71.
[14]: دراسات عن المرأة والرجل، ص: 267.
[15]: نفسه، ص: 92.
[16]: د: كنزة لعمراني العلوي، الأسرة المغربية، ثوابت ومتغيرات، ص:60، تقديم فاطمة المرنيسي
[17]: د، كنزة لعلوي، بلا حشومة، ص: 88.
[18]: نفسه، ص: 89.
[19]: ذ، نوال السعداوي، دراسات عن المرأة والرجل، ص: 99.
[20]: ماركس، إنجلز..،المرأة في التراث الاشتراكي، ص:124.
[21]: ذ: فاطمة المرنيسي، شهرزاد ليست مغربية، ترجمة ماري طوق، ص: 115.
[22]: المرأة في التراث الاشتراكي ، ص: 124.
[23]: سمية نعمان جسوس، بلا حشومة الجنسانية النسائية في المغرب، ترجمة عبد الرحيم حزل، ص:12.
[24]: أصل العائلة، ص: 27.
[25]: ذ، نوال السعداوي، دراسات عن المرأة والرجل ، ص: 104.
[26]: نفسه، ص: 279.
[27]: ذ، نوال السعداوي، دراسات عن المرأة والرجل ، ص: 279.
[28]: حسين بستاني، (النجفي) الإسلام والأسرة، دراسة مقارنة في علم الاجتماع، تعريب على الحاج حسين، ص: 206.
[29]: إنجلز، أصل العائلة، ص: 60.
[30]: أصل العائلة، ص: 60.
[31]: نفسه، ص: 50.
[32]: دراسات عن المرأة والرجل، ص: 174.
[33]: نفسه، ص: 267.
[34]: علم اجتماع الأسرة، ص: 140.
[35]: بلا حشومة، ص: 114.
[36]: نفسه، ص: 114.
[37]: د: زهير حطب، تطور بنى الأسرة العربية، الجدور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة، ص: 182.
[38]: بلاحشومة، ص: 100.
[39]: نفسه، ص: 101.
[40]: دراسات عن المرأة والرجل، ص: 102.
[41]: دراسات عن المرأة والرجل ، ص: 102.
[42] : د، حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر، بحث استطلاعي، ص: 233.
[43]: المرأة في التراث الاشتراكي، ص: 197.
[44]: علم اجتماع الأسرة، ص: 93.
[45]: بينار إيلكاركات، المرأة والجنسانية في المجتمعات الإسلامية، ترجمة معين الإمام، ص:9.
[46]: دراسات عن المرأة والرجل، ص: 231.
[47]: المرأة في التراث الاشتراكي، ص: 197.
[48]: تقديم الأستاذ امحمد طلابي، في مجلة الفرقان المغربية، ص: 9، عدد: 57، سنة: 1428هـ/ 2007م.