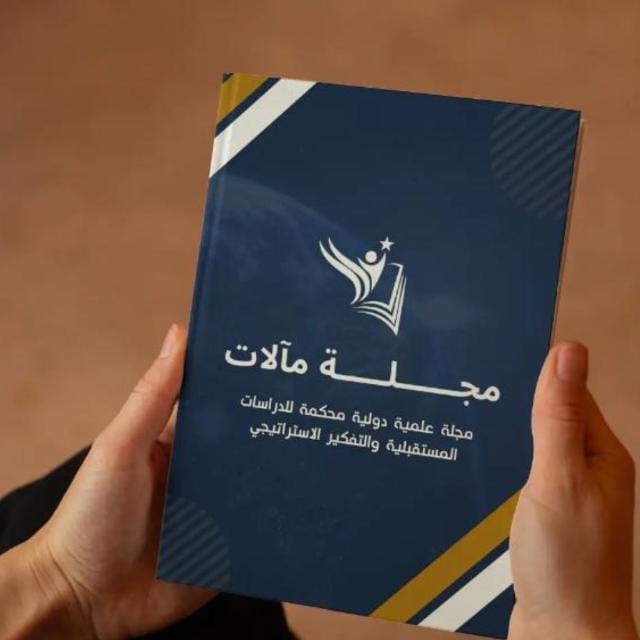إعداد: د.يونس عتيق الله / Younes atikallah
كلية الآداب والعلوم الإنسانية / جامعة محمد الخامس- الرباط
ملخص البحث
يروم علم النفس معالجة الاضطرابات النفسية التي يعاني منها الإنسان بناء للشخصية المتوازنة، تلك الشخصية القادرة على العطاء، وهو نفس الهدف الذي يعمل القرآن على تحقيقه ما دام الإنسان محور الكون، وفي هذا الصدد من البديهي أن يتم الاشتغال على النص القرآني لملامسة سبل التعامل مع بعض الظواهر النفسية، مما يدفع للتساؤل عن قيمة البعد النفسي في القرآن، وإلى أي حد يمكن اعتبار نصوصه مساحات مهمة لاستنبات بعض المقاربات العلاجية التي يمكن أن تشكل إضافة علمية نوعية لمجال علم النفس، وبالخصوص في الشق المتعلق بالصحة النفسية. وكثيرة هي المواقف التي تَعرَّض إليها القرآن وتم من خلالها إرسال إشارات تفيد الحضور القوي للبعد النفسي في نصوصه، وتحفز المتلقي للاجتهاد واستخراج الرسائل المتضمَّنة فيه، كي تحافظ على الصحة النفسية للإنسان.
الكلمات المفتاحية:
البعد النفسي – النص القرآني – مقاربات علاجية – الصحة النفسية
Résumé
La psychologie vise à traiter les troubles psychiatriques afin de construire une personnalité harmonieusement équilibrée. C’est le point d’intersection avec le coran qui considère l’Homme en tant qu’axe principal parmi les autres créatures.
A cet égard, il est indispensable d’approfondir les recherches à propos des textes coraniques pour extraire les modalités de traitement des phénomènes psychologiques, ce qui impose de penser à la valeur du volet psychologique dans le coran et aussi à quel point on peut considérer ses textes comme terrain d’extraction des approches thérapeutiques qui peuvent être une valeur ajoutée pour la psychologie.
Il est primordial de citer plusieurs aspects dans le coran où le volet psychologique a été fortement présent, pour inciter le récepteur à conclure les messages implicites des textes coraniques afin de préserver la santé mentale.
Les mots clés
La dimension psychologique – le texte coranique – les approches thérapeutiques – la santé mentale
البعد النفسي في النص القرآني: مقاربات علاجية
يعد الإنسان أهم مخلوق في هذا العالم، ومن تم كان محل اهتمام الدارسين على اختلاف مشاربهم، بل وإن رسالات السماء تمحورت حول إصلاح شأنه وتأطير مسيره، وحينما نتكلم عن الإنسان، فمن البديهي أن نتكلم عن الجانب النفسي فيه باعتباره البناء الداخلي الذي يؤثر في سلوكه ويؤطره، وما دامت النفس الإنسانية منطلق الفعل الإنساني، فإن البعد النفسي حاضر بين ثنايا الوحي، ولا غرو أن ينحو النص القرآني هذا المنحى من خلال محاورته للمتلقي تشذيبا لما تختزنه دواخله وتأسيسا لماهيته حتى يتحقق له الاستخلاف في الأرض وفق الموازين الحقة.
ارتباطا بالاستخلاف السابق الذكر، فإنه الكلمة المفتاح في حوار الله سبحانه مع الملائكة، “وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ”[1]، والآيات هنا تحمل دلالات نفسية عميقة، إذ أستشف بوصفي متلقيا أن عملية التفكير أثناء أي حوار- مع إبراز التصورات – ظاهرة صحية عند مواجهة أي موقف يُدخل الدماغ في نشاط عقلي “عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق حاسة من الحواس، إذن نستطيع القول إنه تقص محكم ومدروس للخبرة من أجل غرض ما، وقد يكون ذلك الغرض هو الفهم أو اتخاذ القرار أو التخطيط، أو حل المشكلات أو الحكم على الأشياء أو القيام بعمل ما”[2]. وظاهر الآيات هنا يحمل شيئا من الإنكار، كما لو أن الملائكة يرفضون هذا الاستخلاف، مذكرين بميزات الحمد والتسبيح والتقديس التي هم مواظبون عليها، إنه نوع من القلق، وهو قلق عاد يفرضه الموقف، وكأني بالقرآن يقول: إن القلق أمر طبيعي، “وما معنى حياة لا يجد فيها الإنسان قلقا أو خوفا أو هما…؟ وما معنى حياة يتوقع الإنسان منها أن تمضي دائما هادئة وسهلة كبحيرة ساكنة، لا تحركها رياح مفاجئة ولا يقلقها فيضان مفاجئ؟ هذا الإنسان غيرموجود. وليست هكذا الحياة. والإنسان الذي لا يستشعر قلقا أو خوفا أو بؤسا مصاب في وجدانه، وتلك حالة مرضية”[3].
ومن الملاحظ أن خطاب الله عز وجل في بداية الحوار جاء خاليا من الأمر، وتلك ومضة تربوية نفسية تلقننا أدب الطلب، فالإنسان بطبعه يرفض الأوامر “ويعتبر التعبير عن رغباتنا في شكل أوامر صورة أخرى للغة التي تعوق التعاطف، فالأمر يمثل تهديدا صريحا أو ضمنيا للمتلقي بأنه سيتعرض للوم أو العقاب إذا أخفق في الإذعان والطاعة. وهي صورة شائعة في عالم اليوم، ويستخدمها على وجه الخصوص كل من هم في موقع السلطةّ”[4]
ويبقى الحوار مستمرا بضوابط الإقناع، ليأتي الاستدلال على أحقية الإنسان بالاستخلاف في الأرض دون غيره، إذ عُلِّم الأسماء كلها، فتطفو حينها على السطح خصيصة العلم، وهنا يستجلي المتلقي رسالة أخرى مفادها أن العالِم له الريادة، ريادة يسلم لها الجميع، لذلك جاء الإقرار من الملائكة، فنستوعب بطريقة إرادية أن وجودنا رهين بعلمنا، فمتى تعلمنا وأقبلنا على محاضن العلم حققنا هذا الوجود، وإلا فنحن كائنات غير التي أُريد لها الاستخلاف في الأرض، ولا يمكن أن ننكر هنا القيمة الرمزية للعلم من الجانب النفسي باعتباره أحد الضمانات المهمة لتحقيق استقلالية الذات من خلال حسن التفكير والنقد وطرح الأسئلة الضرورية لمعالجة مختلف الإشكالات. فالحوار هنا ليس حوارا بين الله والملائكة فحسب، بل هو في العمق حوار بين الله والإنسان عبر بعد نفسي يستشعر معه هذا الأخير أن المنطلق كان ما تَعَلمه آدم عليه السلام، ولا يمكن للمسير أن يستمر إلا إذا ظل مرتبطا بمنطلقاته، أي بلزوم التعلم، ومنه نفهم أن لغة الحوار القرآني لغة مرنة لا يتسلل إليها الجمود، وفي نظري تبقى اللغة المرنة لغة حلول ولغة وصال “فالتواصل غير العنيف هو لغة مرنة ترفض التعميمات الجامدة”[5] وحيث إن الجمود ظاهرة سلبية، فإن اللغة الجامدة التي ليست لها القدرة على الامتداد في الزمن وفق ما يستجد، غالبا ما تكون عائقا أمام المتلقي،”وقد أشار ويندل جونسون المتخصص في علم المعاني، إلى أننا نخلق لأنفسنا الكثير من المشكلات من خلال استخدام لغة جامدة للتعبير عن واقع دائم التغيير أو لوصف هذا الواقع…غير أن العالم الذي نحاول أن نرمز إليه من خلال هذه اللغة هو عالم يتسم بالمرونة والتغير والاختلافات والأبعاد والعمليات والعلاقات والتطورات والتفاعلات والتعلم والتكيف والتعقيد. ومحاولة التوفيق غير الملائم بين عالمنا المتغير بصفة دائمة وأشكال اللغة الجامدة نسبيا هي جانب من مشكلتنا”[6]، خاصة وأن النفس البشرية ميالة إلى الحياة بحيويتها وديناميكيتها وتجددها المستمر، والقرآن هنا يغرس فينا هذا المنهج تفاديا للتصادم مع الآخر.
وفي نفس السياق المناهض لكل الاختلالات النفسية، نلاحظ أنه إذا كان الملائكة آمنو بأمر الله جميعهم، فإن حالة استثنائية برزت في الآية اللاحقة حيث قال الله سبحانه وتعالى: “وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ”[7]. إبليس هنا شكل الاستثناء بمعارضته وعصيانه، وأظنها رسالة أخرى تعزز قبول النفس للمعارضة في أي موقف، إذ لا يمكن تصور الإجماع العام، فكثيرة هي المواقف التي يخال المرء فيها نفسه محل اتفاق، ليبرز العكس الذي ينجم عنه الانهيار النفسي، وربما الاكتئاب، تلك رسالة أخرى تهدف تقويم البناء النفسي، وهي رسالة يؤكدها حوار آخر لكنه مباشر هذه المرة بين الله عز وجل وإبليس في سورة الأعراف إذ يقول سبحانه:”وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ، قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ”[8]، تكبر إبليس وشعوره بأناه واضح جدا (أنا خير منه) وأستطيع أن أقول إنه أول ظهور لمصطلح (الأنا) الذي كان ولا يزال محط اهتمام وتحليل علماء النفس، باعتباره عائقا سلبيا يسهم في تضخم النفس، مما يستدعي العلاج وهو أمر من الصعب بما كان إذ “قلما نجد في المراجع التحليلية للأنا أي وصف لأية تقنيات علاجية خاصة. أما بالنسبة لفائدة العلاج التحليلي للأنا فإنه لا يوجد حتى اليوم أي دليل مقنع فعلا “[9]. وإذا كان علاج الأمراض أو البحث عن حل لها أمرا مرغوبا فيه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يستمر في حوار إبليس إرشادا له وتنبيها، و إنما مر مباشرة إلى النتيجة والتي هي عقاب واضح وصريح، ولعل العلماء الذين اهتموا بالاتجاه التحليلي للأنا “ككارين هورني و أنا فرويد و إيرك إيركسون وديفيد رابابورت وهاينس هارتمن”[10] لم يطلعوا على القرآن الكريم، وهنا أستطيع أن أقول إن علم النفس الحديث ما دام لم يهتم بدراسة الخطاب القرآني سيكون قد غيب مصدرا مهما له علاقة مباشرة بالنفس البشرية من حيث تهذيبها وتقويمها، فتضخم النفس من خلال استكبار الأنا وأنانيته لا مجال لمواجهته إلا بنقيضه “فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ”[11] كما لو أن القرآن يقول لا دواء للكِبر إلا الصَّغار، ويمكن ملاحظة ذلك في واقع الناس، فكلما أهملت المتكبر وأذللته إلا وكسرت كبرياءه وألزمته موضعه.
إن طريقة التعامل مع إبليس عقابا وتجريدا له من مكانته الملائكية، جعلته ينهج نهج العناد وغواية الخلق، كما تبينه الآيات اللاحقة المتممة للحوار السابق: “قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ”[12]، ليخلص الحوار إلى مآل وخيم ينتظر إبليس وكذا من اتبعه، وفي ذلك تنفير ضمني للإنسان من اتباعه، ولعله علاج قرآني للمتلقي من خلال استعمال مثير نفسي لتجنب كل ما يلزم تجنبه، ويندرج ذلك فيما يعرف في علم النفس (المعالجات بالتنفير)، وهي “عبارة عن أساليب تستخدم شكلا من أشكال المثيرات المنفرة كوسيلة علاجية…يتم ربط أنماط سلوك محددة أو مثيرات معينة مع المثير المنفر”[13] .
وما دمنا نستنبط من النص القرآني أمورا قد تكون مرجعا لعلم النفس، فيمكن من خلال ذلك أن نجيب على سؤال لطالما طرح بأشكال مختلفة ومستويات متنوعة (هل المؤمنون يمرضون نفسيا كغيرهم؟)، أستطيع أن أجيب بأنه ما دمنا نصادف في القرآن ما يرتبط بذلك كما سبق ذكره، فيبقى المؤمن كباقي البشر يتعرض لما يتعرضون إليه، “إن الاضطراب النفسي شأنه شأن بقية الأمراض العضوية التي قد تصيب أيا من البشر، وإذا ما سلمنا بصحة تلك الهراءات فإن مرضى القلب والضغط والسكر. وغيرهم صاروا مرضى لضعف إيمانهم وتدني علاقتهم بخالقهم”[14]، إلا أن المؤمن يستمد من كتاب الله طاقة روحية هائلة، “حيث تأكد أن أحدث الدراسات أثبتت أن اللجوء الإيماني، وزيادة الوعي الديني، يخفظ من حدة الضغط النفسي الواقع على الأفراد، ولكنه لا يمنع من الإصابة بالاضطراب”[15]، فمجرد ولوج باب الله يعطي للمؤمنين متنفسا روحيا، يُنبت في دواخلهم الكثير من الأمل، ولعل عبارة واحدة من القرآن تتجسد في قوله تعالى: ” قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ”[16] كفيلة بأن تريح النفس البشرية أكثر من جرعات الدواء التي تملأ وصفات الأطباء النفسيين، وواقع الحال يؤكد ذلك، فكلما أصابت أحد من الناس مصيبة إلا ووجدته يكرر هاته الآية حتى وإن لم يكن يدرك مغزاها.
إن النص القرآني في مجمله نُصح وتوجيه للاإنسان، ومنه نتعلم أن البحث عن النصائح أمر إيجابي جدا، وتلك دعوة القرآن، بل إن الحوارات السابقة وغيرها من الحوارات في المتن القرآني تحمل بين ثناياها نصائح وإرشادات إلهية تنير الطريق وتعين على تجاوز ما يمكن أن يلم بنا من الصعاب، ما يمكن أن نربطه بما يعرف في الطب النفسي الحديث بـعلم النفس الإرشادي”La psychologie – conseil” وهي طريقة علاجية عملية أشار إليها الطبيب النفسي البلجيكيPierre Dac ويقول: “استشاري علم النفس (كما يشير المصطلح) هو أخصائي يقدم مساعدة عملية وفورية لمستشيره، إنه اتجاه حقيقي للضمير”[17].
لذلك أرى أن علم النفس الإسلامي يمكن أن يكون واعدا، فبالإضافة إلى ما يتيحه له علم النفس الحديث من نظريات ودراسات، فهو ينهل من مدرسة القرآن أيضا، ولا يخفى علينا أن القرآن روح، أي أنه أجدر باقتحام عمق الإنسان وملامسة وعيه الباطن خشوعا فتدبرا ففهما ثم استنباطا، فحينما يقول Pierre Daco: “يمكن لطبيب النفس الإرشادي أن يكون متدينا أو علمانيا. لكن المثالي هو أن يكون قد تم تدريبه بقوة على العلاج النفسي”[18]، فهو يشير بطريقة أخرى إلى إمكانية حضور الجانب الديني في مجال علم النفس، فما الجدوى من التفريط فيما هو روحي مع العلم أن الروح منطلق كل شيء ومصدر حياته، حتى إنه ما ثبت أن حضارة قامت دون دين، بغض النظر عن كونه صالحا أم فاسدا، المهم أن هناك شيئا روحيا يجمع الناس، ويخلق حالة الرضا في دواخلهم، ووصول هذا المقام –أي مقام الرضا- هو في حد ذاته غاية أشار إليها النص القرآني في ارتباط بالنفس، “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي “[19]، إن الرضا مقرون بهاته النفس، والحديث عن الاطمئنان والرضا حديث عن استقرار نفسي، وتلك إشارة رصينة تثبت أن هذا الأخير أمر منشود وضامن أساس في بناء شخصية قوية ومتوازنة، يتضح من ذلك أن الغاية والمهم هو عمق الإنسان، فما تقدّمه الجوارح أو تُقدِم عليه، ما هو إلا إشعاع انعكاسي لما تفجره النفس في الداخل، إذ من بين فروع علم النفس نجد فرعا يهتم بذلك، إنه علم نفس الأعماق “Psychologie des profondeurs”[20]، إذن فالأمر يحتاج إلى فهم الإنسان من الداخل وتشريح الروح البشرية، وهل هناك أعرف بالروح من رب الروح؟ فتفكيك المصنوع وإصلاحه لا يتقنه بدرجة أساس إلا صانعه، وفي ذلك إشارة إلى أنه عند التعامل مع الإنسان على الطبيب أو الدارس أن ينطلق من نفسه أولا لأن الخطأ وارد والشك قائم، وذلك ما يقر به Pierre Daco بنفسه: “المحلل هو جراح الروح، وقد تكون هذه المهنة، الوحيدة التي يجب على المرء أن يعمل فيها على نفسه قبل العمل على الآخرين”[21].
ومن الاضطرابات التي أصبحت اليوم محل اهتمام من المشتغلين بالصحة النفسية، نجد الوسواس، وهو لفظ ليس طارئا وإنما له أصل في القرآن في قوله تعالى: “وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا””[22]، فالوسواس فعل نفسي محض، يمكن أن نربطه بالنفس الأمارة بالسوء التي تدفع صاحبها لما يضره وهو “اسم الشيطان، قال تعالى:(من شر الوسواس الخناس)”[23]، إنه مصطلح له موقعه في علم النفس وفي الطب النفسي خصوصا كاضطراب صعب يُفقد صاحبه التوازن المطلوب في الحياة، أي إن عاقبته غير محمودة، وذات الشيء يؤكده التعبير القرآني، فقد وسوس لهما إبليس ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وهناك قول يرى بأن (اللام) المصاحِبة لفعل (يبدي) هنا تسمى لام العاقبة “( ليبدي لهما) أي ليظهر لهما، واللام لام العاقبة، كما قال: (ليكون لهم عدوا و حزنا)”[24]. ففهم المعاني والنظر إليها من زوايا متعددة يتيح سبل إدراك مآلاتها، وبين الفهم والإدراك تبرز أولى خطوات العلاج.
إن الغاية من العمل على خلق التوازن النفسي لدى الانسان جعله مسؤولا عن قراراته ومُقدِّرا لها، حيث إن القرآن يريدنا مسؤولين لا متهاونين، “وإنكار المسؤولية هو نوع آخر من التواصل المعرقل للحياة، والتواصل المعرقل للحياة يعتم إدراكنا لأننا جميعا مسؤولون عن أفكارنا ومشاعرنا وتصرفاتنا”[25]، إنها مصاحِبة للإنسان طوال عمره، ومع استمراريتها يستمر القرآن مؤطرا وموجها، فكل التعاليم التي تخص حياة الإنسان، هي مسؤولية ملقاة على العاتق وجب الانضباط لقواعدها، وإلا سيعتبر ذلك تفريطا فيها وإنكارا لها، والمسؤولية بطبيعة الحال ليست أمرا محسوسا بقدر ما هي شعور نفسي، “فنحن ننكر مسؤوليتنا عن أفعالنا عندما نعزي سبب هذه الأفعال إلى: قوى مبهمة مجردة … ضغط الجماعة…رغبات لا يمكن السيطرة عليها”[26]، وذلك ما نجده في حوار بديع في سورة إبراهيم، حيث يقول ربنا عز و جل: “وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ “[27]. إن التنصل من المسؤولية واضح وبين، ناهيك عن ضعف الشخصية الذي يبرزه الاتباع دون وعي، فكما لو أن القرآن يخاطب الإنسان: أن كن سيد قرارك وصاحبه، وحتى في المشترك من الأمور كن شريكا لا تابعا خنوعا، ولذلك امتداد في السنة “من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا تكونوا إمعة، تقولون : إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، و لكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساؤوا فلا تظلموا”[28]، وهذا ما لم تغفله الأشكال العلاجية النفسية الديناميكية من خلال ما يسمى “بالتحليل الوجودي” حيث إن هدف هذا العلاج “يتمثل في جعل المريض يدرك إمكانات قراراته ونضجه، ويتم إيلاء أهمية كبيرة للعلاقة العلاجية أكثر من المقابلة الرسمية التي تتم بين شخصين، حيث يعتبر المريض هنا شريكا “[29].
إن الاهتمام بالجانب النفسي للإنسان أولوية لا محيد عنها، حتى إن المشتغلين بعلم النفس وبأهم جوانبه (الطب النفسي)، تتمحور أغلب دراساتهم حول النجاح في بناء الشخصية المتوازنة للإنسان، وأظن أن ذلك ما فطن له Pierre Daco لما أورد في عنوان كتابه السابق الذكر: (Les triomphes de la psycanalyse)عبارة تترجم كل ما قيل: (من العلاج النفسي إلى توازن الشخصية) (Du traitement psychologique à l’équilibre de la personnalité)، فبناء الإنسان المتوازن نفسيا والسوي أخلاقيا هو المبتغى والقصد، وإلا فماذا سيبقى إذا انهار الإنسان من الداخل؟ وكيف سيتأتى له المسير بعد ذلك؟ لذلك كان اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة منصبا على بناء الإنسان أوَّلا، كإشارة إلى أن ما بعده أسهل، وعلى ذات الوزان نزلت السور المكية محيطة ومهتمة بالجانب العقدي الذي يخص بناء الروح بعد تطهيرها من الشوائب وتهذيبها. وكلها سبل تسهم في بناء شخصية الإنسان، وأتحدث هنا عن الإنسان الجاد ذاك الإنسان المنتج والمنجِز، وليس “الإنسان المهدور”[30]، إنسان مستلب منهار، “الهدر يضرب مشروع وجود المرء كي يصبح كيانا ذا قيمة وقائما بذاته وذا دلالة ومعنى واعتبار وامتلاء وانطلاق، مما يمكن أن يلخص في بناء هوية نجاح هذا الوجود. الهدر على هذا المستوى هو نقيض بناء التمكين والاقتدار وصناعة المصير”[31]، ولا شك أن الاقتدار يؤسس للثقة بالنفس والاعتماد على الذات والصبر والتفكير الإيجابي الخلاق، مما ينتج في النهاية إنسانا متوازنا يعرف حجمه جيدا، مما يجعل الآخر يقدره قدره. ولنا في يوسف عليه السلام مثال ذلك كله من خلال حوار يؤطره قوله تعالى: “وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِين،قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ”[32]، تلك صورة راقية للثقة بالنفس وتقدير الذات، فطلب المسؤولية لا ينم إلا عن إلمام كبير بها، وامتلاك للكفاءة المؤهلة لحسن الإنجاز.
إن الخطاب القرآني كما يحضنا على العناية بصحة الجسد باعتباره أمانة، فإنه بمنطق الموازنة يؤكد على الصحة النفسية كذلك، فهاته الأخيرة إذا ما تحققت كانت نعم المشتل للنضج والوعي والرصانة، “فالصحة النفسية لفظ مرادف لمفهوم السواء، وهو يعني النضج والتوافق الاجتماعي والنفسي، ويتطلب مهارات في مجال تكوين علاقات شخصية واجتماعية فعالة وإيجابية مقبولة من الفرد ومن الآخرين، كما يعني توافقا في المهنة، أي فاعلية في أداء الدور الذي يحقق رضا عن الذات وتقديرا لها، كما يعني توافقا مع الذات، بمعنى استبصار الفرد بذاته وقدراته وتوظيفها في إطار إيجابي”[33].
بالإضافة إلى ما سبق، فمن أعقد المعضلات التي تدمر الصحة النفسية، والتي تطرق لها القرآن، معضلة وردت في علم النفس تحت مسمى (العقد النفسية) والتي تخلف اضطرابات تكون لها مآلات سلبية على توازن الشخصية الإنسانية، “والعقد النفسية ما هي إلا طغيان الأهواء والمخاوف النفسية على العقل وسيطرتها عليه، ولذلك عرف البعض العقدة النفسية على أنها (جملة من التصورات أو الانفعالات المكبوتة الناشئة عن حالات صراعية ذات شحنة وجدانية كبيرة، وهي تؤثر في تفكير الشخص وتطبع سلوكه بطابع الانحراف والشذوذ)”[34]، ومن أوضح الأمثلة الصادمة على ذلك ما تعرض له القرآن من حوار صريح بين لوط عليه السلام و قومه باستعمال مفردات دالة على ما نحن بصدده، “وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ”[35]. (إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء) عبارة صادمة يتلقاها المتلقي بعقله، لكن تقع في نفسه موقع النفور والاشمئزاز، إنه أمر طارئ في التاريخ، لم يسبق له أحد من الناس، فبالنسبة لي ذلك فيصل بين الإنسان واللاإنسان، لقد تردى هؤلاء القوم من موقع الآدمية إلى موقع البهَمية، وعلى ذات الشاكلة كل من ذهب مذهبهم. أضف إلى ذلك لغة التعنت والسخرية التي اعتمدوها (أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون)، ففعل (يتطهرون) يحمل معنى الاستهزاء، كما أنه إقرار ضمني بأن ما يفعلونه مناف للطهر، ذلك صراع بين العقل والنفس، عقل يعي فداحة الفعل ونفس تأبى إلا الالتزام بهذا الفعل.
إن ما عانى منه الرسل والأنبياء لا شك أن له تأثيرا نفسيا عليهم، ما أوجب التطمين ورفع القلق وتهوين الضغوط، فذلك نوح عليه السلام بعد محاورته لقومه جاء التطمين الإلهي مباشرة بعد بسط الحوار الذي جرى بينهما، إذ قال تعالى: “وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ”[36].وفي موضع آخر في نهاية الحوار بين نوح وربه، قال تعالى: “فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ”[37]. لقد تضمنت النصوص القرآنية عبارات التسلية وتخفيف الآلام على الرسل والأنبياء ومن تبع هديهم، وهي رسائل إلى الإنسان عموما، أن اطمئن فمهما علا سقف المشاكل والضغوط فّإن لها حلا، فكلما تعرض القرآن لحوار نبي مع قومه إلا وتم تضمين هذا الحوار وتذييله بما يفيد ذلك، ونحن نقرأ القرآن علينا أن نستوعب هذا الأمر ونتربى عليه، لنكون إيجابيين في الفعل وفي ردة والفعل وحتى في التوقع.
ومن نظر وجهة علم النفس عموما والطب النفسي خصوصا، فإن من أهم الأهداف المرجوة انتشال الفرد من براثين الروع والقلق والنصَب النفسي، إلى مستوى الاطمئنان والراحة النفسية حتى تتأتى له الانطلاقة من جديد، ويمكن ترجمة رسائل الاطمئنان في عبارة قرآنية قوية “لَا تَحزَن إِنَّ الله مَعَنا”[38]، فقراءتها بتدبر وإيمان صادق كفيل بالارتقاء بالنفس إلى مقام الرضا والصبر وفتح أبواب الأمل، وهي أمور يبقى انعدامها من أهم مسببات ولوج عيادات الطب النفسي. فمحمد صلى الله عليه وسلم وهو مطارد من خصومه، مختبئ في غار ثور، وقد حفت هواجس الخوف بصاحبه أبي بكر، لَيُترجم ذلك المشهد حوارا، أستطيع أن أقول إنه حوار بين الخوف و الأمل:”إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ”[39].
هذه الحوارات القرآنية التي تمت الإشارة إليها وغيرها، تحمل روح الأمل وبسط الطمأنينة في النفوس، إنها بذلك تكسبنا ما يعرف في علم النفس بالمناعة النفسية، وهي ” قدرة الإنسان على مواجهة الأزمات والكروب، وتحمُّل الصعوبات والمصائب، ومقاومة ما ينتج عنها من أفكار ومشاعر الغضب والسخط والعداوة والانتقام، أو مشاعر اليأس والعجز والانعزالية والتشاؤم. وأبحاث علم النفس تُشَبه المناعة النفسية بالمناعة الجسدية، فكما أن المناعة في الجسم تنشطه وتقويه وتجعل أكثر قدرة على مقاومة الأمراض واحتمال آلامها، فكذلك المناعة النفسية تحصن النفس بقدرات تجعلها قادرة على رفض السوء وتقبل الخير”[40].
وبالنظر إلى تنوع أطراف الحوار في النص القرآني، فإنه يبقى من المثير للاهتمام ذلك المشهد الحواري الذي كان (طائر الهدهد) أحد طرفيه. وتلك إشارة قرآنية للإنسان كي يهتم بالحيوان في جانبه السيكولوجي، فأن يتجرأ الطائر على التصريح بإحاطته علما بما يجهله نبي، هو ومضة قرآنية على شاكلة العصف الذهني، تجعل المتلقي يتخلى عن النظرة البسيطة والعامية للحيوانات عموما، “وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ”[41]، و”قد اهتم علماء النفس بدراسة سيكولوجية الحيوان، على اعتبار أن هاته الدراسة ستساعدهم كثيرا على فهم سيكولوجية الإنسان، الذي يخضع لكثير من التغيرات التي تعقد سلوكه، فللإنسان طموحاته وأفكاره الكثيرة المختلفة، وتصوراته الخاصة للتجربة التي تجرى عليه، ونظرته الشخصية للمجرب وبخاصة إذا كان من الجنس الآخر، ورغبة المفحوص أحيانا في مظهر جيد ليرضي المجرب، وتقلب حالاته النفسية المزاجية، وغير ذلك من التغيرات الكثيرة التي يصعب ضبطها أثناء التجربة، ولذلك يرى علماء النفس أن إجراء التجارب على الحيوان تجنبهم كثيرا من التعقيدات التي تحدث نتيجة لهذه المتغيرات الكثيرة التي لا يمكن ضبطها أثناء دراسة الإنسان”[42].
إن نظرة القرآن للنفس الإنسانية نظرة شمولية تقارب بين الاضطرابات وطرق التعامل معها بحثا عن العلاج، فالغاية بناء الإنسان على موازين تضمن له الاستقامة والاتزان، ورغم الطفرة العلمية التي عرفها العالم، إلا أن مجال علم النفس كما هو الشأن بالنسبة لباقي العلوم، سيظل في حاجة لتلقي رسائل القرآن والاستفادة منها، فالبحث العلمي يقتضي تعدد المناهل وسعة الأفق، خصوصا وأن المعرفة لا حدود لها، وليس هناك مجال يحتكرها بمفرده.
المصادر والمراجع:
– القرآن الكريم برواية ورش.
– أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ط:2.
– أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي (الجامع الكبير)، المجلد الثالث، ط:1- 1996، دار الغرب الإسلامي.
– الدكتور عادل صادق، الطب النفسي، الصحوة للنشر، ط 2، 2015م.
– د. أحمد هارون، اكتشف آلامك النفسية وتخلص منها، مؤسسة بداية للنشر والتوزيع، ط:1، 1439هـ/ 2017م.
– د. مارشال بي روزنبرج، التواصل غير العنيف لغة حياة، مكتبة جرير، ط 1، 2008.
– د. محمد عثمان نجاتي، مدخل إلى علم النفس الإسلامي دار الشروق، الطبعة الأولى، 2001م. – د. مصطفى حجازي، الإنسان المهدور(دراسة تحليلية نفسية اجتماعية)، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب، ط1، 2005. – د.بشرى كاظم الشمري، موضوعات في علم النفس، كنوز للنشر والتوزيع، ط: 1، 2014م.
– سميح عاطف الزين، علم النفس معرفة النفس الإنسانية في القرآن والسنة، دار الكتاب اللبناني، 1991م/1411هـ.
– كلاوس غراوه/ روث دوناتي/ فريديريكهبيرناور، مستقبل العلاج النفسي/ معالم علاج نفسي عام، ترجمة: سمير جميل رضوان، منشورات وزارة الثقافة/ سوريا، 1999. – مجموعة من المؤلفين وأشرف عليه الدكتور فرج عبد القادر طه، معجم علم النفس والتحليل النفسي، دار النهضة العربية، ط1.
مرجع أجنبي:
-PirreDaco، Les triomphes de la psychanalyse، nouvelle éditions Marabout, 2013.
[1]- سورة البقرة، الآيات من 30 إلى 33.
[2]-د.بشرى كاظم الشمري، موضوعات في علم النفس، ط الأولى 2014، كنوز للنشر والتوزيع، ص17
[3]-الدكتور عادل صادق، الطب النفسي، ط 2، 2015م، الصحوة للنشر، ص 27
[4]- د. مارشال بي روزنبرج، التواصل غير العنيف لغة حياة، مكتبة جرير، ط 1، 2008، ص22.
[8]- سورة الأعراف، من الآية 11 إلى 13.
9-كلاوس غراوه/ روث دوناتي/ فريديريكهبيرناور، مستقبل العلاج النفسي/ معالم علاج نفسي عام، ترجمة: سمير جميل رضوان، منشورات وزارة الثقافة/ سوريا، 1999م، ص: 171
[12]- سورة الأعراف، الآيات من 16 إلى 18
13-كلاوس غراوه/ روث دوناتي/ فريديريكهبيرناور، مستقبل العلاج النفسي/ معالم علاج نفسي عام، مصدر سابق، ص:184.
[14]- د. أحمد هارون، اكتشف آلامك النفسية وتخلص منها، مؤسسة بداية للنشر والتوزيع، ط:1، 1439هـ/ 2017م، ص:20.
[17]-PirreDaco، Les triomphes de la psychanalyse، nouvelle éditions Marabout, 2013، page 31
[18] -Les triomphes de la psychanalyse, page 31
– سورة الفجر، من الآية 27 إلى الآية 30.[19]
[20]-Le terme n’a nullement besoin d’être défini.Le psychologue des profondeurs se consacre à l’humain dans ce qu’il a vaste et profond. C’est un humaniste, qu’un spéléologue et un chirurgien de l’âme humaine/ Pierre Daco, Les triomphes de la psychanalyse.p : 33.
[21]-Les triomphes de la psychanalyse، p: 3.9
[22]-سورة الأعراف، الآيات من 19 و20.
[23]- أبو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المجلد السابع، مصدر سابق، ص 178
[25]- د. مارشال بي روزنبرج، التواصل غير العنيف لغة حياة، مصدر سابق، ص 19.
[26]- د. مارشال بي روزنبرج، التواصل غير العنيف لغة حياة، مصدر سابق، ص 20.
[27]- سورة إبراهيم، الآيتان: 21 و22.
[28]- أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي (الجامع الكبير)، المجلد الثالث، ط:1- 1996، دار الغرب الإسلامي، ص 538.
40-كلاوس غراوه/ روث دوناتي/ فريديريكهبيرناور، مستقبل العلاج النفسي/ معالم علاج نفسي عام، ص: 172.
[30]- د. مصطفى حجازي، الإنسان المهدور(دراسة تحليلية نفسية اجتماعية)، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب، ط1، 2005.
[32]- سورة يوسف، الآيات 54 و55.
[33]- مجموعة من المؤلفين وأشرف عليه الدكتور فرج عبد القادر طه، معجم علم النفس والتحليل النفسي، ط1، دار النهضة العربية، ص245
34-سميح عاطف الزين، علم النفس معرفة النفس الإنسانية في القرآن والسنة، دار الكتاب اللبناني، 1991م/1411هـ، المجلد الثاني، ص: 150 و151.
.[35]- سورة الأعراف، الآيات، من: 80 إلى: 82
[40]- سميح عاطف الزين، علم النفس معرفة النفس الإنسانية في القرآن والسنة، ج:2، دار الكتاب اللبناني، 1991م/1411هـ،ص211.
[41]- سورة النمل، الآيات: من: 20 إلى: 22.
[42]- دكتور محمد عثمان نجاتي، مدخل إلى علم النفس الإسلامي دار الشروق، الطبعة الأولى، 2001م، ص: 70.