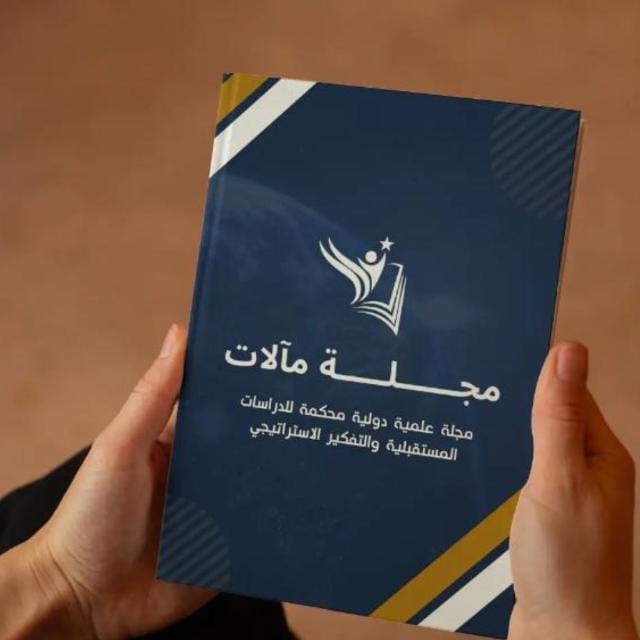محمد ياسين لعبيد جامعة سيدي محمد بن عبد الله ــ فاس
ملخص البحث:
تأتي هذه الورقة البحثية محاولة لترجيح القول في مسألة “حق الزوجة في الثروة المكتسبة مدة العلاقة الزوجية”التي لطالما أسالت الكثير من المداد، وشغلت الباحثينمن الفقهاء والحقوقيين؛ ابتداء من بيان فتوى ابن عرضون وموقف الفقهاء منها، ثم مناقشة الفتوى وموقف المؤيدين والمعارضين لها، وانتهاء بترجيح القول فيها مع مناقشة إمكانية العمل بها على ضوء التحولات الاجتماعية المعاصرة، وفق أصول المذهب المالكي وقواعده؛ بما يحقق مقاصد الشرع في حماية مصلحة المرأة خاصة، ومصلحة الأسرة عامة.
* الكلمات المفاتيح: الحق – الزوجة – الثروة المكتسبة – العلاقة الزوجية – الاجتهادالفقهي النوازل الفقهية –فتوى – ابن عرضون – تغيرات العصر – التحولات الاجتماعية المعاصرة.
The wife’s right to earned wealth during the marital relationship in light of Ibn Ardoun’s fatwa and the changes of era
Mohamed yassine LAABID
University Sidi Mohamed Ben ABDALLAH – FES Morocco
Abstract:
This paper aims to prevail and examinate the polemic question of”The wife’s right to earned wealth during the marital relationship” among Fuqaha and human rights defender. I started by introducing the fatwa of Ibn Ardoun before discussing Fukaha attitudes about his claim. I finished by reconsidering this Fatwa and its value based not only on contemporary social transformations, but also on fundamental rules of Maliki doctrine in order toachieeve the purposes of the Sharia when it regards to protect women rights and her family as well.
Key-words: Right – Wife- Earned Wealth – Marital Relationship – Legal Jurisprudence – Legal Casuistics- Fatwa – Ibn Ardoun- Changes era- Contemporary Social Transformations.
* مقدمة:
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم ومشى.
وبعد؛ تعتبر الأسرة نواة المجتمع وأساس استقراره وصلاحه، لذلك أولاها الإسلام عناية خاصة ببيان حقوق وواجبات كل أطرافها، حفاظا على تماسكهاواستقرارهاوتحقيق مقاصدهاووظائفها؛كما اهتم الفقهاء ببيان أحكامها وما يتعلق بها،ومنهم فقهاء المالكية الذين لهم اجتهادات متميزة في مجال الأسرة، ساهمت في مواكبة تطور أحوال المجتمع، ومراعاة تغير الظروف والأحوال.
ومن المواضيع التي حظيت باهتمام الفقهاء قديما وحديثا – رغم قلة من أفرده بالتأليف- موضوع حق الزوجة في الثروة المكتسبة مدة العلاقة الزوجية؛ وهو حقٌّ يُضْمَنُ للزوجة إذا انتهتِ العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها إما بالطلاق أو الوفاة، وذلك بأن يتم تحديد وحساب مجموع الثروة التي تم تكوينها خلال فترة الحياة الزوجية، فتحصل على جزء منها مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية إلى جانب زوجها.
* الإطار العام للموضوع:
إن فكرة ضمان حق المرأة في مال زوجها المكتسب مدة العلاقة الزوجية تجد أساسها في مبادئ الشريعة وقواعدها، كما تجد أساسها في تراثنا الفقهي المغربي، وفي العديد من النوازل والفتاوى التي أكدت على منح الزوجة هذا الحق عند الطلاق أو الوفاة[1]؛ بناء على تسميته بحق “الكد والسعاية“، أو “حق الشقا“، أو “حق الجرية أو الجراية“، أو “حريق اليد“، أو “تمازولت“؛ لذلك فإن الباحث في هذا الموضوع لا يكاد يظفر بمطلوبه أو يحصل على مرغوبه إلا في كتب الفقهاء والنوازليين المغاربة، وخاصة كتب الغماريينوالسوسيين، والتي اهتمت بمسألة “الكد والسعاية” اهتماما بالغا وكبيرا لا تكاد تجده عند غيرهم من الفقهاء، فعقدوا لها فصولا خاصة أخذت حيزا كبيرا من مؤلفاتهم.
ومما تنبغي الإشارة إليه هو أن مطلبَ “حق الزوجة في الثروة المكتسبة مدة العلاقة الزوجية“، يبقى من أهم المطالب التي نادت بها بعض الحركات النسوية والهيئات الحقوقية، إنصافا للمرأة وانتصارا لها ورفعا للظلم عنها، وحرصت على تضمينه وإقراره في مدونة الأسرة؛ ولا يزال هذا المطلب مستمرا للتنصيص عليه صراحة وبشكل واضح ودقيق، خاصة مع عدم وضوح موقف الفقه والقضاء منه، وللتباين الحاصل في فهم مقصود المشرع المغربي من المادة 49 من مدونة الأسرة والتي جاء فيها: ” يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها“.
* إشكالية موضوع البحث وأهدافه:
إنَّ حق المرأة في المال المكتسب مدة العلاقة الزوجية والذي درج فقهاؤنا على تسميته ب “حق الكد والسعاية“،يبقى من أكثر القضايا إثارة للنقاش والجدل قديما وحديثا؛ بناء على فتوىابن عرضونالتي اعتبرت إنصافا للمرأة ورفعا للظلم عنها، وذلك بين من اعتبرها فتوى خاصة بمنطقة وظروف معينة لا يقاس عليها، وبين من توسع فيها وقاس عليها كل عمل تشارك به المرأة في تنمية مال زوجها،سواء كان عملها داخل البيت أو خارجه، فأوجب لها حقا فيه.
وعليه أتساءل عن مضمون فتوى ابن عرضون؟ وعن مستندها في إقرار حق الزوجة في المال المكتسب مدة العلاقة الزوجية؟ وما موقف العلماء منها قديما وحديثا؟ وهل يمكن التوسع في العمل بها بشكل عام دون تخصيصها بمناطق خاصة وظروف معينة، مراعاة لتحولات المجتمع وتغيرات العصر؟
هذه الإشكالية والأسئلة المتعلقة بها هي ما تتطلع هذه الورقة البحثيةإلى دراستها،عن طريق بيان مضمون فتوى ابن عرضون، وإبراز اجتهاد فقهاء المالكية فيها قديما وحديثا، ومناقشتها وتقديم اقتراحات بشأنها، بناء على التحولات الاجتماعية والتطور الحقوقي في المغرب المعاصر؛ وذلك من خلال مبحثين اثنين:
المبحث الأول: مضمون فتوى ابن عرضون ومواقف الفقهاء منها
المبحث الثاني: مناقشة هذه الفتوى بناء على متغيرات العصر
المبحث الأول: مضمون فتوى ابن عرضون ومواقف الفقهاء منها
المطلب الأول: مضمون فتوى ابن عرضون ومستندها
يعود أصل هذا الإشكال الفقهي إلى الفتوى المشهورة الصادرة عن الفقيه المغربي العلامة ابن عرضون الغماري الجبلي[2]،والتي تقضي بحق المرأة في الكد والسعاية والشقا[3]؛ بحيث إن النساء في البادية وتحديدا في منطقة اجبالة بشمال المغرب، كن يشاركن أزواجهن في الحرث والحصاد وتربية المواشي…، فأفتى ابن عرضون بحقهن في الشقا في هذا المال المكتسب مدة الزوجية، تحقيقا للعدل ورفعا للظلم؛ وهذا نص فتوى ابن عرضون في الموضوع كما أوردها العلمي في كتابه النوازل: «سئل أبو عبد الله سـيـدي مـحـمـد بن الحسن بـن عـرضـون عمن تخدم من نساء البوادي خدمة الرجال، من الحصاد والدراس وغير ذلك، فهل لهن حق في الزرع بعد وفاة الزوج لأجل خدمتهن، أوليس لهن إلا الميراث؟ فأجابه بما أجاب به الشيخ القوري[4] مفتي الحضرة الفاسية، وشيخ الإمام ابن غازي، قال: “إن الزرع يقسم على رؤوس من نتج عن خدمتهم، زاد عليه مفتي البلاد الغمارية جدنا سيدي أبو القاسم بن خجو[5]: على قدر خدمتهم، وبحسبها من اتفاقهم أو تفاوتهم، وزدت أنا ــ لله عبد ــ: بعد مراعاة الأرض والبقر والآلة، فإن كانوا متساوين فيها أيضا فلا كلام، وإن كانت لواحد حسب له ذلك، والله تعالى أعلم“[6].
فهذه الفتوى لم يَسبق إليها ابن عرضون – وإن أضاف إليها إضافات -، فقد أفتى بها قبله الشيخ القوري وأبو القاسم خجوو غيرهما من الفقهاء المتقدمين[7]؛ كما عرفت هذه المسألة في العمل السوسي بحق الكد والسعاية[8]، “حيث نجد الفقهاء السوسيين أعطوا لهـذه المسألة أهمية خاصة، ورأوا أن عمل المرأة ومشاركتها في الإنتـاج في سـوس لا يوازيه عملها في المدينة، وإن كان بعض النساء في المدن يعملن كذلك في الخياطة والنسيج والطرز وغيرها ولكن ذلك نادر، أما في سوس فكلهن يعملن وينتجن ويكدحن إلا من كانت غير قادرة لمرض أو عجـز؛ لـذلك رأى الفقهـاء أن حرمانهن من نصيبهن من هذا الإنتاج إذا وقع طلاق أو وفاة ظلم لهن، و لم يقـع خلاف بين فقهاء سوس في شأن إعطاء المرأة نصيبها من قيمة عملها“[9].
وإن المتأمل في فتوى ابن عرضون يلاحظ بأنها لم تكن قطعا مبنية على الهوى أو الإشفاق الزائد على المرأة الجبلية، وإنما هي مبنية على أسس وقواعد شرعية من أهمها: اعتماده عما نقله عن سلفه من العلماء، وهما الشيخ القوري مفتي الحضرة الإدريسية، ثم جدُّه أبو القاسم بن خجو مفتي البلاد الغمارية، كما جاء في نص الفتوى السابق؛ كما اعتمد على مراعاة مبادئ الإسلام السمحة المتمثلة في العدل والقسط، وتجنب الظلم، والتي ترجع في حقيقة الأمر إلى أصل المصالح المرسلة في المذهب ثم مراعاة العرف؛ فقد وجد ابن عرضون بالبادية الجبلية عرفا يقضي بإعطاء المرأة حظا من الممتلكات المتراكمة خلال فترة الحياة الزوجية، والعرف الحسن من أصول المالكية، لذلك ما كان لابن عرضون أن يتجاهله؛ وكذا جريان العمل بذلك، والعمل بما جرى به العمل معتبر عند المالكية أيضا.
المطلب الثاني: موقف الفقهاء قديما وحديثا من فتوى ابن عرضون
الفقرة الأولى: موقف علماء فاس من هذه الفتوى
لقد كان لعلماء فاس آنذاك موقف مخالف لما أفتى به ابن عرضون نساء بادية جبالة؛ حيث جرى العرف والعمل عندهم بخلاف ذلك؛ فأفتوا بعدم جواز قسمة المال المكتسب خلال مدة الزوجية، وقد نظم هذه الفتوى الفقيه عبد الرحمان الفاسي[10]في نظمه لما جرى به العمل، فقال[11]:
وخدمة النساء في البـــوادي للزرع بـالـدراس والحصـــــاد
قال ابن عرضون لهن قسمة على التساوي بحساب الخدمة
لكن أهل فاس فيها خالفــــوا قالوا لهم في ذاك عرف يعرف
والعرف المشار إليه في نظم صاحب العمل الفاسي هو أن المرأة لا تتشاح مع زوجها فيما تقوم به من خدمة في مال زوجها، ولا تطالبه بشيء مقابل عملها له، لأن عملها مع زوجها باختيار منها يعتبر بمثابة خدمة لازمة لها بمقتضى العرف، كما تقوم بشؤون الأسرة من تحضير الأكل ونظافة البيت.
وبالرجوع إلى فتوى[12]الشيخ عبد القادر الفاسي[13]يلاحظ أنه نقض فتوى ابن عرضون بالاستناد إلى ما يأتي:
ــ أنها مخالفة لما قسمه الله وفرضه في قسمة الأموال والممتلكات، فلم يبق نظر ولا اختيار.
ــ أنه لا مستند شرعي لهذه الفتوى إلا العرف والعادة وهما فاسدان في هذا المقام؛ لكونهما يصادمان قواعد الشرع، ويتبعان أهواء الناس.
ــ أن القول بأن الأحكام تجري مع العرف كما قال القرافي وغيره ــ ادعاء في غير محله، لأن ذاك يتعلق بمقاصد الناس ونياتهم وجري ألفاظهم في أيمانهم وأحـبـاسـهـم عـلى عـرفـهـم ونحو ذلك، وليس فيما يناقض أحكام الشرع ومقاصده.
ــ أن ما جرى به العمل لا يصح الأخذ به إلا إذا كان موافقا للشرع، ولا يتصادم مع الحق، وكان صادرا ممن يعتد به من العلماء الأعلام كعلماء قرطبة كما قال.
ــ أن من فساد الفتوى الاستناد فيها إلى أغراض الناس واتباع أهوائهم ومألوفاتهم من غير دليل شرعي، فإنه حل لعرى الشريعة ومناقضة لحكمها، بينما الشريعة جاءت لتخرج الناس عن داعية أهوائهم ليكونوا عبادا لله كما قال الشاطبي.
كما يشهد لما جرى به العمل بفاس في هذه النازلة أيضا مسألة سكنى الرجـــل دار زوجته، دون أن يتفق معها في البداية على أداء سومة كراء المنزل، فالمشهور لا شيء عليه، ولا يقدم لها أي مقابل، إن طالبته به بعد ذلك، كما قال الشيخ خليل: “وإن تزوج ذات بيت وإن بكرا فلا كراء إلا أن تبين“[14]؛ أي إلا أن تقدم الزوجة بينة ودليلا على أنه اكترى المنزل منها، ولم يكن ذلك مكارمة وتفضلا منها، فكما أن فقهاء فاس أسقطوا عن الزوج واجب كراء المسكن بمقتضى العادة وما جرى به العمل عندهم، وهو أن المرأة لا تقصد في إسكان زوجها معها الكراء، وإنما الرفق بزوجها ومكارمته، فكذلك تسقط عنه إجارة خدمتـها في ماله ومشاركتها في تنميته بالعادة والعرف من باب أولى؛ لأن العرف كالشرط، والمسلمون عند شروطهم مالم تكن مخالفة لقواعد الشرع.
هذا موقف علماء فاس من فتوى ابن عرضون، فماذا عن موقف المعاصرين من هذه النازلة؟
الفقرة الثانية: موقف المعاصرين من فتوى ابن عرضون
لقد كان لهذه الفتوى صدى قويا وأثراعلى الاجتهاد الفقهي في بعض قضايا الأسرة، ليس في المغرب فقط، بل حتى خارج المغرب أيضا؛ وبناء عليهاانقسم العلماء المعاصرون والباحثون في قضايا الأسرة في الإسلام إلى فريقين أيضا:فريق مؤيد للفتوى (أولا)، وفريق معارض لها (ثانيا).
أولا: المؤيدون لفتوى ابن عرضون
ويمثل هؤلاء من علماء فاس تحديدا الشيخ المهدي الوزاني الذي دافع عن هذه الفتوى وأيدها، وحاول أن يستدل لها بقواعد شرعية تعضدها وتقويهافي كتابه:” النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى“، المسمى ب: “المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب“؛ حيث بين فتوى ابن عرضون، وموقف علماء فاس منها آنذاك، ثم أورد نص الشيخ عبد القادر الفاسي في نقدها، ورد عليه وناقشه بأدب العلماء مطولا في النص الآتي:” قلت: كأنه رضي الله عنه فهم أن الزرع المتخلف عن الهالك يقسم بأجمعه على كل من كان يباشر خدمته من غير أن يترك للهالك شيء منه، وليس كذلك، بل معناه أن الذين يخدمون الزرع يأخذون جزءا منه على قدر خدمتهم، وما بقي يكون موروثا عن الهالك لورثته نظير إخراج الزكاة منه أولا إذا مات بعد طيبه، ثم يقسم ما بقي بعد إخراجها على ورثته، وبهذا لا يكون مخالفا للقسمة التي فرضها الله ورسوله، لأن هؤلاء الذين نتج الزرع عن خدمتهم تعلق حقهم بعينه، فيقدمون أولا، ثم ما فضل عنهم يدفع لورثته يقسمونه على فرائض الله نظير الحقوق المتعلقة بعين التركة التي يبدأ بها أولا، ثم يقسم على الورثة ما بقي ثانيا .والحاصل أنه كما ثبتت الشركة في الزرع للخماس بمجرد خدمته كذلك ثبتت لغيره ممن له مباشرة الزرع بجزء على قدر عمله، والله أعلم؛ وبه يبـطـل قـولـه أيـضـا: (وخـلافـه تحـريـف وحـيـد عـن الـشـريـعـة الخ)، وهذا منه رضي الله عنه مبالغة، وإلا فمعاذ الله أن يتفق علماء الجبال على التحريف، سيما أمثال أولئك الأئمة الذين يستسقى بهم الغمام، وقوله: (ولا عبرة بمجرى العادة والعرف مع فـسـاد العـقـد الخ)، قد علمت أنه ليس هنا صريح عـقـد وإنما هنا شركة حكمية بمقتضى العادة كما قالوا ـــ فيمن كان مع أبيه أو أخيه أو عمه على حالة واحدة ومائدة متحدة ـــ أن ذلك يوجب لهم شركة المفاوضة. وقوله: (إذ ذاك إنما هو في مـقـصـودهـم ونياتهم الخ) قد نصوا على أن العرف على قسمين؛ تارة يرجح به القول ولو ضعيفا إذا كان موافقا له كما في قول الزقاقية على العرف عولا، وتارة ينبني عليه الحكم كالاختلاف في متاع البيت إذا شـهـد العرف أنه لأحد الزوجين، وقال في نظم عـمـل فـاس ناظمه ما نصه: عمل فاس يتبع الأعراف.. الخ، فلا وجه لـقـصـره على مـقـصـودهـم ونياتهم الخ، بل يحكم به ولو خالف مقصودهم، تأمله. وقوله: (فإذا كان القول صحيحا وصحبه العمل الخ) قد علمت أن المقلد لا يعرف القول الصحيح من غـيـره لـقـصـوره، فلا معنى لاشتراط هذا الشرط في حقه، نعم، العرف يدركه المقلد قطعا، فإذا وافق قولا من أقوال الأئمة المعتبرين فإنه يرجحه به. وقوله: (كعلماء قرطبة وأمثالهم الخ) نقول: إن الذين أفـتـوا بـهـذا القول وذكروا أن العمل به كالقوري وابن عرضـون وابن خجو وسيدي أحمد البعل وأضرابهم، كلهم أهل للتـرجـيـح كـأهل قرطبة، فلا وجه لتخصيص الاقتداء بأهل قرطبة، إذ لا دليل شرعي على هذا التخصيص، فالحق أن هذا العمل ثابت لا ينكر؛ نعم، يقصر على أهل الجبالكما قالوا: إن العمل الثابت بموضع لا يلزم جريانه في غيره، والله أعلم“[15].
بل صرح بالاعتراض على من أهملها ولم يأخذ بها، بقوله:” وأمـا خدمة النساء في البوادي فالعمل جار بمشاركتهن ولا التفات في اعتراضـه، وقد رددنا ذلك الاعتراض بما يشفي ويكفي في النوازل الجديدة، وقد قال لي من أدركت من قضاة بني مسارة؛ إن العمل بما قاله ابن عرضون لا زال مقررا عندهم إلى الآن“[16].
وممن أيد هذا الرأي من المعاصرين أيضا الدكتور عمرالجيدي في كتابه: ” ابن عرضون الكبير: حياته وآثاره ـ آراؤه وفقهه“، فبعد عرضه لفتوى ابن عرضون وبيان مستندها الفقهي، أورد قصة مفادها أن بعض علماء فاس تراجعوا عن موقفهم المعارض لهذه الفتوى آنذاك، بعد ما زار وفد منهم الفقيه ابن عرضون في منطقته، واطلع على ما تقوم به المرأة من عمل شاق لتنمية مال زوجها، وهذه القصة عبارة عن حكاية منقولة ومتداولة بين بعض الباحثين، ومفادها:” أنه لما أفتى ابن عرضون للمرأة بالنصف وسواها بالرجل في العمل، ثارت ثائرة بعض العلماء في أنحاء المغرب، وفي فاس بوجه خاص، واتفق أن وفدا من علماء فاس كانوا في زيارة لضريح عبد السلام ابن مشيش دفين جبل العلم، ومروا في رحلتهم بشفشاون التي كان ابن عرضون قاضيا بها لملاقاته ومناقشته في فتواه المستحدثة وسألوه عن القضية، فما أجابهم بشيء، بل طلب منهم الانتظار، وبينما هم كذلك إذ مر فوج من النساء وهن حاملات أثقالا على ظهورهن – كعادتهن- من حطب وأنواع أخرى من الأثقال، فقال لهم: ما رأيكم في هؤلاء النساء؟ فتعجب العلماء من ذلك، وأذعنوا لرأيه، وأيدوا حكمه، وأدركوا وجاهة فتواه، وأصابتها روح العدل “[17].
لكن الشيخ التاويل- رحمه الله – أنكر وجود هذه القصة واعتبرها مجرد ادعاء لا يصح قائلا:“وآخر هذه التبريرات والدفاعات عن ابن عـرضـون مـا طالعنا به بعض الباحثين (يقصد عمر الجيدي) من رجوع شـيـوخ فـاس عـن فـتـواهم الى فـتـوى ابن عـرضـون بـعـدما شاهدوا بأعينهم بشفشاون المرأة البدوية وهي تحمل على ظهرها حمولة الدواب فأيدوه في حكمه وأذعنوا لرأيه، وهو ادعاء لا يصح، وقولة لا تثبت، والفتاوى لا تثبت بالشائعات، وكل الفقهاء الذين تناولوا الموضوع لم يشيروا إلى رجوع أهل فاس عن فتواهم، ولو رجعوا أو رجع أحد منهم لنبهوا عليه ولم يغفلوه، والأصل ادعاء الاستصحاب، وبقاء ما كان على ما كان حتى يتبين خلافه. كما أن الفقه لا يتأثر بالمشاهد والمناظر، لأنها ليست من أصوله ولا مصادره“[18].
كما أيد هذه الفتوى أيضا الدكتور إدريس حمادي في كتابه:” البعد المقاصدي وإصلاح مدونة الأسرة“؛ فبعد أن استعرض هذه النازلة، والآراء الفقهية في موضوع اقتسام الممتلكات بين الرجل والمرأة خاصة بعد الطلاق، وحلل مفهوم المنحة وبين كيفية تطبيقاتها كما وردت في نص القرآن الكريم، قال: “والآن وقد تبين أن هناك كثيرا من الأدلة يمكن الاستناد إليها في: أن للمرأة المطلقة لغير سبب “المظلومة” نصيبا في الممتلكات أو قنطارا بلغة القرآن، وأن هذا النصيب أو القنطار قد استند البعض في تقديره إلى المعروف والبعض الآخر اجتهد فقدره بالنصف والبعض الآخر حاد عن النصف إلى الربع…، أقول إذا انطلقنا هذه الخصوصيات، ومما يشـير إليه النص الشرعي واجتهادات الفقهاء فيه أمكن أن يقدر نصيب المرأة المطلقة المظلومة في نظرنا بما لا يتجاوز النصف في حده الأعلىوالربع في حده الأدنى“[19].
ثانيا: المعارضون لفتوى ابن عرضون
ويمثلهؤلاء من علماء فاس والمغرب في القرن المعاصر الشيخ محمد التاويل رحمه الله،والذي ألف كتابا خاصا بهذه النازلة وَسَمَهُ ب:”إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية – رؤية إسلامية“؛ حيث استعرض فيه أنواع عمل المرأة، وبين حكم كل نوع من الناحية الفقهية، ثم خصص الحيز الأكبر من هذا الكتاب لدراسة هذه النازلة تحديدا؛ بحيث استعرض فتوى ابن عرضون بنصها، وبين توثيقها، وأبرز مستندها الفقهي، وناقشها، ورد عليها وعلى المؤيدين لها من القدماء والمعاصرين، وأورد بعض الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية المقررة في باب اقتسام الأموال التي تدل على فساد هذه الفتوى وتناقضها ومناقضتها لقواعد الشريعة، وذلك من ص 18 إلى ص 94 من الكتاب؛ ثم خلص إلى القول ببطلان دعوى بعض المعاصرين بحق الزوجة في اقتسام المال مع زوجها المكتسب خلال العلاقة الزوجية بناء على فتوى ابن عرضون، بقوله:”ليس لهذه الفتوى التي أفتى بها ابن عرضون أصل في الشريعة الإسلامية ولا سند لها في الفقه“[20]، ويضيف في موضع آخر من الكتاب:” وما تزال هذه الفتوى تثير أطماع المشاغبين، ولعاب العلمانيين في الاحتماء بها، واتخاذها مظلة لتحقيق أغراضهم في إشعال الفنية ونار الحرب داخل الأسرة المغـربـيـة بإغراء الزوجة وتحريضها على المطالبة بحقها في مال الزوج وثروته المكتسبة بعد الزواج، بحجة فتوى ابن عـرضـون ومن سار في ركابه من المفتين الذين قلدوه، أو توسعوا في الموضوع أكثر منه. رغم شذوذ فتواه وضعفها، ومخالفتها لنصوص الشريعة وقواعدها العامة، ومناقضتها لفتاواه في نظائرها“[21].
ولا شك أن هذا هو موقف أغلب العلماء والفقهاء في المغرب وخارجه، لكن إلى أي حد يمكن اعتبار الموقفين معا لهما حظ من النظر والصواب باستثمار قواعد منهج تنزيل الأحكام عند المالكية؟ذاك ما سيتم بيانه في المبحث الثاني.
المبحث الثاني: مناقشة فتوى الكد والسعايةوإمكانية العمل بها على ضوء متغيرات العصر
إن المتأمل في فتوى ابن عرضون وما أثارته من نقاش فقهي حاد، بين العلماء في القديم والحديث؛ يلاحظ بأن مستند ابن عرضون في فتواهومن ناصره، وكذا مستند المنتقدين لها وبشدة من علماء فاس ومن وافقهم، هو إعمال بعض قواعد التشريع عند المالكية، وخاصة قاعدتي العرف وما جرى به العمل، واعتبار المصلحة المرسلة.
فإلى أي حد يعتبر اجتهاد الفريقين معا وموقفهما مصيبا للحق وموافقا للشريعة باعتبار، وبالمقابلمجانبا للصواب والحق باعتبار آخر؟ خاصة إذا ما استحضرنا بأن كليهما ينطلق من أصول المالكية ومنهجم في استنباط الأحكام وتنزيلها على الوقائع، وأن الاختلاف بينهما هو في منهج تكييف النازلة فقط.
هذ ما سأحاول بسط القول فيه وبيانه في هذا المبحث من خلال مطلبين اثنين.
المطلب الأول: مناقشة موقف المؤيدين والمعارضين لفتوى ابن عرضون
الفقرة الأولى: مناقشة موقف المعارضين لفتوى ابن عرضون
لقد وجه بعض الفقهاء قديما وحديثا نقدا شديدا لهذه الفتوى، واعتبروها مخالفة لقواعد الشريعة وانحلالا منها وتحريفا لها، كما سبق بيان ذلك عند إيراد رد الشيخ عبد القادر الفاسي على فتوى ابن عرضون ونقده الشديد لها، وكذا رد الشيخ محمد التاويل في كتابه:” إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية ــ رؤية إسلامية“.
لكن المتأمل في الأدلة التي استند عليها فقهاء فاس آنذاك تحديدا ومن انتصر لهم في نقض فتوى ابن عرضون، نجد بأنها ترجع في عمومها إلى اعتبار العرف وما جرى به العمل عند أهل فاس، ثم مراعاة قاعدة المصلحة في تقسيم المال وتوزيعه بين الرجل والمرأة مدة العلاقة الزوجية بإعطاء كل ذي حق حقه؛ وبيان ذلك في الآتي:
أولا: استعمال قاعدتي العرف وما جرى به العمل، قال صاحب العمل الفاسي في نظمه السابق:
لكن أهل فاس فيها خالفوا قالوا لهم في ذاك عرف يعرف”[22]
فعرف أهل فاس وما جرى به العمل عندهم، هو أن المرأة لا تتشاح مع زوجها في خدمة أسرتها ومساعدة زوجها في تنمية ماله، دون أن تأخذ على ذلك مقابلا، أو تطالب بهذا الحق عند الطلاق أو الوفاة.
ثانيا: اختلاف طبيعة العمل التي كانت تقوم به المرأة الجبلية أو السوسية مع طبيعة العمل التي كانت تقوم به المرأة في مدينة فاس وما يشبهها من المدن، فنساء البادية كن يشتغلن خارج البيت في الفلاحة وتربية المواشي بالإضافة إلى عملهن داخل البيت، بينما عمل النساء في مدينة فاس وما يشبهها، كان يقتصر على القيام بشؤون البيت، ولا يشتغلن خارجه؛ لأن الزوج هو المكلف بالعمل خارج المنزل وتوفير حاجات الأسرة المادية من نفقة وسكن…
ثالثا:إن إعمال قواعد الشريعة في تقسيم المال، وقاعدة المصلحة المرسلة في إحقاق الحق ورفع الظلم، يقتضي بأن لا تطالب المرأة التي لم تشارك في القيام بعمل خارج البيت بحقها في المال الذي اكتسبه الرجل بسعيه وحده، مدة العلاقة الزوجية؛ لأن ذلك يتنافى مع قواعد الشرع في كيفية تقسيم الثروة بين الزوج والزوجة، وهو ظلم للرجل، وأكل لماله دون وجه حق، وبالتالي فمن مصلحة استقرار الأسرة وتحقيق مقاصد الزواج، عدم جواز مطالبة المرأة بحق ليس لها فيه نصيب لا شرعا ولا واقعا.
لذلك فخلاصة القول: هو أن المتفحص لموقف علماء فاس من هذه الفتوى، ومن انتصر لهم من المعاصرين، يتوصل إلى أنه موافق للشرع، ومصيب للحق بالاعتبار السابق، لأنه يراعي قواعد العرف وما جرى به العمل، والمصلحة الفضلى للزوج والزوجة والأسرة عموما؛
لكن هل هذا هو الموقف الفقهي البات والنهائي في هذه النازلة، بحيث لا يقبل أي اجتهاد من العلماء مهما اختلفت الظروف وتغيرت الأحوال؟ وبغض النظر عن اجتهاد ابن عرضون ومن انتصر له قديما وحديثا؟
الفقرة الثانية: مناقشة موقف المؤيدين لفتوى ابن عرضون
سبق في المبحث الأولعرض نص فتوى ابن عرضون،والتي أجاز فيها لنساء بادية جبالة– اللواتي كن يشتغلن مع أزواجهن في الفلاحة وتربية المواشي – حقهن في اقتسام هذا المال المكتسب خلال فترة العلاقة الزوجية؛ واستند في فتواه إلى إعمال قاعدتي العرف وما جرى به العمل في المنطقة، وكذا إعمال قاعدة المصلحة المرسلة التي تقضي بأن إعطاء المرأة حقها في هذه الممتلكات هو تحقيق لمبدإالعدل، ورفع للظلم عنها؛ وهو ما أفتى به فقهاء سوس أيضا بحق المرأة في ” السعاية”، وهكذا أصبحت هذه النازلة مشهورة ومتداولة بعبارة:” حق المرأة في الكد والسعاية”.
وإن المتتبع لسياق هذه الفتوى وظروفها، يلاحظ ما يأتي:
الملاحظة الأولى: هي فتوى خاصة بنساء البادية؛ (بادية منطقة جبالة بالنسبة لفتوى ابن عرضون، ونساء بادية سوس بالنسبة لفقهاء سوس)، ولذلك فهي في أصلها فتوى خاصة بنساء البادية ولا تنطبق على نساء المدينة؛ لأن الفتوى قد تتغير مكانا وزمانا وشخصا، باختلاف تحقيق مناطها العام والخاص معا.
الملاحظة الثانية: هي فتوى تخص عمل المرأة في الفلاحة من زراعة وتربية للمواشي وما في حكمهما، ولا شك أن هذا العمل خاص بنساء البادية، ويختلف عن طبيعة عمل المرأة في المدينة في المجال الصناعي والتجاري..، وبالتالي ففتوى ابن عرضون لا يمكن تعميمها وتطبيقها شرعا ومصلحة وواقعا على كل عمل تقوم به النساء، وخاصة في المدينة في المجال الصناعي والتجاري، نظرا لاختلاف طبيعة العمل ومردوديته، وشروط الاشتغال فيه...
الملاحظة الثالثة: هي فتوى تستند إلى عرف المنطقة؛ بحيث جرى العمل فيها بأن المرأة تشتغل مع زوجها في الفلاحة وتربية المواشي..، ولها حقها في هذا المال، دون إنكار من فقهاء المنطقة وقضاتها، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذا عرف حسن؛ لأنه يحقق مبدأ العدل والإنصاف بين الزوج والزوجة على حد سواء، وهو من مقاصد الإسلام وغايته. لكنه عرف خاص بأهل المنطقة، أو بالمناطق التي تشبهها، كبادية سوس مثلا؛ وعليه فلا يمكن تعميم هذه الفتوى على كل مناطق المغرب، لاختلاف ظروف المرأة وعملها والعارف السائد بين السكان فيها.
وخلاصة الكلام في فتوى ابن عرضون: أننا إذا وضعناها في سياقها: زمانا، ومكانا، وعرفا، ومصلحة، يمكن القول بأنها كانت مصيبة للحق وموافقة للشرع بهذا الاعتبار، لأنها راعت العرف الجاري به العمل بين الناس هناك، وكانت استجابة لظروف اجتماعية تعيشها المرأة الجبلية؛”فهي تعمل كل شيء وتواصل الليل بالنهار، إذ يعتبر عمل الرجل متضائلا بجانب عملها، فمن سقي الماء إلى جلب الحطب، ومن حرث الأرض واقتلاع الأشجار إلى بناء الدور، ومن حصد الزرع ودرسه وجمعه وتذريته ونقله وطحنه إلى رعي الماشية، بالإضافة إلى البيع والشراء وحمل الأثقال على ظهرها، نظير ما تحمله البغال والحمير تماما، زيادة على وظيفة الأمومة وربة البيت، ثم لا تحصل بعد طلاقها أو وفاة زوجها إلا على حقوقها المعروفة من إرث أو متعة أو نفقة أو سكنى“[23]؛ وكل ذلك دون مقابل، وهذا من الظلم الفاحش، والإجحاف الفظيع الذي لن يقبل به فقيه متبصر بمقاصد الشرع، ومعايش للواقع، سواء كان ابن عرضون أو غيره.
لكن هل يمكن القول بتعميم هذه الفتوى على عمل باقي النساء إذا توفرت نفس الظروف والمبررات، سواء في البوادي أو المدن كما تنادي بذلك بعض الاجتهادات الفقهية والحقوقية في هذا العصر؟
الجواب عن هذا السؤال، والسؤال الذي قبله في خاتمة الفقرة الأولى، هو ما سيتم بيانه وبسطه في المطلب الثاني من هذا المبحث.
المطلب الثاني: ترجيح القول في إمكانية العمل بفتوى ابن عرضون على ضوء متغيرات العصر
بداية يجب التنبيه والتأكيد على أن الاجتهاد في هذه النازلة الفقهية، وغيرها من النوازل؛ يجب أن يصدر من أهله، وبشروطه، وفي محله، (وهم العلماء المتمكنون من فقه الشريعة ومن منهج تنزيلها في الواقع)، وليس من طرف أي كان، كما يدعي البعض ويتجرأ في هذا الزمان؛ ولست أرى نفسي أهلا لذلك، لكن واجب البحث وطبيعته، يحتم علي بيان الموقف والجواب عن التساؤل السابق قدر المستطاع، ودون جرأة على أحكام الشرع؛ وحسبي في ذلك إجادة النظر فيما صدر عن الفقهاء من أقوال، ثم البناء عليها باستثمار بعض قواعد منهج التنزيل عند المالكية، ما دامت هذه المسألة فيها اجتهاد عند فقهاء المذهب، واختلفوا في تكييفها الفقهي بناء على أدلة وقواعد الشرع، وبمراعاة الواقع.
وبناء عليه،يمكن ترجيح القول في هذه المسألة حسب التفصيل الآتي:
أولا: الأصل في الشرع أن لكل من الرجل والمرأة ذمة مالية مستقلة، سواء قبل الزواج أو بعده، ما دام كل منهما يكسب ماله من عمل خاص به، لقوله تعالى:﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيب مِّمَّا اَكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيب مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ﴾[24]؛ فهذه الآية وإن كانت واردة في سياق خاص، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول علماء الأصول، وبالتالي فالمال المكتسب مدة العلاقة الزوجية لا حق فيه للمرأة إذا كان من كسب الرجل، ولا حق فيه للرجل إذا كان من كسب المرأة الخاص؛ إما بعملها في الوظيفة، أو في القطاع الخاص، أو التجارة، أو عن طريق الإرث..؛ وهذا ما أكدت عليه مدونة الأسرة في المادة 49 عندما نصت على أنه: ” لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر“.
ثانيا:إن الزوجة ليست ملزمة بالعمل في مال زوجها لتنميته، ولا يجب عليها ذلك شرعا؛ سواء في الفلاحة، أو الصناعة، أو التجارة…، وأن نفقتها وتوفير حاجاتها وكل متطلبات الأسرة ماديا واجب شرعي على الزوج؛ باعتبار ذلك من مقتضيات القوامة التي أسندها الله للرجل في قوله تعالى: ﴿اِ۬لرِّجَالُقَوَّٰمُونَ عَلَي اَ۬لنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اَ۬للَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَيٰ بَعْضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنَ اَمْوَٰلِهِمْۖ﴾[25]؛ يقول الدكتور مصطفى بن حمزة:” والواجب الذي يقابل القوامة وينشأ عنها هو واجب الإنفاق على المرأة في كل مراحل عمرها، بنتا وزوجة وأما، لأن ضمان معيشتها وتلبية حاجاتها هو سبيل إلى صون كرامتها وإلى حفظ شخصيتها“[26]، والمقصد الأعظم من ذلك: ضبط التنظيم المالي للأسرة، وحفظ استقرارها، وتحقيق وظائفها الشرعية والاجتماعية والحضارية.
ثالثا:إن المرأة إذا عملت مع زوجها في ماله بعد الزواج، وسعت إلى تنميته، بإرادتها ورضاها ومكارمة منها، أو كان العرف الجاري به العمل يقتضي ذلك، دون أن يطلب منها الزوج ويرغمها على ذلك، أو يعمل على استغلالها، فلا حق لها في هذا المال المكتسب مدة العلاقة الزوجية أيضا؛ لأنه مال الزوج وحده، ولم تكن أجيرة ولا شريكة فيه بمقتضى قواعد الشرع في اقتسام المال، ولأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كما أن حفظ مصلحة الأسرة واستقرارها واستمرارها أولى من كل اعتبار، وهو مضمون رد فقهاء فاس، ومن انتصر لهم، على فتوى ابن عرضون؛ إلا إذا قدمت الزوجة بوسائل الإثبات المقررة ما يفيد عكس ذلك، فهنا قد يكون للقضاء اجتهاد آخر.
رابعا: إذا كان العرف الجاري به العمل يقضي بأن تعمل المرأة مع زوجها في ماله، وتشارك في تنميته، سواء كان عملها في الفلاحة أو غيره، ولها حق مقرر في ذلك بموجب العرف؛ فحقها ثابت شرعا أيضا؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولأن مبدأ العدل والحق، وتجنب الظلم، يوجب إعطاءها نصيبها من هذا المال، بإعمال قاعدة المصلحة المرسلة أيضا؛ وهو مضمون فتوى ابن عرضون ومن ناصره من فقهاء المذهب، كالمهدي الوزاني في نوازله الجديدة.
خامسا:إن الزوجة إذا عملت في مال زوجها بعد الزواج، وشاركت في تنميته، وكان ذلك بمقتضى اتفاق مسبق بينهما في عقد مستقل عن الزواج، على اقتسامه، إما بالإجارة أو الشركة…، وإما مناصفة، أو بنسبة مئوية بينهما، وبرضاهما وإرادتهما وحسب توافقهما، فلها الحق في هذا المال وفق ما هو متفق عليه، ولس في ذلك إخلال بقواعد الشرع ومقاصده في هذه الحالة، لأن المسلمين عند شروطهم ما دامت موافقة للشرع،وهذا ما قال به الدكتور عبد الكبير المدغري في مسألة تعامل الزوجين مع المال المكتسب مدة العلاقة الزوجية كسبا وإنفاقا حسب اتفاقهما، بقوله :”وإنما نقصد به التراضي الثنائي الحر النابع من إرادة الزوجين ورغبتهما المشتركة والمنبثقة عن التشاور بينهما وتأملهما المشترك في الصيغة التي يريد أن تكون عليهما حياتهما الزوجية“[27]، وهذا الاجتهاد الفقهي أخذ بعين الاعتبار التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة، وأراه رأيا فقهيا يتناسب مع روح الإسلام ومقاصده، ويحقق مصلحة الزوجين معا، وينظم علاقتهما المادية، لكن هذا الاتفاق ينبغي أن يراعي مصلحة الأسرة، ومقاصد الشرع من الزواج، ولا يخل بمبدإ القوامة في الشرع بأي حال، وإلا جنينا على الأسرة من حيث ندعي الإصلاح والتغيير نحو الأفضل.
سادسا: أقترح أن يكون هناك اجتهاد فقهي يتبعه تعديل قانوني للمادة 49 من مدونة الأسرة، في مسألة التنصيص صراحة على حق الكد والسعاية للزوجة العاملة داخل البيت أو خارجه سواء في الحاضرة أو البادية، باعتباره مساهمة فعالة من الزوجة في تنمية أموال الأسرة خلال الحياة الزوجية، لكن مع وضع شروط وضوابط وأحكام لذلك حتى لا يتم فتح هذا الباب بشكل مطلق يؤدي إلى تفكك الأسرة؛ يصدر من المؤسسات العلمية المعترف بها شرعا وقانونا، ويمثلها المجلس العلمي الأعلى بالمغرب باعتباره مؤسسة دستورية، يحسم النقاش في هذه النازلة، ويرجح ما يراه موافقا لمقاصد الشرع، ومحققا لمصلحة الأسرة المغربية على ضوء متغيرات الواقع؛ وبهذا يمكن الإسهام والحسم في حل هذه الإشكالية الفقهية والحقوقية القديمة والجديدة معا.
وأؤكد – في الأخير – على أن مدونة الأسرة المغربية لم تنص على حق الكد والسعاية صراحة، لكنها لَمَّحَتْ إليه بشكل متحفظ عندما نصت في المادة 49 على أنه: ” يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها “؛ ويرجع الأستاذ ” الميلود كعواس“[28] إلى أن الذي دفع المشرع المغربي إلى عدم التنصيص صراحة على هذا الحق والاكتفاء بالتلميح إليه، هو كون هذا الحق عرفا خاصا جرى به العمل في مناطق خاصة ووفق ظروف معينة، والمدونة إنما جاءت ليحتكم إليها جميع المغاربة في سائر أنحاء المملكة، كما جاء ذلك في المادة الثانية من مدونة الأسرة[29].
أما قضائيا؛ فنجد أن محكمة النقض قد أكدت صراحة على أن كل عمل تقوم به الزوجة خارج بيت الزوجية إلى جانب زوجها، وتساهم به في تنمية أموال الزوج، يعتبر كدًّا منها تستحق عليه مقابلا يناسب عملها بناء على ما قرره الفقه، وهذا نص القرار[30]: ” إنَّ كل عمل تقوم به المرأة خارج بيت الزوجية وتساهم به في تنمية أموال الزوج يعتبر كدًّا منها تستحق عليه مقابلا يناسب عملها وهو ما قرره الفقه، ومنه ما أفتى به العباس في أجوبته – المخطوطة – أن الذي جرى به العمل عند فقهاء المصامدةوالجزولة أن الزوجة شريكة زوجها فيما أفاداه مالا بتعيينهما وكلفتهما مدة انضمامهما ومعاونتهما ولا يستبد الزوج بما كتبه على نفسه بل هي شريكة له فيه، والطالبة أثارت أنها تعمل إلى جانب زوجها في تربية الماشية وتنظيف الاصطبلات وإعداد ما تحتاج إليه الأسرة وأدلت إثباتا لذلك بلفيف عدلي، والمحكمة لما التفت عن مناقشة تلك الحجة لترتب عليها قضاءها سلبا أو إيجابا فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قراراها للنقض في هذا الخصوص “؛وفي المقابل نجد أن محكمة النقض قد قضت في قرار سابق[31] بأن الخدمة المنزلية لا تعتبر عملا من أعمال الكد والسعاية ولا مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج، وعللت رفضها للطلب بكون الطاعنة لم يثبت لها بمقبول أنها ساهمت فعليا في تنمية أموال الأسرة، وأن الخدمة المنزلية تعتبر من التزاماتها العادية، طبقا للمادة 51 من مدونة الأسرة التي تنص على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.
خاتمة
إذا كان من المقرر أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان وإنسان؛ فإن اللازمَ المنطقي لهدي الواقع بتعاليم الإسلام: اجتهادٌ منضبط بقواعد الشرع ومراعي للزمان والمكان، والوقائع والأحوال، لأنه من غير الممكن إيجاد حلول شرعية لمتغيرات الواقع البشري بدون الاجتهاد والتجديد في بعض الفتاوى والآراء الفقهية التي صدرت عن الفقهاء، وكان تحقيق المناط فيها حسب زمانهم ومكانهم، ولم تعد شروط تحققها وتطبيقها قائمة في واقعنا المعاصر؛ومن ذلك الاجتهاد في هذه المسألة الفقهية والحقوقية المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة المالية على ضوء التحولات الاجتماعية والمستجدات التشريعية والمؤسساتية.
وبهذا المنهج يمكن التجديد في المنهج الفقهي، وإعادة النظر في التراث الفقهي عموما، على ضوء حاجات العصر وواقع الناس فيه، لأخذ الأصلح والأنسب منه، وترك ما كان مختصا بعصر دون آخر، بناء على ظروف ذلك العصر وملابسته، وحاجات الناس فيه، لكن مع الحفاظ على الأصول والقواعد والأحكام الثابتة؛ وهكذا يصبح الفقه مادة حية في واقع الناس، مواكبا للمتغيرات، ومستوعبا للمستجدات، بما يحقق مصالح الناس ولا يناقض مقاصد الشرع؛وقد خلص هذا البحث إلى مجموعة من النتائج ألخصها فيما يلي:
1- إن القائلين بالكد والسعاية يستمدون مشروعيتها من مبدإ العدالة في الإسلام المقررة أصولها في القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم ما استقر عليه العرف وما جرى به العمل.
2- إن القول بالكد والسعاية ملحظ فريد خاص بفقهاء المغرب الأقصى دون غيرهم، مما يدل على عبقرية هؤلاء الفقهاء، وقدرتهم الكبيرة على إيجاد الأجوبة الشرعية للحوادث والنوازل الطارئة.
3- إن حق الكد والسعاية الذي أفتى به الفقهاء كابن عرضون وغيره، إنما هو عرف خاص بمناطق معينة، وخاضع لظروف وأحوال متجددة.
4- إن حق الزوجة في الكد والسعاية لا يشمل إلا ما كدت فيه المرأة من عملٍ خارجٍ عن أعمالها المنزلية، كالحرث والحصاد .. وغيرها، ويمكن قياس عمل المرأة اليوم في عصرنا هذا على ذلك.
5- إن الفتوى بحق الكد والسعاية محكومة بضوابط وشروط محددة عند الفقهاء، بحيث لا يستحق هذا الحق إلا بها.
6- على المشرع المغربي في مدونة الأسرة الأخذ بفتوى الكد والسعاية في حالة طلاق الزوجة أو وفاة زوجها، والتنصيص صراحة على حق المرأة العاملة خارج المنزل في الثروة الأسرية المكتسبة مدة العلاقة الزوجية، خاصة في ظل عدم تفعيل الزوجينلمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة.
قائمة المصادر والمراجع المعتمدة في البحث
٭ القرآن الكريم برواية الإمام ورش عن نافع.
٭ أبو عيسى المهدي الوزاني: ” تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس “، تقديم: هاشم العلوي القاسمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – الرباط، طبعة سنة 2001م/1422ه.
٭ أبو عيسى سيدي المهدي الوزاني “المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتوى المتأخرين من علماء المغرب“، قابله وصححه: عمر ابن عباد، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية – الرباط-، طبعة سنة: 1419ه/1998م.
٭ إدريس حمادي: “البعد المقاصدي وإصلاح مدونة الأسرة “، إفريقيا الشرق – الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2005.
٭أحمد ابن القاضي المكناسي: “جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس“، دار المنصور – الرباط، طبعة سنة: 1973م.
٭ أحمد ابن القاضي المكناسي: “درة الحجال في غرة أسماء الرجال“، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، درا الكتب العلمية -بيروت، الطبعة الأولى، 1423ه/2002م.
٭ أحمد بابا التنكبتي: ” كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج “، تحقيق: أبو يحيى عبد الله الكندري، دار ابن حزم-بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1422ه/ 2002م.
٭ الميلود كعواس: “حقُّ الزوجة في الكد والسعاية دراسة في التراث الفقهي المالكي “، مطبعة المعارف الجديدة – الرباط-، الطبعة الثانية، 2013.
٭ الملكي الحسين بن عبد السلام: “نظام الكد والسعاية“، مكتبة دار السلام- الرباط، طبعة سنة 2002.
٭ محمد بن جعفر الكتاني: ” سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس“، تحقيق: عبد الله الكامل الكتاني وحمزة بن محمد الطيب الكتاني ومحمد حمزة بن علي الكتاني، دار الثقافة – البيضاء، الطبعة الأولى، سنة 1425ه/2004م.
٭ مصطفى بن حمزة: ” كرامة المرأة من خلال خصوصيتها التشريعية “، مكتبة الطالب – وجدة، طبعة سنة 2004.
٭ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي: ” الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي“، تحقيق: عبد العزيز عبد الفتاح القاري، المكتبة العلمية – المدينة المنورة، بدون تاريخ الطبع.
٭ محمد مخلوف: “شجرة النور الزكية في طبقات المالكية“، تحقيق: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية -بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1423ه/2003م.
٭ محمد التاويل: ” إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية “، مطبعة آنفو- برانت، طبعة سنة 2006.
٭ عبد الكبير المدغري: ” المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير “، مطبعة فضالة – المحمدية، طبعة سنة: 1420ه/1990م.
٭ عيسى بن علي الحسني العلمي: “النوازل “، تحقيق: المجلس العلمي بفاس – وزارة الأوقاف، مطبعة فضالة – المحمدية-، طبعة سنة 1406ه/1986م.
٭ عمر الجيدي: “ابن عرضون الكبير: حياته وآثاره وفقهه “، دار عكاظ للطباعة والنشر، طبعة سنة 1987.
٭ صالح عبد السميع الآبي الأزهري: “جواهر الإكليل – شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل-“، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، د.ت.
٭ رجاء مكاوي: “قضايا الأسرة بين عدالة التشريع، وفرة التأويل، قصور المساطر، تباين التطبيق“، دار السلام، طبعة سنة: 2002.
1– رجاء مكاوي: “قضايا الأسرة بين عدالة التشريع، وفرة التأويل، قصور المساطروتباين التطبيق “، دار السلام، طبعة سنة: 2002، ص: 107.
1– هو الإمام، القاضي، الفقيه، العالم أبو العباس أحمد بن الحسن بن يوسف بن عمر بن يحيى المعروف والمشتهر بابن عَرضون، الزَّجَلي، المُوسوي، الصَّالحي، المغربي، المالكي؛لم تُسعف المصادر في تحديد زمن ولادة ابن عَرضون، في حين خَلُص الأستاذ عمر الجيدي ـ رحمه الله ـ في بحثه إلى أنه وُلد عام 947هـ بمجموعة من المرجحات يطول ذكرها هنا، وكانت ولادته بقرية تلمبوط التابعة لإقليم شفشاون شمالي المغرب، ونشأ في أحضان أسرة معروفة بالفضل والدين والعلم؛ تقلَّبَ ابن عَرضون بين مدارس جبال غمارة، وبين حلقات الدروس بجامع القرويين بفاس، فنجد في طليعة الذين أخذ عنهم: والده الذي حفظ عليه القرآن الكريم ودرسه مبادئ النحو، والفقه، وعمُّهُ أبو حفص عُمر، وأبو محمد الهبطي، وأبو عبد الله محمد بن مجبر المساري، أبو نعيم الجنوي، وأبو العباس المنجور، وغيرهم من أعلام المغرب في ذلك الوقت، حتى صار مَضرب المثل في العلم والورع والتقوى؛ ولي بعد رجوعه من فاس القضاء بشفشاون، وزاول إلى جانبها مهام متعددة: كالخطابة والتدريس والإفتاء؛ واشتهر ابن عرضون بانتدابه للتأليف، وعُرف تمييزاً عن أفراد أسرة ابن عرضون بالعالم المُؤلف، ومن أشهر مؤلفاته: «اللَّائق لمعلم الوثائق»، و«مقنع المحتاج في آداب الأزواج»، ثم اختصره في كتاب بعنوان «مختصر مقنع المحتاج في آداب الأزواج والولدان»، رسالة آداب الصحبة، أو رسالة التودد والتحابب، و«حدائق الأنوار وجلاء القلوب والأبصار في الصلاة والسلام على النبي ﷺ وعلى آله وأصحابه الأبرار»، وكتاب في شرح أسماء الله الحسنى، وغير ذلك؛ كانت وفاته ـ رحمه الله ـ في بلده ومسقط رأسه في العاشر من رجب عام 992هـ، ولم يُعلم موضع دفنه.
* مصادر ترجمته: درة الحجال لابن القاضي (1/172)، جذوة الاقتباس له أيضاً (1/160)، سلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني (2/268)، شجرة النور الزكية لمخلوف (ص286)، الفكر السامي للحجوي (2/602).
2– ومعنى هذا الحق اصطلاحا كما ذكر ذلك الملكي الحسين في كتابه: نظام الكد والسعاية “هو حق المرأة في الثروة التي تنشئها وتكونها مع زوجها خلال فترة الحياة الزوجية” انظر ص: 12؛ ويضيف الملكي موضحا هذا التعريف: ” وهذا الحق يضمن للزوجة إذا انتهت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، إما بالطلاق أو الوفاة، بأن يتم تحديد وحساب مجموع الثروة التي تم تكوينها خلال فترة الحياة الزوجية، فتحصل على جزء منها مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية إلى جانب زوجها” انظر ص: 12.
1– هو محمد بن قاسم بن محمد القَوْرِي اللخمي المكناسي الفاسي؛ الإمام القدوة، رأس العلماء ومفتي الحضرة الفاسية؛ كان علامة جامعا مشارا إليه في تحقيق علوم النقل والعقل؛ أخذ عن عمران الجاناتي وابن غياث السلاوي وعبد الله العبدوسي وغيرهم؛ وأخذ عنه ابن غازي وأحمد زروق وابن هلال وغيرهم؛ توفي – رحمه الله- سنة 872ه.
* مصادر ترجمته: كفاية المحتاج لأحمد بابا التنبكتي (ص: 432-433)، درة الحجال لابن القاضي (ص: 279).
2– هو أبو القاسم بن علي بن خجو الحساني الفقيه المفتي بالبلاد الهبطية، كان فقيها نوازليا يستظهر الفقه المالكي، وكان قولا للحق لا يخاف في الله لومة لائم، توفي – رحمه الله – سنة 956ه؛ درة الحجال لابن القاضي (ص: 425).
3– عيسى بن علي الحسني العلمي: “النوازل “، تحقيق: المجلس العلمي بفاس – وزارة الأوقاف، مطبعة فضالة – المحمدية، طبعة سنة 1406ه/1986م، 1/ ص: 101-102.
4– الميلود كعواس: “حقُّ الزوجة في الكد والسعاية دراسة في التراث الفقهي المالكي “، مطبعة المعارف الجديدة – الرباط-، الطبعة الثانية، 2013، ص: 81.
5– إدريس حمادي: “البعد المقاصدي وإصلاح مدونة الأسرة “، إفريقيا الشرق – الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2005، ص: 86.
6– ينظر مقدمة الأستاذ هاشم العلوي القاسمي على تحفة أكياس الناس، ج1، ص: 18.
1– هو أبو زيد عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي، الإمام العلامة العمدة المحقق المتفنن في العلوم، حامل راية المنثور والمنظوم، أخذ عن والده وأحمد الزموري والشريف البوعناني وابن سودة وغيرهم، له تآليف منها: نظم العمل الفاسي، واللمعة في قراءة السبعة، وغاية الوطر في علم السير، وغيرها ..، توفي سنة: 1096ه؛ شجرة النور الزكية، 1/456-457.
2– أبو عيسى المهدي الوزاني: ” تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس “، تقديم: هاشم العلوي القاسمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – الرباط، طبعة سنة 2001م/1422ه، ص: 33.
3– للاطلاع على نص الفتوى يرجع إلى نوازل العلمي: مرجع سابق، 2/ ص: 104-105 – 106.
4– هو أبو محمد عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي شيخ الجماعة، علم الأعلام، الفقيه المحدث المفسر، أخذ عن كثير منهم: والده وابن عاشر وعم أبيه وهو عمدته وبه تخرج، وأخذ عنه الكثير منهم: أبناؤه وعيسى الثعالبي وأبو سالم العياشي ومحمد العربي وغيرهم ..، توفي – رحمه الله- سنة 1007ه؛ شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ( 1/ ص: 455-456).
1– صالح عبد السميع الآبي الأزهري: “جواهر الإكليل – شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل-“، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، د.ت، ج2/ ص: 198.
1– أبو عيسى سيدي المهدي الوزاني “المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتوى المتأخرين من علماء المغرب”، قابله وصححه: عمر ابن عباد، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية – الرباط-، طبعة سنة: 1419ه/1998م، ج7/ ص: 262-263.
2– إدريس حمادي: مرجع سابق، ص: 86.
3– عمر الجيدي: “ابن عرضون الكبير: حياته وآثاره وفقهه “، دار عكاظ للطباعة والنشر، طبعة سنة 1987، ص: 199.
1– محمد التاويل: ” إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية “، مطبعة آنفو-برانت، طبعة سنة 2006، ص: 54.
2– إدريس حمادي: مرجع سابق، ص: 87-88.
1– محمد التاويل: مرجع سابق، ص: 23.
1– أبو عيسى المهدي الوزاني: مرجع سابق، ص: 33.
1– عمر الجيدي: مرجع سابق، ص: 193 وما بعدها.
3– مصطفى بن حمزة: ” كرامة المرأة من خلال خصوصيتها التشريعية “، مكتبة الطالب -وجدة، طبعة سنة 2004، ص: 54.
1– عبد الكبير المدغري: ” المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير “، مطبعة فضالة – المحمدية، طبعة سنة: 1420ه/1990م، ص: 79.
1– الميلود كعواس: مرجع سابق، ص: 110.
2– تنص المادة الثانية من مدونة الأسرة على أنه: ” تسري أحكام هذه المدونة على: 1- جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى …..“.
3– قرار محكمة النقض عدد: 63، في الملف الشرعي رقم: 742/2/2/2019، الصادر بتاريخ: 15 فبراير 2022.
4– قرار محكمة النقض عدد: 770، في الملف الشرعي عدد: 154/2/1/2016، الصادر بتاريخ: 06دجنبر 2016.