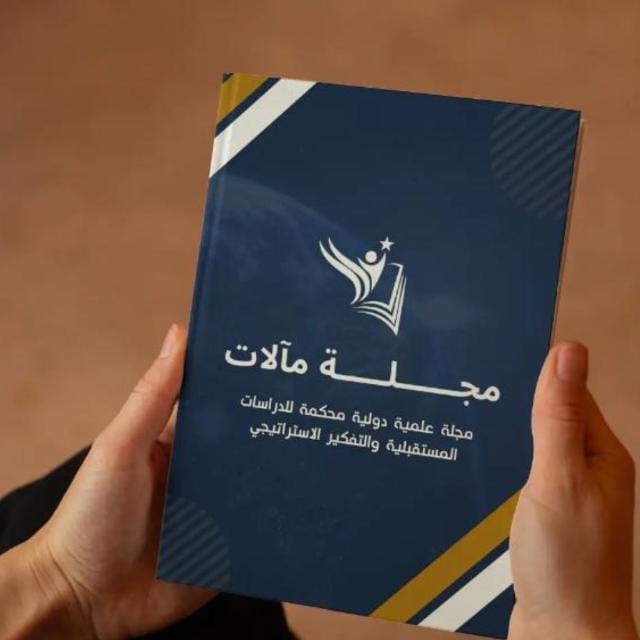بشرى حبوبة جامعة محمد الخامس– الرباط
الملخص
تعد مدونة الأسرة عنصرا مهما في سياق التنمية،لأنها تعالج قضايا تؤثر على المساواة القانونية (الحق في الزواج والطلاق، صفة رب الأسرة، إدارة الممتلكات الزوجية وحضانة الأطفال)، والحصول على الأصول الاقتصادية (الإرث، والمهر، والنفقة الزوجية، والنفقة على الأطفال)، وحماية الأطفال (الحضانة). كما تجعل المسؤولية عن الأسرة مشتركة بين الزوج والزوجة على قدم المساواة؛ وليست حكرا على الرجل فقط. غير أنه وبعد مرور عقدين من الزمن على تفعيلها بأقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية، ظهرت مجموعة من الإشكالات التي أثرت بشكل أو بآخر على روح وفحوى مدونة الأسرة، والتي تعود يمكن ردها إما لعدم انسجام النصوص، وعدم مراعاتها لسياقاتها الشرعية والتشريعية؛ أو لتعارضها مع مقتضيات العديد من موادها. مما فرض على المشرع إعادة النظر في مجموعة من مقتضياتها، ومحاولة تأهيلها على نحو يساعد على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى عشرين سنة، وكذا تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية.
الكلمات المفتاحية: مدونة الأسرة – المساواة القانونية – تعديل النصوص – التحولات المجتمعية.
Abstract
The Family Code is an important element in the context of development, where it addresses issues relating to legal equality (the right to marriage and divorce, the status of head of the family, the management of matrimonial property, custody children), access to economic goods (inheritance, dowry, spousal support, child support), as well as the protection of children (custody). This also means that responsibility for the family is shared equally between husband and wife; and not reserved only for the father. However, two decades after being instated at the level of the family courts of first instance, a set of problems emerged, which affected in one way or another the spirit and content of the Family Code, and which can be attributed either to the lack of coherence of the texts, or their failure to take into account their legal and legislative contexts; or because it conflicts with the requirements of several of its articles. This forced the legislators to reconsider a set of its requirements, and to attempt to rehabilitate it in such a way as to contribute to correcting the imbalances that their judicial application had revealed for twenty years, as well as to modify the requirements which had become obsolete, due to the development of Moroccan society and national laws.
Keys words: Family Code – Legal equality – Editing texts – Social changes,
مقدمة:
تعتبر الأسرة أهم المؤسسات الاجتماعية التي يحتمي بها الإنسان، ويحقق من خلالها جوهره الإنساني، ويكسب داخل إطارها هويته وشخصيته.ومعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يؤدي المهمة الإستخلافية العمرانية المناطة به، إلا إذا انخرط في كيان اجتماعي،وفي مقدمته كيان الأسرة التي يقول عنها الشيخ محمد الغزالي: “إن تكوينها دين، والحفاظ عليها إيمان؛ ومكافحة الأوبئة التي تهددها جهاد، ورعاية ثمرتها من بنين وبنات جزء من شعائر الله”(قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة2002). ولما كانت الأسرة مركز المجتمع وجوهره، فقد عمدت كل القوانين الدولية والوطنية إلى جانب الشريعة الإسلامية، بتقنين كل ما يتعلق بالأسرة، وتحديد أدوار الفاعلين فيها وصيانة حقوقهم. خاصة منها المجتمعات العربية والإسلامية التي شهدت تحولات هائلة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
وفي هذا السياق،عرف المغرب سجالا كبيرا حول مراجعة مدونة الأحوال الشخصية، انتهي إلى تبني مدونة الأسرة سنة 2004 التي اعتُبِرت، وطنياً ودولياً، مشروعا مُؤسِّساً لمجتمع متساو وحداثي، يستهدف التوفيق بين القيم الكونية لحقوق الإنسان والمقاصد النبيلة للمرجعية الإسلامية. وقد شكل استبدال مُسمَّى قانون الأسرة من «مدونة الأحوال الشخصية» إلى» مدونة الأسرة» قطيعة مع هذه الأخيرة من جهة؛ وتأكيدا على أن القانون الجديد هو لجميع أفراد الأسرة من جهة ثانية، بالنظر لما حققه من مكاسب من حيث النهوض بحقوق المرأة، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، والحفاظ على كرامة الرجل؛ وذلك في احترام تام للثوابت الدينية والهوية المغربية، ومراعاة للتطورات الدولية والوطنية.
والآن، وبعد انصرام عقدين على دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، عرف المغرب تحولات كبرى على المستوى المجتمعي وعلى مستوى تركيبة الأسرة، نتيجة للتزايد السكاني، وارتفاع نسبة التمدرس، وخروج النساء لسوق العمل… ومع ما أفرزه التطبيق العملي من اختلالات وثغرات، سواء على مستوى النص أو على مستوى فهمه وتنزيله، ومسايرة للتطورات التشريعية التي عرفها المغرب؛ ووفاءً بالتزاماته الدولية، بعد مصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل،فقد أصبحت الحاجة إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة أمرا ضروريا وملحا، من أجل ضمان وتعزيز أمن واستقرار الأسرة المغربية.والسؤال المطروح هنا: إلى أي حد استجابت المدونة للتحديات المجتمعية التي تواجهها الأسرة؟ وما أبرز الإشكالات القانونية والاجتماعية التي أفرزتها بعد دخولها حيز التطبيق؟ وما هي المحددات المنهجية لإصلاح المدونة، والتعديلات المرتقبة؟
لمقاربة هذا الموضوع،لا نجد بُداًّ من إعطاء نظرة حول سياق إصلاح مدونة 2004 وأهم المستجدات التي جاءت بها؛ وكذا بيان المحددات المنهجية لإصلاحها، ثم الوقوف على أهم الإشكالات العملية التي أفرزها تفعيل بنودها،وتطبيق مقتضياتها.
1– سياق إصلاح المدونة
غداة حصول المغرب على استقلاله، وانطلاق عملية بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها، انصب اهتمام الملك محمد الخامس على تطوير منظومة قانونية متناسقة ومتكاملة، تحقق المرامي والأهداف التي كان يتطلع إليها الشعب المغربي؛وفي صدارتها وضع مدونة للأسرة مستمدة من المذهب المالكي الذي كان المعمول به في المغرب. ولهذه الغاية أصدر ظهيرا شريفا بتاريخ 22 محرم1377(19 غشت 1957م)، أُحدثت بمقتضاه لجنة لوضع مدونة لأحكام الفقه الإسلامي، عرفت ب “مدونة الأحوال الشخصية” التي اعتبرت حينها إنجازا رائداً، وتقنينا لفيض من القواعد والأحكام الفقهية المتناثرة في تضاعيف كتب الفقه الإسلامي،تم جمعها وإفراغها في فصول محددة ومضبوطة يسرت على القضاة مجال الفهم والتطبيق. غير أنه،وبعد مرور عقدين من الزمن على صدور المدونة ووضع مقتضياتها على محك التفعيل والتطبيق القضائي؛ كشفت عن قصور بَيِّنٍ في بعض موادها التي بَدَا أنه في حاجة للإصلاح والتعديل، لتصبح متماشية مع التقاليد والأعراف المغربية، ومُواكِبةً لما عرفه البلد من تحولات اجتماعية كبرى.
هكذا، وبعد أن أصبح المغرب عضوا في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة منها الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء (سنة 1979)، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل (سنة1989)؛ وبعد أن قُدِّمت العديد من العرائض والمطالب من حركات المجتمع المغربي، استقبل الملك الحسن الثاني وفدا نسائيا بتاريخ 19 شتنبر 1992، تم على إثْرِه تشكيل لجنة أُنِيط بها تعديل بعض فصول المدونة، التي لها علاقة بوضعية المرأة والطفل داخل الأسرة سنة 1993.وقد شملت هذه التعديلات بصفة عامة الفصول المتعلقة بولاية المرأة والطلاق والتعدد والحضانة؛ وكان ذلك أول تعديل يمس فصول المدونة منذ الشروع في العمل بها سنة 1958، مع استثناء التعديل المتعلق ب “الإرث بالرد[1]“الذي اعتُمِد سنة 1962[2]. وقد ظل الأمر كذلك، إلى حدود سنة 2004 عندما دعا نخبة من العلماء إلى وضع مدونة للأسرة -جديدة-، قمينة بأن ترمم الخلل وتواصل مسار الإصلاح، بعد أن انكشفت ثغرات ومثالب جديدة تحتاج إلى مزيد من التنقيح والتعديل.
للإشارة، فالمقصود بمدونة الأسرة، مجموعة القواعد الموضوعية والشكلية التي تنظم علاقة الأفراد، من حيث الزواج والطلاق وأثرهما، وكذا نظام الإرث والوصية.فأهميتها تبدو أكبر من باقي القوانين الأخرى، لكونها تمثل وثيقة يؤطر سلوكيات الأسرة المغربية من الولادة إلى ما بعد الوفاة؛كما تختزل نصا يُعنى بتدبير السلطة داخل بيت الزوجية.ونظرا للطابع الديني لقضايا الأسرة، واحتراما للاتفاقيات الدولية، وتماشيا مع ما تتطلبه الحداثة، فقد استندت مدونة الأسرة في صياغتها إلى المرجعيات التالية:
– المذهب المالكي.
– الانفتاح على المذاهب الأخرى.
– الاجتهاد الذي يُراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
– الاتفاقيات الدولية.
– العمل القضائي.
مما جعلها تنطوي على عناصر تجديد معتبرة، من شأنها أن تساعد على حلحلة المطالب القانونية، وأن تستجيب للانتظارات الشعبية.
2-مستجدات مدونة الأسرة
تعتبر مدونة الأسرة ثمرة نقاش مستفيض شغل الرأي العام المغربي لفترة طويلة؛ وبصدورها سنة 2004حقق المغرب تقدما ملموسا على مستوى الحقوق والعلاقات الاجتماعية، التي كرست المساواة بين الجنسين. ومن أبرز المستجدات التي جاءت بها نذكر:
أولا: إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين، وتمثل ذلك في:
-المساواة في رعاية الأسرة، إذ أصبحت الزوجة طرفا أساسيا وشريكا للزوج، على قدم المساواة، في رعاية الأسرة، وفي الحقوق والواجبات.
– المساواة في سن الزواج، وذلك باعتماد سن موحدة للفتى والفتاة، وهو 18 سنة كحد أدنى.
– المساواة بين الولد والبنت المحضونين في سن اختيار الحاضن، وحصرها في 15 سنة لكل منهما.
– جعل الولاية في الزواج حقا للمرأة، تمارسه الرشيدة باختيارها ومصلحتها؛
– المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين تجاه الأسرة؛ وإعمالا لهذا البند تم التخلي عن مفهوم الطاعة مقابل الإنفاق.
– جعل الطلاق بيد كل من الزوجين، يمارسه كل منهما حسب شروطه الشرعية، وتحت مراقبة القضاء باعتباره حلا لميثاق الزوجية.
– المساواة بين أولاد البنت وأولاد الابن في الاستفادة من حقهم في تركة الجد، عند وفاة البنت أو الابن قبله أو معه) الوصية الواجبة (.
– تقييد إمكانية التعدد بشروط صارمة[3].
ثانيا: ترسيخ مبدأ العدل والإنصاف،من خلال:
– التدخل التلقائي للنيابة العامة كطرف أصلي في الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام الأسرة؛
– الإسراع في إقامة أقسام الأسرة بمختلف المحاكم، ودراسة إمكانية إحداث صندوق التكافل العائلي؛
– إقرار جواز الاتفاق بين الزوجين لتنظيم واستثمار أموالهما المكتسبة عند أو خلال فترة الزواج؛
– إثبات نسب الأطفال المزدادين أثناء فترة الخطوبة[4].
ثالثا: تبسيط الإجراءات وتسهيل المساطر عن طريق:
– تحديد مدة البث في القضايا المتعلقة بالنفقة داخل أجل أقصاه شهر واحد؛
– تبسيط مسطرة الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج؛
– تبني صياغة قانونية وشرعية جديدة للمدونة تتلاءم مع روح العصر، واستبعاد بعض المصطلحات التي أضحت متجاوزة، أو من شأنها المساس بكرامة المرأة وإنسانيتها.
وعلى الرغم من أن المدونة أدخلت العديد من الأحكام الجديدة، إلا أن ثمة مشاكل عديدة ومعقدة طفقتْ قائمة بخصوص بكيفية تفسيرها وتنزيلها على أرض الواقع.
3- الإشكالات العملية لمدونة الأسرة
شكلت مدونة الأسرة طفرة نوعية وتقدما كبيرا في مجال تعزيز الحقوق الإنسانية، وتحقيق الالتحام الأسري، ورأب الصدع الذي قد يعتري مؤسسة الزواج. غير أن الممارسة المهنية والتنزيل العملي لبعض مقتضياتها أظهر بعض الإشكالات، من أهمها:
1-3– إشكالات في كتابي الزواج والطلاق
إن نظام الزواج هو النظام الذي ارتضاه الله للإنسان؛ فبه تنظم الغريزة، وبه يتم التأسيس لأسرة ناجحة ومتينة. يقول الله عز وجل: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾ سورة الروم:21. وفي هذا الإطار، جاء قانون مدونة الأسرة ينشد تنظيم حياة الناس، والوصول إلى حلول شرعية تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية، وتأخذ بعين الاعتبار متطلبات القرن الواحد والعشرين. وإذا كانت مدونة الأسرة قد وضعت ضوابط محكمة لتنظيم مؤسسة الزواج، فإن الأمر ما انفك ينطوي على نوع من القصور والغموض بخصوص صور الزواج: زواج الراشدين- زواج القاصر- زواج التعدد- زواج المغاربة المقيمين بالخارج؛ بل ولا يتوقف هذا الغموض عند مرحلة الزواج، وإنما يمتد ليشمل مرحلة انحلال الرابطة الزوجية.
أ)-الإشكالات المتعلقة بزواج الراشدين: بخصوص زواج الراشدين الذين ينعمون بحياة زوجية عادية، فيتعين حذف اللبس من الفقرة الثانية من المادة 10[5]والمادة 14[6] من المدونة، بحيث يؤكد النص صراحة على “العدليْن” بدل “الشاهديْن”. لأن لفظ “الشاهدين” عام، يشمل الشاهدين من عامة المسلمين، كما قد يشمل العدلين؛ والحال، أن المدونة نفسها عبرت في المادة 14ب “شاهدين مسلمين”.والمراد بهما شاهدان من عموم المسلمين، بينما المقصود ب “الشاهدين” في المادة 10، هما العدلين المُوَثِّقيْن لعقد الزواج؛ ورفعا لهذا الخلط وَجَبَ التعبير بلفظ “العدلين” بدل الشاهدين.
ب)– الإشكالات المتعلقة بزواج القاصر: يعتبر زواج القاصر من المواضيع القديمة/الحديثة، التي تصدى لها الباحثون في العلوم الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ لما يفرضه الواقع من تغييرات ومستجدات، وما يتسم به من تباين في العادات والتقاليد. حيث ما زال الجدل الفقهي قائما حول مدى مشروعية تحديد سن أدنى للزواج، ومدى أحقية ولي الأمر في وضع الضوابط والشروط له في إطار المصلحة العامة؛ لتحقيق مقاصد الشريعة في بناء الأسرة بناء سليما.يشمل زواج القاصر الشخص الذي لم يبلغ بعد سن الرشد القانونية؛ فإذا كانت المادة 20 من المدونة صريحة في أنه يمكن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المحدد في 18 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك؛ فان الواقع العملي أبان عن أن هذه الظاهرة ما لبثت مستشرية في المجتمع المغربي، حسب مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل.بالنظر إلى أن عدد رسوم الزواج دون سن الأهلية المسجل منذ سنة 2004، عرف تغيرا ملحوظا من سنة لأخرى؛ حيث سجل ارتفاعا مضطردا في السنوات السبع الأولى لدخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، بلغ ذروته سنة 2011 بما مجموعه 39031 رسم زواج بقاصر، أي ما يعادل 12%من مجموع رسوم الزواج المبرمة في نفس السنة. هذا، قبل أن يسجل المنحنى انخفاضا ملموسا بعد ذلك، ليستقر في حدود 21433 أي ما يعادل8,5%من مجموع رسوم الزواج لسنة 2021.
إجمالا، وبرغم إحاطته بفيض من الضمانات القانونية،فإن واقع تطبيق مدونة الأسرة بشأن زواج القاصر قد اعترته كثير من التعقيدات، وأبان عن العديد من الإشكاليات، نذكر منها:
– إشكالية عدم تحديد السن الأدنى الذي في إطاره يمكن الإذن بزواج القاصر، لذلك وجب تحديد حد أدنى في 16 أو17 سنة لكلا الجنسين وبموافقة الوالدين، على غرار التشريعات المقارنة كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الإيطالي الذي حدد السن القانوني في 16 سنة كاستثناء، كلما توفرت أسباب وجيهة، وبعد موافقة الوالدين وصدور إذن قضائي.
– عدم تحديد -في المادة 20 أو في أي مادة أخرى- للاختصاص المكاني مما يؤدي الى التحايل.
– لم تلزم المدونة القاضي بالسماع للقاصر؛
– عدم التنصيص على إلزامية الجمع بين البحث الاجتماعي والخبرة الطبية؛
– عدم بيان المقصود بالخبرة الطبية ومن يقوم بها؛
– تفاوت المبررات القضائية المعتمدة في تزويج القاصرات؛
– تفاوت في السلطة التقديرية بين المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف.
ورفعا لهذا الاختلاف وتوحيدا لمناهج العمل لدى كل أقسام قضاء الأسرة، يتعين أن ينص قانونا وبشكل صريح يحسم هذا الأمر.
ج)-الإشكالات المتعلقة بتعدد الزوجات: تطرح مسألة التعدد إشكالات مجتمعية كثيرة تمت معالجة معظمها في إطار مدونة الأسرة؛ غير أنه وبعد تفعيلها منذ سنة 2004، طفت على السطح مشاكل شتى، لعل أهمها تمسك الزوج أحيانا بالتعدد دون موافقة الزوجة المراد التزوج عليها. وفي حال عدم طلب الزوجة الطلاق،تُطبِّق المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليه في المواد 94 إلى 97 من مدونة الأسرة؛مما يفرض طرح السؤال: هل للمحكمة الحق أن تطبق،بشكل تلقائي،مسطرة الشقاق؟ علما بأنه عند الرجوع إلى الفصل 03 من قانون المسطرة المدني[7] نجده ينص على التالي:”يتعين على المحكمة أن تبث في حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات؛ وتبث دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة، ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة”.وهو أمر جَلِي، يوجب على المحكمة ألا تبث فيما لم يطلب منها؛مما يجعل المادة 45 من مدونة الأسرة متضاربة مع الفصل 03 من قانون المسطرة المدنية؛وبالتالي، فأي النصين يصير واجب التطبيق؟
وفي ذات السياق، نظم المشرع مسطرة التعدد في المواد من 40 إلى 46، متجها إلى تكريس طابع المنع إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، أو في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها؛ بل إنه جعل الإذن مقرونا بمجموعة من الشروط، كضرورة إثبات الزوج لوجود مبرر موضوعي استثنائي. وهنا لم يحدد المشرع مفهوم المبرر الموضوعي الاستثنائي؛ مما ترك الباب مفتوحا أمام السلطة التقديرية للقاضي في منح الإذن بالتعدد.
د)– الإشكالات المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج: جاءت المادة 14 لحلحلة المشاكل المتعلقة بزواج المغاربة المقيمين بالخارج، ولتسهيل مسألة زواجهم عبر التوفيق بين العقدين المدني والشرعي. حيث ترك إبرام عقد الزواج للإجراءات الإدارية المطبقة في البلد الأجنبي الذي يقيمون به، شريطة توفر شروط عقد الزواج المنصوص عليها في المادة13 من مدونة الأسرة؛ إلا ما كان من شرط سماع العدلين “الإيجاب والقبول” من الزوجين وتوثيقه، واكتفى باشتراط حضور شاهدين مسلمين. وهذا الشرط يطرح عدة إشكالات توثيقية عملية يعاني منها مغاربة العالم، كما يعاني منها الموظفون المكلفون بمهام العدول بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج.
يتمثل الإشكال الأول في حكم الإخلال بهذا الشرط، إذ أُغْفِلَ حكم الاستغناء عن شاهدين مسلمين عند إبرام العقد، وتم تداركه فيما بعد أو لم يتم تداركه.وهنا يجدر التساؤل: ما هي طبيعة هذا الزواج في هذه الحالة؟ هل هو صحيح من الناحية القانونية أم لا؟ خاصة وأنه بالرجوع إلى المواد59 و60و61 المتعلقة بالزواج غير الصحيح، لا تندرج ضمنها حالة الزواج الذي لم يحضره الشاهدان المسلمان ضمن الزواج الباطل، ولا ضمن الزواج الفاسد؛ وبالتالي، فهل حضور الشاهدين المسلمين أمر اختياري؟ مع التذكير بأن المحكمة الابتدائية بمكناس، مثلا، ذهبت في إحدى أحكامها إلى رفض تذييل الحكم بالطلاق الصادر عن المحكمة الابتدائية ببوردو بالصيغة التنفيذية.لكون “عقد الزواج المُدْلى به، غير مضمن للأركان والشروط المنصوص عليها في المادة14 من مدونة الأسرة، ومن ضمنها حضور شاهدين مسلمين؛مما يفيد بأن عقد الزواج المذكور مخالف لمقتضيات النظام العام المغربي[8]“.
بالنسبة للإشكال الثاني، فنلفيه مرتبطا بكيفية إثبات أن الشاهدين الحاضرين مع الزوجين مسلمين؛ إذ هل يتعين إدلاؤهما بشهادة تؤكد ديانتهما/إسلامهما، أم الاكتفاء بالجنسية فقط؟ أم الاقتصار على كون أسماء الشاهدين عربية؟ علما بأن أن الجنسية أو الاسم لا يعكسان مطلقا عقيدة المعنيين بالأمر؛ إذ ليس كل مغربي أو عربي مسلم، وليس كل أجنبي أو أعجمي غير ذلك.
وبخصوص الإشكال الثالث الذي يثيره هذا الشرط -أي حضور شاهدين مسلمين- فيتعلق بكيفية إثبات حضور هذين الشاهدين وفق قانون بلد الإقامة في عقد الزواج؟ وما هو المخرج في الحالة التي لا يسمح فيها بلد الإقامة بذلك؟ وهل يجوز تضمين حضور الشاهدين في عقد مستقل عن عقد الزواج؟
أما الإشكال الأخير المترتب عن مقتضيات المادة 15، التي تشترط وجوب إيداع نسخة من عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد الإقامة، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية التابع لها محل إبرام العقد؛ فإذا لم توجد هذه المصالح، تُرسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. فالإشكال الذي تطرحه هذه المادة يتمثل في الآثار الناشئة عن عدم إيداع هذه العقود بالقنصلية في الموعد المحدد، أو إيداعها بعد انصرام أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليها قانونا[9] ؟ وما الإجراء الذي يتعين اتخاذه في حال ما تقدم الزوجين بنسخة من العقد للمصالح المعنية بشكل متأخر؟ هل يتم قبوله منهما، أم لابد من سلوك مسطرة أخرى بديلة؟
2-3 الإشكالات المتعلقة بانحلال ميثاق الزوجية
تعتبر الرابطة الزوجية من أهم أسس الزواج الذي تنشأ به الأسرة؛ والقاعدة أن الزواج”ترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام”؛والمقصود بذلك أن نية طرفي عقد الزواج يجب ألا تنصرف إلى توقيته، أي هو دوام الحياة الزوجية واستمرارها. غير أن هذه الديمومة والاستمرارية لا تعني خلود هذه الحياة وبقاءها إلى الأبد، بل يمكن أن تنحل الرابطة الزوجية، سواء بوفاة أحد الزوجين أو فقده، كما يمكن أن تنتهي بطلاق او تطليق أو فسخ؛وفي هذا السياق، حاولت مدونة الأسرة وضع مجموعة من المقتضيات التي تروم تبسيط الإجراءات. إلا أنه بالرغم من ذلك، فقد أفرز الواقع العملي إشكالات عديدة لابد من الوقوف عندها.
أ)-الإشكالات الخاصة بالطلاق والتطليق: نظم المشرع المغربي في المواد من78 إلى93 من مدونة الأسرة، عددا من الإجراءات التي يتعين على الطرفين والمحكمة سلوكها؛ بدءا بطلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، ومرورا بمحاولة الصلح بغرفة المشورة، التي يتعين على المحكمة القيام بها، وتحديد مستحقات الزوجة والأطفال إذا فشلت محاولة الصلح؛ وانتهاء بالإذن بتوثيق الطلاق لدى عدلين. وفي هذا الصدد، فقد أتاحت المدونة للزوج والزوجة، على حد سواء، إمكانية إنهاء العلاقة الزوجية إما بالطلاق أو التطليق؛مع إخضاع ممارسة هذا الحق لمراقبة القضاء.
ولئن كانت المحاكم المغربية قد سجلت في الفترة الممتدة بين سنتي 2017و2021 ما مجموعه 588.769 قضية طلاق وتطليق، وفق ما جاء في تقرير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول القضاء الأسري بالمغرب لسنة 2023؛ فإن من الإشكالات المثارة بهذا الشأن:
– عدم تنصيص المدونة على الوكالة في الطلاق والتطليق.
-عدم تقييد الإذن بتوثيق الطلاق الاتفاقي بأجل معين.
-في حال تخلف الزوجة، طالبة التطليق، عن الحضور بعد استنفاذ محاولة الصلح، هل يمكن اعتبار تراجعاً عن طلب التطليق؟
-هل للأبناء الراشدين الحق في التدخل في دعاوى الطلاق والتطليق للحصول على المستحقات؟
– غياب تعريف في المدونة يحدد فيه مفهوم ” الشقاق”، وترك الأمر مفتوحا للسلطة التقديرية للقاضي؛ فالمادة 94 مهجورة فيما يخص مفهوم التطليق للشقاق: ماذا نقصد بها؟
– عبء المادة 81 من مدونة الأسرة بخصوص المغاربة المقيمين بالخارج، التي تلزم الزوج في قضايا الطلاق، بل وحتى في قضايا التطليق للشقاق، بأن يحضر بصفة شخصية إلى إحدى محاكم المملكة، عملا بمقتضيات المادتين 79 من مدونة الأسرة والفصل 212 من قانون المسطرة المدنية،المتعلقتين بالاختصاص المحلي لدعاوى الطلاق والتطليق.
ب)-الإشكالات الخاصة بمسطرة الصلح:لا شك أن مدونة الأسرة المغربية جاءت بمجموعة من المستجدات والإصلاحات، التي حاولت من خلالها رأب الصدع بين أفراد الأسرة وجمع شملها. خاصة عند حدوث نزاع يُفضي إلى حل ميثاق الزوجية، والذي لا يعتبر اللجوء إليه إلا استثناء؛ لما له من تأثير على تفكك الأسرة، سواء بالنسبة للزوجين أو بالنسبة للأبناء في حالة وجودهم. ولعل أبرز هذه المستجدات التي أضحت الآن من بين الإشكالات المثارة، ما يتعلق بمسطرة الصلح وإلزاميتها في قضايا الطلاق والتطليق؛ علما بأنها تعتبر من الإجراءات الجوهرية التي نصت عليها مدونة الأسرة في المادتين 81و 82، خاصة منها الشق المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية.والواقع أن مسطرة الصلح هذه، قد أبانت عن مجموعة من الإشكالات التي تعيق تطبيقها على أرض الواقع؛ نذكر منها:
-نصت الفقرة الثانية من المادة 82علىانتداب الحكمين من طرف المحكمة:”للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة…[10]“. والملاحظ أن هذه الفقرة جاءت مبهمة، باعتبارها لم تحدد بشكل دقيق صفة الحكمين،كما لم تبين الشروط والاعتبارات التي على إثرها يتم انتداب الحكمين ومجلس العائلة. مما يفرض السؤال عن ماهية المعايير والاعتبارات، التي يأخذ بها القاضي الصلحي في انتداب الحكمين ومجلس العائلة؟ وهل كل الأشخاص أهل لتولي هذه الصفة؟فالمادة 81 من مدونة الأسرة” تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح”…أي إلزامية حضور الزوجين بصفة شخصية لمحاولة الإصلاح بينهما من طرف المحكمة. لكن ما غاب عن المشرع، عند وضعه لهذا المقتضى، هو مسألة زواج المغاربة المقيمين بالخارج، أو الذين يعملون خارج أرض الوطن وزيجاتهم داخله، خاصة أولئك الذين يجدون صعوبة في التنقل والسفر؛ علما بأن المشرع رتب جزاء على عدم حضور الزوج أو الزوجة لمسطرة الصلح في قضايا الطلاق. فإذا تخلف الزوج عن الحضور، رغم توصله بالإشعار شخصيا، يعتبر متراجعا ما لم يُدلِ بعذر مقبول؛ بينما إذا تخلفت الزوجة، رغم استدعائها بصفة شخصية، فإنها لا تعتبر متراجعة إذا كانت مدعية أو طالبة الطلاق.
– إن وجود بعض الإشكالات في المقتضيات القانونية الخاصة بتنظيم مسطرة الصلح،قد انعكس سلبا على الجانب العملي حينما أراد القضاء تطبيق هذه المقتضيات؛ بل وزاد الأمر سوءا عندما ساهم في خلق إشكالات واقعية جديدة تضاف إلى الإشكالات والمعيقات العملية التي يعاني منها القضاء المغربي ابتداءً.ومن أبرزها أن مسطرة الصلح لا تقام داخل الوقت الكافي لمحاولة الإصلاح بين الزوجين؛ كما أن القاضي المكلف بالصلح يكون مجبرا على إجراء العشرات من جلسات الصلح في اليوم الواحد، مما يؤثر سلبا على مضمون وجودة وفعالية هذه المسطرة؛ بحيث تتم مسطرة الصلح بطريقة سريعة ودون أن تتحقق الغاية المرجوة.
3-3 الإشكالات المتعلقة بالنيابة الشرعية: يقصد بالنائب الشرعي، طبقا للمادة 230 من مدونة الأسرة، الولي وهو الأب والأم والقاضي، والوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ وأخيرا المقدم وهو الذي يعينه القضاء.غير أن ما يلاحظ، أن المدونة ميزت بين الأب والأم التي لا تعتبر نائبة شرعية على أبنائها، إلا على سبيل الاحتياط؛ أي في حالة عدم وجود الأب أو فقْد أهليته، وهو ما يسبب لها مشاكل جمة عند محاولة استصدارها لبعض الوثائق الإدارية لفائدة أبنائها. مما يجبرها على اللجوء إلى القضاء الاستعجالي، أو للنيابة العامة أو حتى القضاء الإداري؛هذا، خلافا للأب الذي لا يجد أي صعوبة في نيابته عن أبنائه؛ مع التذكير بأن مقتضيات المادة 4 من مدونة الأسرة أسندت رعاية الأسرة للزوجين على نحو متساو.
4-3 الإشكالات المتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة(المادة 49): إن الأموال المكتسبة بين الزوجين هي الأموال التي يتم اكتسابها خلال فترة الزواج؛ سواء من خلال العمل أو الاستثمار أو أي مصدر آخر ، وبشكل عام، تخضع هذه الأموال للقسمة بالتساوي بين الزوجين في حالة الانفصال أو الطلاق؛ لكنه بالرغم من منح المشرع لأطراف النزاع إثبات حقوقهم طبقا للقواعد العامة، مع مراعاة مجموعة من العناصر، فأن هذه المقتضيات ما انفكت تثير إشكالين اثنين نوردهما فيما يأتي.
– الإشكال الأول يرتبط بتحديد مفهوم “القواعد العامة”، إذ لم يحدد المشرع لا طبيعة هذه القواعد العامة ولا مصدرها ، وقد ترتبت عن هذا اللبس عدة أراء، يذهب أولها إلى أن المقصود بذلك القواعد المنظمة لظهير الالتزامات والعقود؛ مما دعا المشرع إلى منح الطرفين حرية الإثبات، دون أن يقيده في اتجاه الإثبات المدني، لكونه يصطدم مع مقتضيات الفصل443 قلع، الذي يفرض الإثبات الكتابي لكل تصرف يتجاوز1000درهم.في حين يجنح الرأي الثاني إلى منح الحق لكل زوج في رفع الدعوى أمام المحكمة للمطالبة بحقه؛ مع إمكانية اعتماده لكافة وسائل الإثبات، دون التقيد بأحكام الفصل443 من قلع. وأما الاتجاه الثالث، فيرى أن المقصود بالقواعد العامة، تلك المنصوص عليها في المادة 400[11] من مدونة الأسرة، على اعتبار المذهب المالكي مصدراً مكملا لنص المدونة، التي تشكل مرتكزا قانونيا يمكن الاستناد إليه في تحديد طبيعة القواعد العامة للإثبات.[12]
– أما الإشكال الثاني فيتعلق بطبيعة ونطاق العناصر الثلاثة، التي أدرجها المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 49، والتي يعتمد عليها القاضي في ترتيب حق الزوجين في المكتسبات خلال الحياة الزوجية في حالة غياب الاتفاق الكتابي.وتتمثل هذه العناصر في مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة؛ مع الإشارة إلى أن المشرع لم يحدد طبيعة هذه الأعمال ولا المجهودات المبذولة، ولا حتى المقصود بتحمل الأعباء. إذ هل يندرج كل ما يقوم به أحد الأزواج سواء كان ماديا أو معنويا ضمن هذه العناصر؟ وهل تدخل الأعمال المنزلية التي تقوم بها الزوجة في هذه الأعباء[13]،في ظل تنصيص المشرع على جعل مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال مشتركة بين الزوجين[14]؟
هكذا، وبعد استعراض هذه الإشكالات، يتبين أنه بالإضافة إلى المعيقات القانونية والقضائية التي تعرقل تطبيق مدونة الأسرة،وجب التنبيه إلى أن هناك معيقات اجتماعية وثقافية أخرى تتمثل في غياب الفهم الصحيح لمقتضيات موادها لدى الأسر المغربية، بسبب ضعف التوعية والتحسيس. مما يستلزم صياغة مقتضيات قانونية متكاملة ومتناسقة، تضمن التطبيق السليم لمدونة الأسرة التي ستخرج إلى حيز الوجود في غضون هذه السنة (2024).لكن وقبل اعتزام إعادة النظر في بنودها، لا مناص من الاستناد إلى محددات منهجية للإصلاح، نستعرض عناصرها تباعاً فيما يلي.
3- المحددات المنهجية لإصلاح مدونة الأسرة
لأجل المبادرة بإصلاح ناجع للمدونة، لابد من اقتفاء منهجية حصيفة تقوم على جملة من المحددات والمرتكزات المنهجية التي يبدو متفاوتة من حيث أهميتها وأولويتها.
1-3سمو المرجعية الإسلامية: تعتبر المرجعية الإسلامية مرجعية الدولة المغربية بمؤسساتها ومكوناتها؛ حاكمة لتشريعاتها وقوانينها التي لا ينبغي أن تعارض ثوابتها وقطعياتها، خاصة في مجال الأسرة الذي له مكانة خاصة في دين الإسلام. وهو ما تم تأكيده على النحو التالي في الدستور المغربي، وفي الخطب الملكية ذات الصلة، وفي نص مدونة الأسرة حتماً.
أولا- دستور المملكة المغربية: ورد في تصدير دستور 2011 أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية”. وقد تم التنصيص في فصله الأول على الآتي:”تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح…”.وتم التأكيد في الفصل الثالث على أن:”الإسلام دين الدولة”؛ وفي الفصل الثاني والثلاثين على أن:”الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع”.
ثانيا–الخطب الملكية: جاء في خطاب العرش لسنة 2022:”وبصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله؛ لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية ، ومن هنا، نحرص أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي؛ مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”؛ مما يؤكد على حرص جلالة الملك على الالتزام بأحكام الشريعة القطعية.كما أكد هذا التوجه في خطاب العرش لسنة2023 بما يلي:”في ظل ما يعرفه العالم، من اهتزاز في منظومة القيم والمرجعيات، وتداخل العديد من الأزمات، فإننا في أشد الحاجة الى التشبث بالجدية، بمعناها الأصيل:
– في التمسك بالقيم الدينية والوطنية، وبشعارنا الخالد: الله– الوطن- الملك؛
– في التشبث بالوحدة الوطنية والترابية للبلاد؛
– في صيانة الروابط الاجتماعية والعائلية، من أجل مجتمع متضامن ومتماسك”.
وزاد في خطاب افتتاح السنة التشريعية (أكتوبر 2023) بقوله:” في إطار هذه القيم الوطنية، التي تقدس الأسرة والروابط العائلية، تندرج الرسالة التي وجهناها الى رئيس الحكومة بخصوص مراجعة مدونة الأسرة ، إن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها؛ فالمجتمع لن يكون صالحا إلا بصلاحها وتوازنها، وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة “.
ثالثا: مدونة الأسرة: أكدت مدونة الأسرة هذه المنطلقات في الشأن الأسري الذي يلتصق عند أغلب الطوائف المغربية بالدين؛ حيث نصت في المادة الثانية على سريان أحكامها على مَغربيَيْن أحدهما مسلم، واستثنت من اليهودي المغربي الذين يحتكم إلى الأحوال الشخصية العِبْرية.وقد جاءت المادة 400 من مدونة الأسرة لتؤكد هذه الصلة، ولتفتح إمكانية الاجتهاد المنضبط للشريعة، المراعي لتحقيق قيمها ومقاصدها فيما لم يتم التنصيص عليه:” ما لم يَرِدْ به نص في هذه المدونة، يُرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يُراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف”.
2-3سمو الاتفاقيات الدولية مقيد بأحكام الدستور وبالهوية الوطنية الراسخة للمملكة المغربية: إن هذا المبدأ، قد نص عليه الدستور في تصديره حيث أكد التالي:”إن الهوية المغربية تتميز بتبوّء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها”، وأن المصادقة على الاتفاقيات الدولية وسموها على المواثيق الوطنية يكون”في نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة”. ومن ثم، فإن المواثيق الدولية مرحب ومعمول بها، طالما أنها تتوافق مع مبادئ الأمة،ولا تسمو على التشريعات الوطنية.
3-3مقاربة تشاركية شاملة لمؤسسة الأسرة وعدم تجزيئها: تصاغ المدونة من خلال النظر المنهجي الشامل لمؤسسة الأسرة وليس لأفرادها؛ والمقصود هنا تغليب المقاربة المؤسساتية الجماعية التي تُعْلي من قيم التراحم والتكامل، على المقاربة التجزيئية الفردانية التي تُذْكي قيم النزاع والصراع والتصادم. فالمدونة كما جاء في الخطاب الملكي:”ليست مدونة الرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها… فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال”.
هذا، ويتطلب النظر السديد في مقتضيات المدونة، إشراك كافة الفاعلين وانخراط مختلف الهيئات الوطنية في ورش الإصلاح، وفي مقدمتهم العلماء والفقهاء والقضاة والعدول والخبراء والفاعلون المدنيون؛ كل في مجال اختصاصه، بما يسهم في بناء رؤية متكاملة لمؤسسة الأسرة، ويحقق استقرارها وأداء وظائفها على الوجه الأمثل.
4-التعديلات المقترحة ومقاصدها
تهدف المقترحات المقدمة إلى إعادة النظر في مجموعة من مواد مدونة الأسرة؛ وذلك بعرض مقترحات نراها داعمة لمؤسسة الأسرة، ومساعدة على التنزيل السليم لمقتضيات المدونة؛ وتهم على وجه الخصوص إشكالية زواج القاصر،ومسألة تعدد الزوجات، ومسطرة الطلاق والتطليق…
1-4إشكالية زواج القاصر: أكد الواقع العملي خلال عشرين سنة الماضية أن الشروط التي وضعتها المدونة بخصوص زواج القاصر، حققت مقاصدها إلى حد ما، مساهمة في استقرار هذا النوع من الزيجات في نسبة ضعيفة.حيث تراوحت نسبة زواج القاصر مقارنة بمجموع رسوم الزواج منذ سنة 2004 إلى سنة 2019، بين 11,99% كأعلى نسبة سُجلت سنة 2011،و7,53% كأقل نسبة سجلت عام2019. ولعل أهم ملاحظة يمكن إبداؤها، تتمثل في أن النسبة الأعلى في هذا الصدد قد سجلت لدى القاصرين/القاصرات البالغين 17سنة.حيث شكلت حوالي 70,52%من المجموع العام لرسوم زواج القاصر خلال13 سنة؛ في حين لم تتجاوز رسوم الزواج المتعلقة بالقاصرين البالغين 14 سنة ما نسبته 0,71%من المجموع العام[15]. لأجل ذلك، لا نرى مبررا لإزالة الاستثناء الوارد في المادة (20)،والإبقاء على إمكانية الإذن بزواج من اقترب(ت) من السن القانوني للزواج (18 سنة)، والتي يكون الزواج فيها مصلحة واقعة وراجحة، يقدرها القضاء المختص بمعية الأولياء الشرعيين. ولهذا السبب نلاحظ أن جل قوانين الأسرة في العالم، تركت إمكانية الترخيص بهذا الزواج بعد التحقق من بعض الشروط بعينها. ومن جانبنا، فإننا نقترح تجويد مضمون هذه المادة، من خلال:
-إبقاء المشرع على سن أدنى للإذن بتزويج القاصر في حدود 16 أو 17 سنة، مع ضرورة موافقة الوالدين على غرار بعض التشريعات المقارنة؛
– التنصيص على إلزامية الجمْع بين البحث الاجتماعي والخبرة الطبية؛
-جعل البث في طلبات زواج القاصر من اختصاص هيئة جماعية يترأسها القاضي المكلف بالزواج؛
– إعطاء الحق للنيابة العامة في الطعن في مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر؛
-تحديد المشرع للاختصاص المكاني لزواج القاصر؛
– اعتبار تجريم زواج القاصر غير قانوني.
وعموما يجب استحضار أن النص القانوني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرتفع عن الواقع، ومن تم فإن المقاربة الواجب اعتمادها لمعالجة هذا الموضوع ينبغي أن تكون شاملة تستحضر الجانب القانوني إلى جانب المعطى السوسيو-ثقافي للمجتمع، لأن ظاهرة زواج القاصر بالمغرب تتضافر فيها العديد من العوامل منها الاقتصادية، الاجتماعية،والثقافية.
2-4 مسألة تعدد الزوجات: مع أن قضية التعدد باتت هامشية في المجتمع المغربي، فلا بد من مواصلة تقييدها بشروط وضوابط صارمة، إلا في حالات استثنائية بعينها، وبإشراف من القضاء الأسري. ومن ذلك:
-ضرورة إعطاء مفهوم واضح للمبرر الموضوعي الاستثنائي المُوجِب للتعدد.
– حذف الفقرة الأخيرة من مقتضيات المادة 45 من المدونة، التي جاء فيها “فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها ولم تطلب التطليق، طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97″، لمخالفتها مقتضيات الفصل3 من قانون المسطرة المدنية.
يبدو أن الإجراءات المسطرية التي اتخذت بخصوص هذا الموضوع في المدونة، قد قيدت إلى حد بعيد ظاهرة تعدد الزوجات التي أصبحت تشكل أقل من 1% من عدد الزيجات المنعقدة خلال السنة الواحدة.
3-4 ضبط مسطرة الطلاق والتطليق: يتعين سن ضوابط منطقية وواقعية لتفعيل مسطرة الطلاق والتطليق، التي ما فتئت تثير جدلا واسعا لدى المعنيين والمهتمين، وذلك من خلال:
-تشديد مسطرة التطليق للشقاق، ووضع حد أدنى للبث في الطلب.
-عدم قبول طلب الطلاق أو التطليق إلا بعد إنجاز تقرير من طرف المجالس العلمية، أو مجلس العائلة بفشل محاولة الصلح.
-تفعيل دور المساعدة الاجتماعية.
-التنصيص على إمكانية قبول الوكالة في الطلاق أو التطليق عندما يتعذر على الزوج أو الزوجة الحضور شخصيا.
_ وضع معايير واضحة في تحديد المتعة أو المستحقات، مع جعل هامش السلطة التقديرية للقضاة في حدود معينة.
_التنصيص على كون عمل الزوجة المنزلي بمثابة مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية.
–حذف مقتضيات المادة 90 من المدونة التي تؤكد بأنه”لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره، وكذا الغضبان إذا كان مطبقا”، لعدم انسجامها مع السياق العام للمدونة.
إن هذه الإجراءات تكتسي أهمية بالغة، وتمثل الخط الوقائي للأسرة في مواجهة الخلافات الأسرية والحد من الآثار السلبية للتفكك الأسري الناجم عن الطلاق.
3-4مسألة النسب والبنوة وحفظ مصلحة الطفل المولود خارج إطار الزواج:
لقد اعتبرت الشريعة الإسلامية الطفل المولود من زنا بريئا من زلة والديه، وله حق الرعاية والكفالة من طرف المجتمع.يشهد على ذلكما روي عن عمر بن الخطاب في قصة الرجل الذي التقط لقيطا وضمه إليه، فقال له عمر:” اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته[16]“، ولذلك وجب تحميل الوالد البيولوجي قسطا من المسؤولية المادية، اعتمادا على الخبرة الجينية التي لها دقة قد تفوق الوسائل التي كانت تستعمل قديما في إعطاء النسب أو رفضه كالقيافة[17] وغيرها. لأن حفظ مصلحة الطفل بغض النظر عن كونه ولد عن علاقة داخل إطار الزواج، أو خارج إطار الزواج، لا يجوز إهدارها والتفريط فيها، ويندرج في الحفظ أن يجد العناية المادية اللازمة قصد تحصيل قوته ومعاشه وتعليمه إلى أن يبلغ، وأن يعطى له اسم لا يعير به بين أقرانه، وأن يتلقى التربية السليمة، وتحقيقا لهذه الغاية يجب إدراج هذه التعديلات كنوع من جبر الضرر للطفل المولود خارج إطار الزواج.
وإجمالا، لقد كشف التطبيق العملي للمدونة أن فرص نجاح الصلح من قِبل المحكمة حال قيام وعرض النزاع تبقى ضئيلة ومحدودة جدا. ولذا، تبرز الحاجة لإيجاد بدائل للنهوض بمسطرة الصلح خارج أسوار المحكمة، من شأنها أن تعيين على رأب الصدع قبل استفحال الشقاق، والتي نراها كامنة في تفعيل الوساطة الأسرية والعمل على مأسستها، بحيث تتولى مهمة القيام بمساعي الصلح بحرفية وعلى الوجه الأنسب. يُفترض أن تتألف هذه المؤسسة الحيوية من حكماء يحظون بحسن التقدير والاحترام والإنصات لقولهم من ذوي الخبرة والتجربة العملية؛ وتتمثل مهمتها في النظر في جل طلبات حل ميثاق الزوجية قبل عرضها على المحكمة. وكذا، في إقرار مبدأ المساواة بين الأب والأم في مهام النيابة الشرعية عند قيام العلاقة الزوجية؛ وفي حالة وفاة الأب أو فقدان أهليته، يجب التأكيد على أن الأم ليست في حاجة لممارسة ولايتها على أبنائها القاصرين،إلى صدور حكم أو إشهاد من المحكمة أو القاضي المكلف بشؤون القاصرين؛ لكونها نائبة شرعية بقوة القانون، مع إيلاء المصلحة الفضلى للطفل أهمية بالغة عند أي تعديل لنصوص المدونة.
خاتمة:
إن تطبيق مدونة الأسرة بعد عقدين من الزمن على دخوله حيز التنفيذ، قد أبان عن وجود عدة معوقات تحول دون الإعمال الناجح لمقتضياتها التي جاءت لحماية الأسرة عموما، بما في ذلك المرأة والطفل والرجل. كما أن الأسرة المغربية عرفت تطورا كبيرا بخصوص مواقفها من عدة قضايا من قبيل زواج القاصر، وتعدد الزوجات، ومسطرة الطلاق والتطليق؛ فضلا عن رغبتها بخصوص إعادة النظر في العلاقات المالية بين الزوجين، من خلال إخضاع الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية لقواعد تنظيمية،إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة تحت رقابة القضاء… الشيء الذي طرح بإلحاح سؤال تقييم وتقويم حصيلة التطبيق العملي لمدونة الأسرة، ودور القضاء في استجلاء إرادة المشرع. إذ أن الإشكالات العملية التي واجهت تطبيق المدونة طيلة عشرين سنة، لا يمكن مواجهتها إلا بتشجيع الاجتهاد القضائي، والسعي إلى تطويره وتوحيده بشكل يضمن الموازنة بين مختلف المرجعيات المُؤطِّرة لمدونة الأسرة، والتي كانت وما تزال مشروعا مجتمعيا حداثيا على درجة كبيرة من الأهمية؛ يُعوَّلُ عليه في إدماج الأسرة المغربية في التنمية،باعتبارها النواة الأولى والأساسية للمجتمع.
حري بالذكر، أن تعديل المدونة ليس بالمهمة السهلة ولا بالأمر الهين، على اعتبار أن أي نص تشريعي يفترض أن يجيب بواقعية على المشاكل التي تطرح في المجتمع. إذ لا يصح أن يُصاغ نص تشريعيا يستجيب لانتظارات سكان المناطق النائية مثلا (العالم القروي)، باعتباره يقتصر على اعتماد مقاربة المركز فقط. لأن هناك العديد من التفاصيل التي أملت تعديل مدونة الأسرة، سواء على مستوى الشكل على مستوى الموضوع، لعل أبرزها البنود المتعلقة بمسطرة الطلاق للشقاق التي تم تشريعها، ابتداءً، من أجل حل مشكل التعسف على المرأة في الطلاق،فتبين أنها جاءت بنتائج عكسية؛ حيث وسعت دائرة الطلاق وسرَّعت من وتيرته على نحو يخلخل أركان المجتمع.هذا زيادة على ما طرحته مسطرة الصلح أمام القضاء من مشاكل، إذ من اللازم أن تناط هذه المهمة بجهات متخصصة قبل التوجه للقضاء، من مثل مؤسسة الوساطة أو الصلح… على اعتبار أن القضاء، لا يتم اللجوء إليه إلا عندما يتقرر الطلاق بصفة نهائية؛ علاوة على أن منح مهمة الصلح للقضاء، إنما هو هدر للزمن القضائي الذي لا يتحقق الصلح غالبا من خلاله. هذا، دون إغفال ما تطرحه مقتضيات الإذن بالزواج من إشكالات، بخصوص المسطرة والإجراءات الإدارية، التي تتطلب بعض المرونة بشأن منح الاختصاص لمؤسسة العدول. كما أن الإشراف القبلي والبعدي للقضاء على هذا الإذن يُعد أمرا غير مستساغ؛ إذ يَحسُن الاحتكام للإذن الإلكتروني الذي بات متاحا بفضل التطور التكنولوجي الرقمي.
وخلاصة القول،إن حفظ الأسرة المغربية وتحصينها يعتبر أمرا بالغ الأهمية،ويستدعي مقاربة شمولية قائمة على مراجعة وإصلاح المدونة.إصلاح لابد وأن توازيه مبادرات وسياسات تربوية، وثقافية، واجتماعية، واقتصادية، وقانونية، وإعلامية، في إطار مقاربة متنوعة المداخل، متكاملة الأهداف والمقاصد.
المراجع:
– أبو بكر البيهقي، السنن الكبرى، الناشر: دار الكتب العلمية، 1424-2003.
– ابن أبي شيبة، مصنف أبي شيبة، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 2008.
– محمد المهيدي، تقرير أشغال الندوة الدولية حول موضوع النظام القانوني لزيجات وأَطْلِقَة المغاربة المقيمين بالخارج بين النص وإشكالات التطبيق بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بوجدة، بحوث المؤتمرات سنة 2010.
– محمد الأزهر، شرح مدونة الأسرة، الطبعة السابعة، 2015.
عمر المزكلدي، تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين: قراءة في مفهوم المادة49 من مدونة الأسرة، مجلة العلوم القانونية، عدد مزدوج5/4، 2015.
– فاتحة الطلحاوي، تدبير المال المكتسب في فترة العلاقة الزوجية وفق المادة49 مدونة الأسرة، مجلة العلوم القانونية، عدد مزدوج رقم5/4 الجزء الأول، 2015.
– أشغال اللجنة المكلفة بتدوين الأعمال التحضيرية لمدونة الأسرة، تنسيق إدريس الضحاك، 2016.
– مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، وزارة العدل، 2019.
– مدونة الأسرة، قانون المملكة المغربية، الطبعة الثالثة: 2021-2022.
[1]الرد لغة: هو الصرف، واصطلاحا هو ” صرف المسألة عما هي عليه من الكمال إلى النقص”، أي صرف الزائد من الفروض إلى أصحاب الفروض الموجودين بنسبة فروضهم إذا لم يوجد عاصب. ابن قدامة، المغني، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة الأولى 1979، 7/46.
[2]أشغال اللجنة المكلفة بتدوين الأعمال التحضيرية لمدونة الأسرة، الأعمال التحضيرية لمدونة الأسرة، تنسيق إدريس الضحاك، ص 40.
[4]المصدر السابق، ص 50- 51- 52.
[5]المادة 10:” ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.يصح الايجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين”. قانون المملكة المغربية، مدونة الاسرة، الطبعة الثالثة: 2021-2022، ص 16.
[6]يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الايجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على اسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان…”، قانون المملكة المغربية، مدونة الاسرة، الطبعة الثالثة: 2021-2022، ص 16.
[7]ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.
[8]حكم المحكمة الابتدائية الصادر بتاريخ 2009/09/26، رقم 3136 في الملف عدد3315/06/5، أورده محمد المهيدي، تقرير أشغال الندوة الدولية حول موضوع “النظام القانوني لزيجات وأطْلِقَةِ المغاربة المقيمين بالخارج بين النص وإشكالات التطبيق”، بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بوجدة، بحوث المؤتمرات سنة 2010، ص288.
[9]– محمد الأزهر، شرح مدونة الأسرة، الطبعة السادسة، ص 62.
[10]– المادة 82 من قانون المملكة المغربية، مدونة الأسرة، ص 30.
[11]نص المادة400: “كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف”.
[12]عمر المزݣلدي، تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين –قراءة في مفهوم المادة49- من مدونة الأسرة، مجلة العلوم القانونية، عدد مزدوج5/4، 2015، ص40.
[13]اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول حكم عمل الزوجة داخل البيت إلى اتجاهين، الاتجاه الأول يرى بوجوب الخدمة المنزلية على الزوجة استنادا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على فاطمة بالخدمة داخل المنزل وعلى على بالكسب خارجه، ويمثل هذا الاتجاه فقهاء الحنفية، في حين يرى الاتجاه الثاني والذي يمثله الحنابلة والشافعية وبعض المالكية الذين اتفقوا على عدم وجوب الخدمة المنزلية على الزوجة، وعلى الزوج أن يأتيها بكسوتها مخيطة تامة، وبالطعام مطبوخا تاما.
[14]فاتحة الطلحاوي، تدبير المال المكتسب في فترة العلاقة الزوجية وفق المادة49 مدونة الأسرة، مجلة العلوم القانونية، عدد مزدوج رقم5/4 الجزء الأول، ص125.
[15]– مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، وزارة العدل. 2019.
[16]أبو بكر البيهقي، السنن الكبرى،الناشر: دار الكتب العلمية 1424-2003،6/332.
[17] القيافة لغة : مصدر قاف قيافة،وهي تتبع الأثر والشبه، والقيافة في الشرع لا تخرج عن المعنى اللغوي؛ هي تتبع الآثار ومعرفة الشبه بالشبه، والقائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. ابن أبي شيبة، مصنف أبي شيبة، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 2008، ص 257.